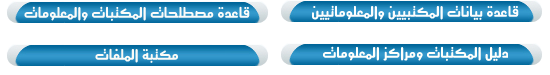
| أخبار المكتبات والمعلومات يُنشر في هذا المنتدى كل ما يتعلق بمجال المكتبات والمعلومات من ندوات أو مؤتمرات أو دورات. |
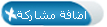 |
|
|
|
|
المشاركة1 |
|
المعلومات
مكتبي نشيط
البيانات
العضوية: 18065
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: فلسطيـن
المشاركات: 90
بمعدل : 0.01 يومياً
|
 تحديات كبيرة تطرحها الثورة الرقمية كيف يحافظ المجتمع المدني على الملكية الفكرية الرقمية؟ الثورة الرقمية تضع تحديات كبيرة أمام المجتمعات العربية مما يتطلب دورا جهدا كبيرا منها في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية. ميدل ايست اونلاين بقلم: حسام عبد القادر لقد أتاحت الحرية المطلقة على الإنترنت سهولة إصدار أي فرد في أي مكان في العالم لأي موقع يكتب فيه ما يريد ويهاجم فيه أي شخص سواء كان فرداً أو جماعة رسمية أو غير رسمية، أو أن يصدر موقعاً يطلق عليه صحيفة أو جريدة، وينشر عليها مواد منقولة من أي مصدر أو مرسلة من أي قارئ، دون التأكد من مصدرها، ودون أي ضوابط للنشر نعرفها نحن ككتاب ونلتزم بها. بل إنه في الوقت الذي انتشرت فيه المطالبة بحقوق الملكية الفكرية نجد هذه الحقوق تهدر بسهولة من خلال مواقع الإنترنت التي تقوم بالاستيلاء على مواد صفحاتها من أي موقع آخر أو من صحيفة مطبوعة لا فرق دون أية مراعاة للملكية الفكرية التي يتحدث عنها العالم، ليس هذا فقط بل إن بعض المواقع التي تعد مواقع كبرى تقوم باستلام المادة من المراسلين وتنشرها دون أي مقابل مادي، بدعوى أنه لا يوجد ميزانية للدفع مقابل المواد المنشورة، رغم أن بعض هذه المواقع مدعمة بشكل كاف، ولكنها تستغل أيضا تعطش البعض ورغبته في نشر مواد مكتوبة باسمه لا يتمكن من نشرها في صحف مطبوعة. من أجل هذا تأتى أهمية البحث والدراسة حول حقوق الملكية الفكرية على شبكة الإنترنت فى ظل ثورة هائلة فى النشر الإلكتروني على مستوى العالم، بدأت هذه الثورة دون أى ضوابط أو مراعاة لقوانين فخرجت عشوائية إلى حد كبير تحتاج إلى من ينظمها ويقننها، خاصة فى ظل نظام دولي جديد يعتمد على التطور والسيطرة والسلطة، ويجب فى ظل هذا النظام أن يكون للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية دوراً كبيراً فى إدارة هذا التنظيم وتقنينها ولذلك رأينا فى اتحاد كتاب الإنترنت العرب أن يكون من أهم الأهداف الرئيسية هو الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية على شبكة الإنترنت وذلك من خلال آليات محددة نعرضها على كل الحكومات العربية لمحاولة سنها فى قوانين نتفق عليها جميعاً من أجل المصلحة العامة. الملكية الفكرية..نظرة تاريخية: الملكية الفكرية حسب ما عرفها المركز المصري للملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات هي كل ما ينتجه ويبدعه العقل والذهن الإنساني، فهي الأفكار التي تتحول أو تتجسد في أشكال ملموسة يمكن حمايتها، وتتمثل فى الإبداعات الفكرية والعقلية، والابتكارات مثل الاختراعات والعلامات والرسوم والنماذج وتصميمات الدوائر المتكاملة والسلالات النباتية وحقوق المؤلفين. ويهدف نظام حماية حقوق الملكية الفكرية إلي تنمية البحث والتطوير وذلك بتقديم حوافز للاستثمار في العملية الإبداعية وتشجيع الوصول إلي الابتكارات. أما منظمة التجارة العالمية فتعرف حقوق الملكية الفكرية على أنها الحقوق التي تعطى للبشر على منتجات إبداعاتهم الذهنية. وغالبًا ما تعطى للمبدع حقوق شاملة على استخدام منتجات إبداعه لمدة زمنية محددة. والاهتمام بالملكية الفكرية ليس حديثا كما قد يبدو للبعض، فلقد بدأ هذا الاهتمام مع الثورة الصناعية الأولى بأوروبا، حيث تعددت الابتكارات والإبداعات التي ساهمت بشكل فعال في النمو الاقتصادي في البلدان الصناعية الكبرى. ويعتبر مصطلح الملكية الفكرية مصطلحا قانونيا يستخدم بشكل شائع للإشارة إلى مجموعة من الحقوق التي تمنحها أشكال الملكية الفكرية التالية وهذه الأشكال صنفتها المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية (الويبو wipo ) كالتالي: حقوق المؤلف والحقوق ذات الصلة، والبراءات، والأسرار التجارية، والعلامات التجارية، والمنافسة غير المشروعة، والدوائر المتكاملة، والتصاميم الصناعية، والأصناف الجديدة من النباتات، ويتم تقسيم حقوق الملكية الفكرية إلى قسمين رئيسيين: أولهما يتعلق بما يمكن أن يسمى حقوق الطبع والنسخ، إذ تعطى هذه الحقوق لمؤلفي الأعمال الأدبية (الكتب والأعمال المكتوبة عمومًا) والأعمال الفنية (التأليف الموسيقي، والفن التشكيلي، وفن الخط، وبرامج الكمبيوتر والأفلام)، وحقوق الأداء بالنسبة للمبدعين (كالموسيقيين والمطربين والممثلين)، والمنتجين للأسطوانات والشرائط المسجلة والمنظمات الإذاعية. أما القسم الثاني وهو المتعلق بالملكية الصناعية، ويتضمن هذا القسم حماية العلامات المميزة مثل العلامات التجارية، والمؤثرات الجغرافية؛ أي حماية السلعة المنتَجة في مكان محدد، حينما يكون لهذا المكان أثر في نوعية السلعة المنتَجة (كتمييز الأرز البسمتي عن بقية أنواع الأرز على سبيل المثال)، كما يتضمن حماية الملكية الصناعية بهدف رئيسي هو حفز الابتكار، وتصميم وإبداع التكنولوجيا. وفي هذا القسم تكون الحماية متوفرة للاختراعات المحمية ببراءات اختراع والتصميم الصناعي والأسرار التجارية. كما تمنح حقوق الملكية الفكرية للأشخاص لإبداعاتهم الفكرية حيث تقدم للمبدع حقا حصريا من أجل استعمال والاستفادة من إبداعاته/ابداعتها لفترة زمنية معينة وهو ما يهمنا فى موضوعنا، فبموجب اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية يتم حماية المصنفات فإنه يتم حماية تلك المصنفات دون أية شكليات في كافة الدول الأطراف بتلك الاتفاقية. ويعني ذلك أن حماية حق المؤلف الدولية تلقائية وتكون قائمة حالما يتم إبداع العمل وينطبق هذا المبدأ في كافة الدول الأطراف في اتفاقية بيرن. والمواد التي تتضمنها اتفاقية منظمة التجارة العالمية التي تسمى "اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة" والتي يشار إليها اختصارًا بـ"التريبس" Trade Related aspects of Intellectual Property Rights “TRIPS” تهدف إلى حماية حقوق الطبع والحقوق المرتبطة بها، وحماية العلامات التجارية، والمؤثرات الجغرافية، والتصميمات الصناعية، وبراءات الاختراع، والتصميمات الأولية للدوائر المتكاملة، وحماية المعلومات المتعلقة بالأسرار التجارية. الجدير بالذكر أنه بمجرد توقيع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على اتفاق جولة أورجواي الذي أسس لمنظمة التجارة العالمية، وهي الجولة التي انتهت في عام 1994 تصبح موافقة -في نفس الوقت- على الاتفاقات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، حيث إن الاتفاقية قد وضعت بمنطق التوقيع الواحد المجمل، أي لا يمكن التوقيع على نتائج الجولة، وفي نفس الوقت يتم التنصل من أي من الاتفاقات التي تضمنتها. والحقيقة أنه من البداية كانت الولايات المتحدة تضغط بشدة من أجل إدراج موضوع حقوق الملكية الفكرية ضمن اتفاقات منظمة التجارة العالمية، فرغم أنه كان هناك ما يسمى باتفاقية باريس لحقوق الملكية الفكرية الصناعية، واتفاقية برن في سويسرا التي تُعنى بقضية حقوق الطبع والنسخ، فإنهما لم تكونا ترضيان تطلعات الولايات المتحدة، لأن اتفاقاتهما ليست شاملة كاتفاقات جولة أورجواي، كما أنها ليس لها نفس صفة الإلزام التي تمتلكها منظمة التجارة العالمية حاليا في هذا المجال. وكانت الولايات المتحدة والدول المتقدمة قد ضمنت اتفاقيتي باريس وبرن ضمن اتفاق جولة أوروجواي بحيث أصبحتا جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقات المتعلقة بالموضوع في إطار منظمة التجارة العالمية. ويفسر هذه الضغوط الأميركية واستغلال الاتفاق لتعديل القوانين في العديد من بلدان العالم، ومن ضمنها بعض القوى التجارية الكبرى في العالم كالصين أن الولايات المتحدة تمتلك قدرة تنافسية كبيرة في مجال الصادرات من الخدمات المستندة للإبداع التكنولوجي والفكري والفني، مقارنة بعجزها الدائم والمزمن في التجارة السلعية؛ حيث نجد أن عجز الميزان التجاري (أي التجارة في مجال السلع: الصادرات السلعية - الواردات السلعية) هو عجز كبير ومتزايد، ويأخذ صفة العجز المزمن منذ سنوات طويلة. بينما على الطرف الآخر نجد أن الصادرات الأميركية من الخدمات -خاصة من صادرات برامج الكومبيوتر والأفلام السينمائية والمسلسلات والبرامج التليفزيونية، وما تحصل عليه الشركات الأميركية من عوائد مقابل إعطاء تراخيص المعرفة الفنية وتراخيص حق إنتاج بعض السلع والخدمات في بلدان العالم الأخرى- تزيد عن المدفوعات التي تقوم بها الولايات المتحدة من جراء وارداتها من الخدمات. ولذلك نجد أن العجز الكبير في الميزان التجاري (تجارة السلع) ينخفض إلى حد ما بسبب الفائض في تجارة الخدمات، وبحيث ينخفض العجز في الميزان الجاري (التجارة في السلع والخدمات) عن العجز في الميزان التجاري. والواقع أنه كما سبق القول فإن هذا الاتجاه السابق يُعد اتجاها تاريخيا في تجارة الولايات المتحدة مع دول العالم المختلفة منذ فترة طويلة من الوقت. ويجب أن نلفت النظر إلى ظهور مشروع القانون الفرنسي فى ديسمبر 2005، بعد توصيات المجلس الأوروبي التي نادت بوجود مثل هذا القانون والتي ترجع إلى عام 2001 واهتم القانون بحماية حقوق المؤلف على الإنترنت خاصة في ظل سهولة نشر المؤلفات -سواء كانت مؤلفات أدبية أو غنائية أو سينمائية- على مواقع الإنترنت المختلفة، وإمكانية استغلالها بسهولة من قبل مستخدمي الإنترنت. ولذلك قام المشرع بمنع عمليات التبادل غير القانوني عن طريق فرض أنظمة الحماية الرقمية "DRM" والتي تعطي للجهاز الذي يقوم بتنزيل الملفات من الإنترنت كودا معينا يسمح بفتح هذه الملفات على هذا الجهاز فقط. كما سمح بوجود هذه الأنظمة التقنية في الـ CDs والـDVDs مما يحميها من أي عملية نسخ، ولكن أعضاء البرلمان الفرنسي انتبهوا لما تمثله هذه الأنظمة من انتهاك لحقوق المستهلكين، خاصة إذا كانت هذه الأنظمة لا تعمل إلا مع بعض الأجهزة فقط؛ ولذلك قاموا بتعديل هذه المادة مما يسمح بإمكانية تشغيل هذه الـ CDs على جميع الأجهزة حفاظًا على حقوق المستهلك، كما قاموا بإدخال تعديلات أخرى حتى لا تتعارض هذه الأنظمة مع أمن الأفراد أو الشركات. ولكي يحقق أي قانون الحماية المرجوة منه فلابد من وجود عقوبات مادية أو معنوية لمن يتعدون حدوده، وفي بداية نقاش مشروع القانون كان يلزم من ينتهكونه بغرامة تصل إلى 300 ألف يورو وثلاث سنوات حبسا، إلا أن باتريك بلوش، عضو الحزب الاشتراكي الفرنسي قد هاجم هذه العقوبة بشدة أثناء حواره مع مجلة "بدائل اقتصادية" (Alternatives Economiques)، واعتبرها مغالاة من الحكومة خاصة، وأن مشروع القانون آنذاك لم يفرض ملاءمة أنظمة الحماية الرقمية لجميع أجهزة الاستماع. وعندما أقر القانون في البرلمان الفرنسي تم تخفيف العقوبة وتدريج الغرامات المدفوعة، واقتصرت هذه العقوبة المشددة على الناشرين لبرامج تبادل المؤلفات وتتدرج الغرامة إلى أن تصل إلى 38 يورو لمن يقوم بإنزال ملفات محمية من الإنترنت دون وجه حق، وترتفع إلى 150 يورو إذا أتاح تلك الملفات للغير، وقد أثار حق المستهلك في نسخ الـCD الشخصية الخاصة به، جدلا كبيرا بين أعضاء البرلمان أثناء مناقشة هذا القانون، حيث اعتبر بعض أعضاء الحزب الاشتراكي وحزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية أنظمة الحماية الرقمية انتهاكا واضحا لحقوق المستهلك في الاستمتاع بملكيته للسلعة. وأثناء التصويت على القانون وافق الأعضاء على حصول المستهلك على حق النسخ، ولكنهم لم يحددوا الحد الأدنى للنسخ، وعلى مجال التطبيق فتبقى المشكلة قائمة، حيث لا تسمح أنظمة الحماية بنسخ الأسطوانات. أما الـDVD الخاص بالمؤلفات السينمائية، فقد تم رفض عمل أي نسخة شخصية لها ويهاجم عضو الحزب الاشتراكي، ديدييه ماتيوس هذا قائلا: إننا نسدد ضريبة للحصول على النسخة الشخصية وفي نفس الوقت لا يمكننا ممارسة حق نسخها! وفي النهاية، يبقى القانون عالقا حتى تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ، وإذا اختلف على بعض المواد يتحتم إعادة مناقشتها بين ممثلي كل من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية حتى يتوصلوا إلى حل وسط ومناسب. وسوف يكون لهذا القانون تأثيراً هاماً على الدول النامية فعلى المستوى الثقافي في الدول النامية، سيؤثر بشكل قوى خاصة أن الكتب والمواقع الفرنسية تعتبر مرجعا ثقافيا مهما لطبقة المفكرين والباحثين في المجالات القانونية والسياسية وغيرهما. وسيكون تأثيرها أوضح على دول شمال إفريقيا كالجزائر وتونس والمغرب، وذلك للارتباط الثقافي والفني بين فرنسا وتلك الدول، بالإضافة إلى محدودية الموارد بتلك الدول والتي تعوق المستهلك فيها عن شراء المؤلفات التي يحتاجها من الإنترنت، أما بالنسبة لباقي الدول العربية فسوف يؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى توجهها إلى مصادر أخرى للثقافة، وإن كانت محدودة وليست بنفس العمق الثقافي والحضاري لفرنسا وسيزيد هذا التوجه إذا عمم هذا القانون على باقي دول الاتحاد الأوروبي. الرخص البديلة: وبخصوص حماية الملكية الفكرية ودور المجتمع المدني فهناك منظمة غير حكومية أوروبية هى منظمة "كرييتيف كومونز" من أجل العمل على وضع رخص بديلة للأعمال والمنتجات الإبداعية, فتقوم هذه المنظمة بأخذ الموقف الوسط بين من ينادى بالتراخيص الجامدة المغلقة, وبين من يطالب بعدم وجود أى ترخيص لأى عمل أو منتج إبداعي. فهى إذن لديها تراخيص خاصة يمكن لصاحب أو صاحبة المنتج أن يختار\ تحتار الترخيص الذى يريده\ تريده. وقد بدأ هذا المشروع أستاذ بجامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأميركية اسمه "لورانس ليسيتنج" فى نهايات عام 2001 ثم بدأ الإعلان عن أولى التراخيص فى نهايات عام. وقد شارك فى المشروع العديد من أساتذة الجامعات المتخصصين فى قوانين الملكية العامة والملكية الفكرية وكذلك المهتمين بشئون الإنترنت، وقد أصبحت الآن واسعة الإنتشار فى شتى دول العالم وبخاصة بين مستخدمى الإنترنت. أعتقد أن المجتمع المدنى بشكل عام فى حاجة لمثل هذه الرخص لأنه يقوم ينشر تنمية وحقوق إنسان والهدف هو التعميم وليس التخصيص, وبالتالى فهي فى رأيي أنسب رخصة له، وتوجد الآن مبادرات كثيرة لترجمة هذه الرخص إلى العديد من لغات العالم ومنها اللغة العربية. النشر الإلكترونى: يعرف أشرف صلاح الدين مؤلف كتاب "الإنترنت عالم متغير" النشر الإلكتروني بأنه العملية التي يتم من خلالها تقديم الوسائط المطبوعة (Printed-Based Materials) كالكتب والأبحاث العلمية بصيغة يمكن استقبالها وقراءتها عبر شبكة الإنترنت أو الوسائط المتعددة حيث تتميز هذه الصيغة بأنها مضغوطة ومدعومة بوسائط وأدوات كالأصوات والرسوم ونقاط التوصيل التي تربط القارئ بمعلومات فرعية أو بمواقع على شبكة الإنترنت. ولكنى أرى أن النشر الإلكترونى ليس فقط تحويل الوسائط المطبوعة إلى وسائط رقمية ولكنه أيضاً التأليف المباشر على شبكة المعلومات (الإنترنت) أو إخراج كتاب أو مطبوعة فى صورة اسطوانة ممغنطة مباشرة، فبعد انتشار الإنترنت أصبح هناك آلاف من المؤلفين والباحثين والمبدعين فى كافة المجالات أتاحت شبكة المعلومات الفرصة لهم لإخراج إبداعاتهم ونشرها دون الحاجة لوسيط مطبوع أو لناشر يطلب منهم شروطاً معينة لنشر هذه الإبداعات، فمن مزايا النشر الإلكتروني في عدم وجود تكاليف متعلقة بالطبع والتوزيع والشحن، الأمر الذي يغير المبدأ التقليدي عند الناشرين، فبدلا من مبدأ "اطبع ثم وزع" حل مبدأ "وزع ثم اجعل المستخدم يطبع". بل وصل الأمر ببعض المؤلفين المتمكنين من التقنيات الحديثة إلى استغلال مزايا هذه التقنيات مثلما فعل الكاتب الأردنى الدكتور محمد سناجلة رئيس اتحاد كتاب الإنترنت العرب عندما أخرج روايتان وقصة حتى الآن على الإنترنت قدم فيهما تقنية الإنترنت من خلال الوصلات واستخدام برنامج الفلاش الرواية الأولى هى "ظلال الواحد" والثانية هى "شات"، ثم أخيراً قصة "صقيع"، فمن مزايا النشر الإلكتروني التفاعلية من خلال استخدام ما يعرف بنقاط التوصيل (hyperlinks) التي تزود القارئ بمعلومات إضافية قد لا تكون أساسية في النص غير أنها متعلقة به، وكذلك سهولة البحث عن المعلومات وسهولة تعديل وتنقيح المادة المنشورة إلكترونيا، ويعتبر سناجلة حتى الآن هو الكاتب العربي الوحيد الذى استغل هذه الإمكانيات بشكل كامل، وقد أكد سناجلة فى لقاءات عديدة له أنه يتمنى أن يتخذ مؤلفون آخرون هذا المنهج ويحاولون تقديم أنواعاً متعددة من الأدب من خلال هذه النظرية وباستخدام هذه التقنية، ونحن فى انتظار أن يتفاعل الأدباء العرب لينافسوا سناجلة فى هذا المجال. وعلى المستوى العالمى قرأنا أخيراً عن رواية "مليون بنغوين A Million Penguins " أول رواية أدبية يحررها مستخدموا الإنترنت باللغة الإنجليزية وهى الرواية التى تعرضها «كتب بنغوين» إحدى كبريات دور النشر في بريطانيا على الانترنت، وقد افتتحت دار النشر البريطانية موقعا لها على الانترنت وزودته ببرامج (ويكي Wiki) اللازمة، التي تسمح لأي مستخدم بالدخول الى الرواية وقراءة فصولها، وكتابة او تحرير أي موضع في الرواية الجماعية، ووضعت الدار الرواية على موقع www.amilliompenguins.com وظهر أن الرواية دخلت فعلا في فصلها السابع، وقت كتابة هذا الكلام، ووصل عدد الكلمات فيها الى أكثر من 9 آلاف كلمة، وتتحدث الرواية عن قصة خيالية تدور حول أحد المديرين في ميدان تقنية المعلومات في فنلندا، يستقيل من منصبه ويترك عمله كي يتجول عبر القارة الاوروبية وفي الهند، إلا أنه يظل متواصلا مع أصدقائه وأقربائه عبر الرسائل النصية التي يبعثها بهاتفه الجوال. إلا أن أهم عيب فى النشر الإلكترونى حتى الآن تمنع البعض من عدم اللجوء لهذه الوسيلة هو عدم وجود حماية كافية للمواد المنشورة إلكترونيا، والخوف من النسخ غير المشروع وكذلك حقوق المؤلفين الفكرية، الطريف أن بعض المؤلفين المتحمسين للنشر الإلكترونى أكدوا أن سرقة حقوقهم الفكرية تتم بشكل أو بآخر حتى فى الكتب المطبوعة فهناك جدال دائم مستمر بين الناشر والمؤلف حول حقوق الثاني وأن الناشر لا يلتزم ببنود العقد من حيث عدد النسخ وأماكن التوزيع، وبالتالى فيكتفى البعض من المؤلفين بميزة نشر إبداعه على نطاق واسع غير مهتماً بما قد يتعرض له من سرقات أو عدم حماية حقوق الملكية الفكرية له. دور المجتمع المدنى ومن هنا تأتى أهمية وجود كيانات عربية لحماية هذه الحقوق بشكل منظم وهذا العبء لابد أن يقع على عاتق المجتمع المدني العربي فهو دوره ولابد أن يؤدي من خلاله، وقد نبه إلى هذا الدكتور رأفت رضوان مدير معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصرى سابقاً والأمين العام للاتحاد العربى لتكنولوجيا المعلومات والذى أكد أن أولى الخطوات لتوحيد الصف العربي هو وجوده في صورة كيانات ولو صغيرة لمواجهة المنافسة خاصة إذا كانت هذه المنافسة تكنولوجية مما دفع البعض لمطالبة بلوبي تكنولوجي، ومن ثم ظهر "الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات" وموقعه http://www.arab-ita.org/ فى فبراير 2001 وقد شارك في تأسيسه كلا من مصر والإمارات وسوريا والسعودية والمغرب والأردن والكويت وفلسطين ليرسم ويحدد السياسات ويدفع القطاع الخاص للمشاركة العربية العربية. إلا أنه بالنظر فى موقع هذا الاتحاد فوجئت بأنه آخر تحديث له كان فى 5 سبتمبر عام 2004 ومعنى هذا أنه متوقف عن التحديث ما يقرب من عامين، ورغم أن الموقع ما زال موجوداً ويؤكد أن الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات هو اتحاد عريي نوعى متخصص غير سياسي يتبع مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية, وهو مخصص لغرض خدمة وتلبية احتياجات المجتمع العربي لتكنولوجيا المعلومات, بالإضافة إلي توفير الإمكانيات التي من خلالها تعمل الشركات العربية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات سويا لتحسين وللارتقاء بالصناعة بشكل عام، بالإضافة إلي المحافظة على مستويات عالية من التعاون بين أعضاء الاتحاد، ويضم الاتحاد بين أعضائه شركات متخصصة في مجال صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والإنترنت والتجارة الإلكترونية فضلا عن شخصيات عامة مهتمة بهذا المجال. وهكذا فإن الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات لا يقتصر فقط على كونه اتحادا ولكنه يمثل نقطة مرجعية لجميع البيانات والخدمات الخاصة بصناعة تكنولوجيا المعلومات في الوطن العربي. ومع كل هذا الكلام الرائع إلا أن هذا الاتحاد غير موجود حالياً لا فى الواقع الافتراضي ولا فى الواقع العملي داخل المجتمع والسؤال لماذا لم يتم تحديث الموقع ولماذا لم يقم هذا الاتحاد بجهود حقيقية تجاه ما أعلنه المهندس رأفت رضوان من مواجهة التنافس التكنولوجي القائم؟ الواضح أن مشكلة هذه الكيانات التى تبدأ ضخمة وباجتماعات ومؤتمرات يحضرها الناس من كافة الدول العربية أنها كيانات فردية وأقصد بفردية أنها فردية القرار وفردية النشأة رغم عضوية دول عديدة بها، فأي كيان يكون معتمد على فرد واحد –أظنه هنا رأفت رضوان- يصبح مهدداً بالتوقف فور مغادرة هذا الشخص له أو ابتعاده لفترة لأي سبب كالعمل أو حتى حياته الاجتماعية ومن هنا فالحكم بالفشل يكون مصير هذه الكيانات. إلا أننا يجب أن نلفت النظر إلى وجود حقيقة واحدة لا تحتاج إلى تزييف وهي أن الدول العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات أصبحت تصنف في المستويات الأخيرة بحيث لا يوجد خلفنا إلا بعض الدول الأفريقية ودول جنوب الصحراء وهذا يرجع إلى مجموعة من العناصر الكمية والكيفية فالدول العربية على مستوى نشر خطوط التليفون إلى نسبة السكان أفضل حالا من دول جنوب شرق آسيا لكنها في نفس الوقت بالنسبة لعدد أجهزة الكمبيوتر مازالت هي الأعلى لكن العبرة في النهاية بالاستخدام وعندما نتحدث عن عدد مشتركي الانترنت إلى عدد السكان نجد أن هذه النسبة لا تزيد عن 1.5% إلى 2% في أحسن تقديراتها كما أن المحتوى العربي على الانترنت مقارنة بعدد السكان نجد أننا الأقل بهذا المحتوى فمعظم المواقع العربية تنشأ باللغة الإنجليزية وهذا يؤدي لتقليل المحتوي العربي والذي لا يزيد عن 0.09% مقارنة بعدد السكان الذي يبلغ 5% من قيمة عدد السكان في العالم علاوة على ذلك ارتفاع نسبة الأمية في الوطن العربي والتي أصبحت تمثل المركز قبل الأخير فيها كما أن الوطن العربي ذاته متنوع ومتباين بصورة كبيرة. وأرى أن أول محاولات جادة من جانب المجتمع المدنى العربى للخوض فى هذا المجال كانت فى المرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات في مدينة جنيف بسويسرا التى انعقدت في ديسمبر 2003 دون حضور عربي ملحوظ، إلا من بعض ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، رغم الأهمية التي حظيت بها هذه القمة وما صدر عنها من إعلان مبادئ وخطة عمل، تؤثر على علاقة الفرد والمواطن العربي بمجتمع المعلومات والمعرفة. وقد استرعى هذا الغياب اهتمام مجموعة من نشطاء المجتمع المدني العرب الذين حضروا قمة جنيف حول المعلومات. وتداعى هؤلاء للقاء ونقاش الأولويات والاستعداد لحضور أكثر فعالية في الجزء الثاني من القمة في تونس 2005، وبالفعل تم الإتفاق على المبادئ العامة للمجموعة العربية، والتي تستند إلى ما ورد بتقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003 المتعلق بمجتمع المعرفة، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان كأرضية إنطلاق لتحقيق الأهداف التالية: أولاً: تقوية المشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني العربي لحضور القمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتها الثانية في تونس عام 2005، والاجتماعات التحضيرية الرسمية للقمة. ثانياً: تنمية الوعي والمعرفة بقمة تونس، والدور الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الإهداف المنشودة. ثالثاً: تطوير مجتمع المعلومات لتنمية العدالة الإجتماعية، والعمل على تمكين المرأة لتساهم في عملية التنمية المستدامة والإهتمام بالطفل وذوي الإحتياجات الخاصة والفئات المهمشة في المجتمعات العربية. كما اتفق المجتمعون والذين كونوا مجموعات إخبارية وورش عمل على الإنترنت نظمها مركز مجتمع المعرفة بإشراف الدكتورة مارلين تادرس الذى كان له دوراً كبيراً تجاه هذا النشاط فى تشكيل مجموعة ضغط من مؤسسات المجتمع المدني العربي من أجل إيصال أهداف هذه المنظمات الى القمة، وتنسيق الجهود ما بين مجموعة مؤسسات المجتمع المدني العربي والمؤسسات الأخرى المشاركة بالقمة حول القضايا المشتركة، وإنشاء موقع عربي لمجموعة مؤسسات المجتمع المدني العربي. كما اتفق فريق العمل أيضاً على تكليف جميع الحضور بالتعريف بالمجموعة العربية في بلدانهم والانخراط في نقاش الأولويات التي تهم المجتمع المدني العربي نحو قمة تونس لمجتمع المعلومات، وفتح العضوية أمام مؤسسات المجتمع المدني العربي للانضمام للمجموعة العربية الخاصة بقمة تونس، ومناقشة إعلان عمّان الصادر عن المؤتمر الإقليمي العربي "نحو مجتمع معلومات أكثر عدالة" كمسودة لإعلان للمجتمع المدني العربي، وتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني على المستويات الوطنية، فيما يتعلق بالقمة العالمية لمجتمع المعومات بمرحلتها الثانية والتي ستعقد في تونس عام 2005 وما يلي القمة من نشاطات، والمشاركة في الإجتماعات التحضيرية للقمة والتي ستعقد في سوريا، جنيف وتونس، وتنظيم اجتماع إقليمي عربي تحضيري قبل إنعقاد قمة تونس. وبمناسبة ذكر قمة تونس للمعلومات فقد حدث داخل هذه القمة والقمة الماضية بجنيف صراع بين دول الاتحاد الأوروبى وبين الولايات المتحدة الأميركية هذا الصراع حول إدارة الإنترنت فما زالت أميركا مصرة على الانفراد بإدارة الإنترنت رافضة أى محاولة لمشاركتها فى هذا الأمر ضاربة عرض الحائط بأى قوانين أو مؤتمرات أو أفكار تقال فى هذا الشأن ولنا أن نتخيل أن كل هذا الكم من المعلومات يدار من خلال دولة واحدة فقط هى الولايات المتحدة الأميركية وما ينتج عن ذلك من هيمنة واحتلال أقوى من الاستعمار قديماً ليس هذا فقط بل إن البرامج الرئيسية التى يعمل من خلالها جهاز الحاسب الآلى وشبكة الإنترنت هى برامج أميركية ومن إنتاج شركة مايكروسوفت والتى تخترق دائماً وبها ثغرات مستمرة يدخل من خلالها الهاكرز والجواسيس وطبعا الفيروسات. والغريب أننا نوافق على ذلك طواعية دون أي محاولة للاعتراض أو لاتخاذ موقف وخاصة أن البديل موجود وهو البرامج المفتوحة المصدر Open source والتى سنتحدث عنها لاحقاً. فإذا أردنا أن نتحدث عن دور المجتمع المدنى تجاه هذه القضية فيجب أن نؤكد أن للمجتمع المدني أربعة مقومات أساسية هي: - الفعل الإرادي الحر أو التطوعي. - التواجد في شكل منظمات. - قبول التنوع والاختلاف بين الذات والآخرين. - عدم السعي للوصول إلى السلطة. ويتطلب دعم الطابع الشعبي للمجتمع المدني الاهتمام أكثر بالمنظمات الشعبية ذات الجذور العميقة فى المجتمع التي تهملها حاليًا المنظمات غير الحكومية المنشأة حديثًا وتشمل المنظمات الشعبية تحديدا النقابات المهنية والعمالية، والتعاونيات، واتحادات الطلاب، ومنظمات الحرفيين والمنظمات المهنية وتنظيمات الخدمة الاجتماعية، ويوفر هذا التنسيق استفادة المنظمات غير الحكومية وسائر مكونات المجتمع المدني من التراث الطويل والخبرات الواسعة للحركة النقابية في مجالات التعبئة وحشد القوى، ولديها الوسائل والكوادر المدربة على ذلك. ولها خبرات هامة في المجال المطلبي، وتتوفر لدى المنظمات الأخرى التعاونية والاجتماعية والطلابية خبرات متنوعة وإمكانيات بشرية تطوعية يمكن أن تستفيد منها المنظمات الأخرى حديثة النشأة لاكتساب القدرة على التأثير والاستناد إلى قاعدة اجتماعية واسعة وامتلاك خبرات جديدة في مختلف المجالات، وسوف يساعدها ذلك على تجاوز وضعها الحالي كمنظمات منعزلة عن بعضها تعمل في إطار أهداف جزئية بحيث تتجه إلى إقامة تحالفات مع المنظمات الأخرى العاملة في نفس المجال مثل حقوق الإنسان والمرأة والبيئة والتنمية .. الخ، وتجاوز وضعها النخبوى إلى آفاق جماهيرية وشعبية أوسع تساعدها على تفعيل نشاطها واكتساب المقومات الضرورية لتحولها إلى حركات اجتماعية لها عمق شعبي كاف. وقد اعترف الحزب الوطنى المصرى وهو الحزب الحاكم فى المؤتمر السنوى قبل الأخير له عام 2005 حول "دعم دور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية" أن الجمعيات الأهلية المصرية، بالرغم من تراثها الزاخر بالنماذج المضيئة والمشرفة منذ أوائل القرن التاسع عشر ودورها الحيوى كشبكة للأمان الاجتماعى، إلا أنها ما زالت تواجه صعوبات وتعانى من مشاكل هيكلية أهمها: 1 - ضعف البناء المؤسسى للجمعيات مما يكرس الشخصانية وغياب الصف الثانى فى أغلب الحالات. 2 - صعوبة الحصول على التمويل. 3 - ضعف الممارسة الديمقراطية وعزوف الشباب عن المشاركة فى عضوية الجمعيات ومجالس إداراتها، بالإضافة إلى انخفاض مشاركة المرأة فى مجالس الإدارة. 4 - الحاجة لبلورة رؤية استراتيجية أو أجندة قومية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تتبنى بشكل مركز وعلمى بعض أولويات قضايا التنمية مثل مكافحة الفقر والبطالة والمشاركة فى قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، بحيث تكون مشاركتها أكثر فعالية. 5 - تراجع ثقافة التطوع. 6 - طول الإجراءات من جانب الجهة الإدارية المختصة للحصول على الموافقات، سواء للتأسيس أو الحصول على التمويل للمشروعات أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة أو غير ذلك. وأيا كانت درجة الاختلاف فى وضع مؤسسات المجتمع المدني من بلد لآخر فإن معظمها يعاني من التوتر فى العلاقة مع الأجهزة الإدارية لأكثر من سبب منها: 1-أعطت القوانين صلاحيات كاملة للحكومة من خلال الوزارات المختصة كالشئون الاجتماعية أو العمل أو الشباب أو الداخلية في الإشراف على الجمعيات والمنظمات الأخرى. وقد تحولت هذه الصلاحيات فى التطبيق الفعلى إلى نوع من الإشراف والرقابة البيروقراطية التي انتقصت من استقلالية هذه المنظمات، كما تحولت فى بعض الأحيان إلى رقابة أمنية أثرت سلباً عليها. 2-فى بعض الأقطار العربية تتعدد مستويات الإشراف والرقابة من قبل الحكومة على المنظمات، مما يخلق مشاكل عديدة تعوق تنفيذ المشروعات التى تتبناها هذه المنظمات. 3-السلطات التى منحها القانون للحكومة فى بعض الأقطار العربية (مصر، سوريا، الإمارات، الجزائر) لحل المنظمات الأهلية أو دمجها فى أخرى، تصبح أيضاً مصدراً للتوتر وعدم الثقة بين الطرفين، أو قد تتحول إلى سلطة للتهديد فى يد الدولة فى بعض الأحيان. 4-أصبحت عملية توزيع المخصصات المالية على الجمعيات الأهلية مصدراً آخر للتوتر بينها وبين الحكومة، وقد ارتبط ذلك بتدفق المعونات الأجنبية التى يجب أن تحظى بموافقة الحكومة، وفى حالات أخرى يتم توزيعها من خلال الحكومة مما يخلق حساسية بينها وبين القطاع الأهلي. 5-تختلف درجات التعاون أو التوتر بين الحكومات والجمعيات الأهلية باختلاف الأقطار العربية وباختلاف مجالات النشاط، فالتعاون يزداد بين الحكومة والمنظمات التى تسهم فى مساندة الدولة من خلال سد الفجوات أو ثغرات الأداء الحكومى، أو من خلال اضطلاع البعض منها بدور فى تنفيذ الخطة القومية، بينما ترتفع حدة التوتر بين الحكومة والمنظمات إذا أدركت الأولى أن نشاط بعض هذه المنظمات يتضمن تهديداً أو تحديا لها. من أمثلة ذلك العلاقة بين بعض الحكومات العربية ومنظمات حقوق الإنسان. كذلك فإن التوتر بين الطرفين قد يجد مصدره فى الأشخاص القائمين على بعض هذه المنظمات حيث تبرز قيادتها كعناصر معارضة للحكم. ومن ثم فإننا نلحظ اتجاه بعض المنظمات نحو اختيار شخصيات على علاقة طيبة مع الحكومة، ليكونوا واجهة طيبة لهذه المنظمات ولضمان رضا الحكومة عما تقوم بـه من نشاط. كما أن الحكومات استخدمت أكثر من آلية لضمان سيطرتها على مؤسسات المجتمع المدنى مثل آلية التشريع التى تفرض قيوداً عديدة على إنشاء ونشاط هذه المنظمات مما كان له أكبر الأثر فى الحد من قدراتها وإمكانيات نموها. وقد عرض عبد الغفار شكر لنماذج من هذه القيود مثل: التسجيل والإشهار حيث تشترط كل الدول العربية، ما عدا لبنان والمغرب، موافقة السلطات الحكومية قبل بدء النشاط، وتوضع شروط مبهمة وغامضة لقيامها مثل عدم مخالفة النظام العام وإثارة الفتنة وتستخدم هذه الشروط لرفض قيام الجمعيات التى لا تطمئن إليها الحكومة. ويعتبر قرار الرفض نهائياً لا يجوز التظلم منه أمام جهة قضائية فى بعض الأقطار العربية. ونرى نفس القواعد بالنسبة للنقابات العمالية والمهنية حيث لا يجوز إنشاء أكثر من نقابة لكل مهنة أو أكثر من لجنة نقابية فى نفس الموقع، هذا بالإضافة إلى سلطة حل الجمعيات حيث أن حل هذه الجمعيات بواسطة السلطة الإدارية لا يقل خطورة وربما كان أكثر من رفض تأسيسها خاصة إذا أعطيت الجهات الإدارية حق حل الجمعيات فى غير المخالفات الخطيرة وبدون حق الاستئناف إلى القضاء. وفيما عدا لبنان والمغرب فإن معظم التشريعات العربية تعطى للسلطة الإدارية حق حل الجمعيات لأسباب متنوعة يمكن أن تصدر بشأنها عقوبات أقل مثل الإنذار أو لفت النظر وليس حل الجمعية. كما تلتزم الجمعيات بعدم الحصول على تبرعات إلا بعد موافقة الجهة الإدارية وضرورة تحديد مصادر التمويل، ويستخدم التمويل الأجنبى ذريعة لمحاربة الجمعيات واتخاذ إجراءات ضدها، كما يتم فرض عقوبات مغلظة على أعضاء مجالس الإدارة المخالفين يصل إلى عقوبة السجن مما يؤدى إلى إحجام المواطنين عن المشاركة فى العمل التطوعى خوفاً من التعرض لهذه العقوبات. ورغم أن الدساتير فى معظم الأقطار العربية تؤكد حق المواطنين فى إنشاء الجمعيات والنقابات إلا أن التشريعات المطبقة تسلب المواطنين هذا الحق وتحرمهم من ممارسته بحرية. وكنموذج لهذا الوضع فإن قانون النقابات العمالية فى مصر يعطى للجهة الإدارية وهى وزارة العمل سلطات واسعة بالنسبة للنقابات مثل الحق فى الاعتراض على تكوين النقابة وطلب حل مجلس الإدارة المنتخب ومنح وزير العمل سلطة تحديد شروط العضوية فى مجلس الإدارة وقواعد تمثيل أعضاء اللجان النقابية فى النقابات العامة. وحق تحديد مواعيد الانتخابات وإجراءات الترشيح والانتخاب لمجالس الإدارة، وإصدار اللائحة النموذجية واعتماد اللائحة المالية ومراقبة مالية النقابات. وما تزال هذه الوصاية الإدارية قائمة رغم صدور حكم المحكمة الدستورية فى 15/4/1995 الذى ينص على "حق النقابة ذاتها فى أن تقرر بنفسها أهدافها ووسائل تحقيقها وطرق تمويلها، والمواد والقواعد التى تنظم بها شئونها، ولا يجوز بوجه خاص إرهاقها بقيود تعطل مباشرتها لتلك الحقوق أو تمتعها بالشخصية الاعتبارية على قبولها الحد منها ولا أن يكون تأسيسها بأذن من الجهة الإدارية، ولا أن تتدخل هذه الجهة الإدارية فى عملها بما يعوق إدارتها لشئونها ولا أن تقرر حلها أو وقف نشاطها عقابا لها، ولا أن تحل نفسها محل المنظمة النقابية فيما تراه أفضل لتأكيد مصالح أعضائها والنضال من أجلها". دور البرامج المفتوحة المصدر فى الخروج عن الهيمنة الأميركية: الفكرة فى البرامج مفتوحة المصدر أنها ببساطة برامح كل الكود بتاعها مفتوح ويمكن لأى أحد تعديله وتغييره وإعادة نشره، فكلنا نستخدم فى الغالب منتجات مايكروسوفت مثل وورد وباوربوينت وما إلى هذا بل وكلنا يستخدم فى الغالب أيضا إنترنت إكسبلورر وهو أيضا من منتجات مايكروسوفت ونستخدم نوع من أنواع الويندوز ألبس كذلك؟. المشكلة فى هذا أن هناك إعتمادا تاما على منتجات شركة واحدة بلا منافس, وكلما أخرجت هذه الشركة ويندوز جديد أو وورد جديد لهثنا وراءها لنشتري الجديد وإلا بقينا متخلفين عن الآخرين. وهكذا أصبح إعتمادنا على شركة واحدة إعتمادا كليا مما يشكل الكثير من المشاكل إن لم تكن الأخطار، لذلك هناك الآن حركة باسم المصادر المفتوحة, فهناك بدائل عن الويندوز مثل اللينكس, وبها برامج تعمل مع الويندوز حتى أنه إذا أردنا التحويل إلى لينكس لا نشعر أننا بمفردنا وأننا فقدنا الإتصال بكل الناس الذين لديهم ويندوز. بالنسبة لتركيب اللينوكس, ولكن الآن وحتى نكون واقعيين, يمكن إستخدام البرامج بشكل عام المفتوحة المصدر والتى تعمل على نظام ويندوز وليس بالضرورة اللينكس, مثل اوبن اوفيس وهو بديل لوورد وباوربوينت وإكسل بالإضافة إلى ذلك, فلنفكر قليلا فى مشكلة الإعتماد على شركة كبرى واحدة مثل مايكروسوفت, فهناك أيضا مشكلة أمنية أو تخص أمن الدول. يعنى لو أنه مثلا فى الحكومات الإلكترونية التى تقوم فى كل مكان الآن قامت الحكومات باستخدام منتجات مايكروسوفت أو منتجات أية شركة كبرى فإن كل بيانات الدولة ستكون على هذه البرامج التى لا تملكها وبالتالي فيها خطورة كبيرة على أمن الدولة. وهنا يأتى خطاب عضو الكونجرس من بيرو الذى إتخذ قرارا لدولة بيرو بعدم إستخدام منتجات مايكروسوفت فى الشئون الدولية أو المتعلقة ببيانات الدولة, بل إستخدام البرامج مفتوحة المصدر مما دعا مايكروسوفت لترد عليه محاولة طمأنته إلا أنه رد عليها مرة أخرى بالرفض الكامل. فالفكرة فى البرمجيات المفتوحة أن المصدر مفتوح وبالتالي لو حدث أى تلاعب فى الكود يمكن للكل معرفته لأنه مفتوح وهناك الملايين حول العالم من الذين يعرفون الكود ويعملون بالمصادر المفتوحة. أما لو كان مغلقا فيمكن وضع أي كود يريده المبرمج للحصول على البيانات أو للتلاعب فى البيانات, ولكن مفتوح المصدر لا يمكن أن يحدث هذا لأنه مفتوح هذا من الناحية الأمنية، وعندما يحدث عطل ما فنحن لسنا تحت رحمة المبرمج الأصلي وشركته لكي يصلح العطب بل يتم إصلاحه على الفور وفى غضون ساعات معدودة من كل المبرمجين حول العالم. ومثال لذلك هو إنترنت إكسبلورر مثلا: به كم هائل من الأعطاب والبدائل مفتوحة المصدر موجودة. كل الفيروسات تقريبا التى تأتى من الإنترنت (وليس من البريد) هى من إكسبلورر, وشركة مايكروسوفت تصلح الأمور ولكن كلما كان لديها الوقت أو كلما أصبح الخطر غير محتمل أو تم فضح الخطر. بينما في البرامح الأخرى مفتوحة المصدر مثل فايرفوكس على سبيل المثال, عندما يظهر عطل واحد يقوم الآلاف من المبرمجين بإصلاحه فى ذات اليوم. اتحاد كتاب الإنترنت العرب.. نموذج وتحدِّ ومن هذا المنطلق لمفهوم المجتمع المدني والنشر الإلكتروني قام مجموعة من المثقفين العرب بإنشاء اتحاد لكتاب الإنترنت العرب من أهم أهدافه حماية الحقوق الفكرية للكتاب العاملين فى مجال شبكة الإنترنت والدفاع عن حقوقهم ونشر الثقافة الرقمية فى أنحاء الوطن العربى ليكون منظمة غير حكومية لا تهدف للربح ومن أجل تحقيق الأهداف التالية: 1- نشر الوعي بالثقافة الرقمية في أوساط المثقفين والكتاب والإعلاميين العرب وكذلك نشر الوعي بالثقافة الرقمية بين أوساط الشعب العربي. 2- السعى لتحقيق قفزات نوعية في وعي الشعب العربي عموما للالتحاق بركب الثورة الرقمية التي تجتاح العالم. 3- المساهمة الفعالة في نشر الثقافة والإبداع الأدبي العربي، من خلال استخدام وسائل العصر الرقمي بما فيها شبكة الإنترنت. 4- توحيد الجهود الفردية للمثقفين العرب عموما وأعضاء الاتحاد خصوصا لنشر وترسيخ مفهوم الثقافة الإلكترونية، والدخول بقوة فاعلة ومؤثرة عالميا للعصر الرقمي. 5- رعاية المبدعين والموهوبين العرب، وتنمية قدراتهم والعمل على إبرازها ونشرها رقميا. 6- السعي الحثيث لإدخال الثقافة والإبداع العربي بأصنافه كافة، ضمن سيل المعلومات المتدفق السريع 7- ترسيخ مفهوم أدب الواقعية الرقمية، بصفته الأكثر قدرة على الاتساق مع روح العصر 8- إنشاء دار نشر إلكترونية تسهم في نشر الإبداع الأدبي العربي بكافة أشكاله 9- التواصل الفعَّال والمؤثر مع سيل المعلومات المتدفق من خلال التواصل مع المثقفين من أرجاء العالم كافة، وإنشاء صيغ للتبادل الثقافي معهم باستخدام شبكة الإنترنت. 10- العمل على إيجاد مكتبة إلكترونية عربية شاملة تحتوي على الإنتاج الثقافي العربي ونشره إلكترونيا. 11- الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية للكتاب الذين يمارسون كتاباتهم رقميا وعلى شبكة الإنترنت. وقد تم تسجيل الاتحاد مؤخراً كمؤسسة مدنية عربية بالأردن وسوف يتم بإذن الله إقامة أول مؤتمر عربى دولى للإعلان عن اتحاد كتاب الإنترنت العرب، والأهم أنه سيكون من أولويات العمل هو تشكيل لجنة عمل لبحث سبل مواجهة وتفعيل موضوع حماية الملكية الفكرية على الإنترنت، ليكون للاتحاد دوراً فعالاً تجاه هذه القضية. حسام عبد القادر باحث واعلامي مصري والنص ورقة قدمت في المؤتمر العربي الاول للثقافة الرقمية في طرابلس (مارس 2007) المصدر / ميدل ايست اون لاين http://www.middle-east-online.com/culture/?id=46056 
|

|
|
|
المشاركة2 |
|
المعلومات
مكتبي نشيط
البيانات
العضوية: 18065
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: فلسطيـن
المشاركات: 90
بمعدل : 0.01 يومياً
|
 نحو نظرية نقدية جديدة تؤطر الكتابة الرقمية الأدب والتكنولوجيا: أسئلة ثقافية وتأملات في المفاهيم الثقافة التكنولوجية غيرت إيقاع التعاملات الفردية والجماعية وجعلت الكل منفتحا على بعضه. ميدل ايست اونلاين بقلم: د. زهور كرام مدخل مفتوح كلما تطور الفكر البشري، وتطورت آليات تفكيره، كلما تغيرت أشكال تعبيره، ومن ثمة تغيرت إدراكاته للأشياء والحياة والعالم. وهو مبدأ يستقيم مع التطور التاريخي المنطقي للمعرفة في علاقتها بالتطور التاريخي للحضارات. إن انتقال الحضارات من مستوى تواصلي إلى آخر، أكثر استثمارا لتطور الفكر البشري الذي فيما هو يطور أدوات تفكيره، من حيث أنه يسعى إلى حياة أكثر انفتاحا على الخلق والإبداع وتجديد الرؤية، يولد أشكاله التعبيرية التي تعبر عن حالة الوعي بهذا الانتقال. يشهد الزمن الراهن شكلا جديدا في التجلي، بسبب الثقافة التكنولوجية، التي غيرت إيقاع التعاملات الفردية والجماعية. كما سمحت بفضل وسائطها الإلكترونية والرقمية بجعل الكل منفتحا على بعضه، ضمن شروط الثقافة الموحدة رقميا. وهذا، ساهم في تحرير الإبداعية الفردية التي وجدت فضاء خصبا لاستثمار رغبة الذات في التعبير تحت فيض الإمكانيات التقنية والمعلوماتية والمعرفية التي تقدمها هذه الثقافة، وكذا ما تقدمه وسائطها من خدمات مبهرة ومدهشة بدون قيد أو رقيب يعطل عملية الانطلاق في البحث والاكتشاف، وفي إمكانية التعبير والإبحار في المعلومة. ولعل هذا التحول في أدوات التواصل مع المعرفة، بالشكل الخدماتي السريع والفعال، يساهم في تطور أشكال التعبير التي لا شك أنها تعبر عن التحول في رؤيا العالم. 1- ا لأدب والتجلي الرقمي يشهد الأدب ومختلف أشكال التعبير شكلا جديدا من التجلي الرمزي، باعتماد تقنيات التكنولوجيا الحديثة، والوسائط الإلكترونية. وإذا كانت كل حقبة تاريخية يعبر أفرادها عن علاقتهم بالعالم، وتصورهم للوجود من خلال عدد من الأشكال الرمزية بالخصوص التي تكون ذات علاقة بآليات التفكير والمناهج والتواصل المتاحة، فإن الأدب الرقمي أو التفاعلي الذي يتم في علاقة وظيفية مع التكنولوجية الحديثة، لاشك أنه يقترح رؤى جديدة في إدراك العالم، كما أنه يعبر عن حالة انتقالية لمعنى الوجود، ولمنطق التفكير. فهل يمكن الحديث عن بداية تشكل مفهوم جديد للأدب ولمنتجه ومتلقيه؟ وهل يمكن القول بأننا على عتبة شكل تعبيري تقني إلكتروني، سيقترح تجليه، باعتباره إمكانية جديدة في التعبير عن العلاقة بين الذات والعالم. وهل حققت الممارسة الإبداعية الرقمية في التجربة العربية، تراكما مهما حتى تصبح متنا مؤهلا للاشتغال النقدي، مادام الهاجس في كل تجربة أدبية هو البحث عن المنطق الذي يشكل نظام التجربة؟ وهل يمكن افتراض ممارسة أدبية بالتنازل عن الذاكرة أو تجاوزها، مادامت الإمكانيات الرقمية تقدم للمشتغل الرقمي كل حاجياته من المعلومة والمعرفة والنصوص؟. لاشك أنها أسئلة سياقية يطرحها واقع الممارسة التكنولوجية في المشهد المعلوماتي والثقافي العربي. وهي أسئلة نسعى من خلالها إلى التفكير بصوت موضوعي في التجلي الرقمي للممارسة الأدبية العربية من خلال رؤية موضوعية تتوخى البناء المعرفي والفلسفي والأدبي. لكن استحضار بعض الفرضيات السياقية والمعرفية فيما يخص نظرية الأدب بشكل عام، يعد ضرورة مهمة في عملية تأمل الأدب في علاقته بالرقمي. 1 –1 إن بناء أي تصور معرفي ومفهومي لممارسة أدبية، ينطلق من ذاكرة ثقافية ونصية بما فيها الموروث والحداثي. 1-2 إن أي شكل أدبي لا يولد من العدم، كما أنه لا يتلاشى، وإنما يستمر في أشكال تعبيرية سواء كخلفية نصية، أو يدخل في علاقة جديدة مع البناء الجديد، ليستمر وجوده باعتباره ذاكرة للكتابة والنص والتعبير. 1-3 إن كل شكل جديد للتجلي الأدبي، يطور نظرية الأدب ولا يلغيها. 2 - الأدب الرقمي: مفاهيم في طور التشكل إذا كانت العملية الإنتاجية في وضعية الأدب المطبوع ورقيا، تتم من خلال المنتج والمتلقي والمنتوج( النص)، فإن نظرية تداول هذه العملية الإنتاجية من خلال الوعي النقدي قد اجتهدت عبر عصور عديدة، وباعتماد مناهج أدبية وأدوات إجرائية في محاولة البحث أو توصبف المنطق الذي تحتكم إليه العملية الإبداعية، وإنتاج إدراك لهذا المستوى العلائقي بين مكونات الفعل الإنتاجي الأدبي، فكانت الإدراكات النقدية تختلف فيما بينها، وتتفاوت في تشخيصها لهذا المستوى العلائقي، وذلك بناء على الفرضية الفلسفية التي تنطلق منها. ولعل رغبة الوعي النقدي في إيجاد تفسيرات للسر الإبداعي وفي السعي إلى بناء ملامح الوعي الممكن للجماعة أو الفرد أو الحضارة من خلال الممارسة الإبداعية هو الذي كان وراء إنتاج هذا التعدد الهائل، والمفتوح باستمرار على فرضية الوعي النقدي فيما يخص آليات القراءة. ولعلنا قد نفهم هذا التعدد الذي يتوالد مع كل تحول في بنية /تركيبة العملية الإبداعية من خلال سر إنتاج اللحظة الإبداعية، وأهميتها في إنتاج رؤيا العالم. وهي اللحظة الفاصلة بين الواقعي والتخييلي، أو بعبارة أخرى هي الحالة التي يصبح عليها المبدع عندما يبدأ في الانزياح عن الواقعي المعيشي، والانخراط في المتخيل حيث فرصة التجلي الرمزي لوعيه المحتمل، والذي يكون وراء طبيعة بناء النص. إن التفكير في الأدب الرقمي من خلال استحضار الأبعاد المعرفية والبنائية والنقدية والفلسفية لنظرية الأدب في إطاره الشفهي أو المطبوع ورقيا، مسألة يفرضها التصور الفلسفي للأدب، سواء في بعده الجمالي المعرفي، أو في بعده التقني الأسلوبي المرتبط بالخطاب. كما تفرضها مشروعية مرافقة النقد للتجربة الأدبية وهي تشهد اختلافات في تمظهراتها وتجلياتها. لهذا، فالحديث عن تجربة الأدب المطبوع ضمن إستراتيجية التفكير في الأدب الرقمي، مسألة مشروعة في إطار محاولة فهم هذا الغنى الذي يتولد عن رغبة إدراك الحالة الإبداعية. والتي معها يشتغل الفكر البشري ويطور أدواته، مادام فعل القراءة في نص أدبي هو فعل التفكير الذي يعتمد أشكالا من الأدوات والمناهج. أن نقرأ الأدب الرقمي سواء في إطار تحديده النظري، أو من خلال تجليه النصي، يعني أن نمارس التفكير باعتماد وسائل حديثة تنتمي إلى ثقافة النص الرقمي، ولكن في نفس الوقت نفكر من خلال ذاكرتنا النصية والنظرية. 2- 1الأدب بين الرقمي وعبر الرقمي إن الاقتراب من الأدب في وضعه الرقمي، هو اقتراب من المتغير في الحالة التي تصبح عليها الممارسة الإبداعية، عندما تعتمد دعامة الرقمي. يعني انتقال سياقي وبنيوي وأسلوبي في الظاهرة الأدبية. لهذا، فأول متغير يصادفنا عند تأملنا لهذه التجربة الأدبية هو الرقمي باعتباره وسائط تكنولوجية وإلكترونية، بها يتشكل النص الأدبي وينفتح على زمنه التكويني، بل تتحول بدورها إلى عنصر وظيفي. تبدأ مجرد وسائط في إطار الخدمات التي تقدمها التكنولوجيا الحديثة لكل مستخدم لها، ولكنها تصبح مكونا وظيفيا بالنسبة لمنتج النص الأدبي، نظرا لكونها تصنع بنائية النص، ومن ثمة تحدد شكله، وشكل قراءته. ولكون النص يتحول بموجبها إلى حالة مغايرة عن النص كما يريد المبدع أن ينتجه. يحضر الرقمي في هذا الشأن باعتباره وسيطا في العملية الإنتاجية للنص ، لأنه يقدم خدمات للنص ودعما معلوماتيا وتوثيقيا ونصيا ولغويا ورمزيا للكتابة. لكنه يعيش بدوره التحول ويصير وظيفيا. لهذا،يمكن القول بأن الأدب يصبح رقميا عندما يتحول الرقمي إلى عنصر وظيفي، أي يصبح مكونا بنائيا ، ويتحكم في تدبير القراءة وتشكل النص.ولكن النص يبقى عبر رقمي عندما يظل الرقمي مجرد وسيط لبناء النص ليس إلا. والمؤشر على ذلك، أن النص إذا ما تم طبعه ورقيا فإنه قد يفقد بعض بهاراته الجمالية التقنية مثل الصورة المتحركة والصوت وغير ذلك، ولكنه يحافظ على إطاره العام. هل يكفي أن ننتج نصا باعتماد الوسائط الرقمية حتى يتحقق النص الرقمي؟ ما الذي يمنح للتجربة الجديدة شرعيتها الإبداعية؟ أليس منطقها المختلف هو الذي يمنح للتجربة التعبيرية أصالتها؟ 2-2-المنتج الرقمي إنه الذي ينتج النص الرقمي، مستثمرا وسائط التكنولوجيا الحديثة، ومشتغلا على تقنية النص المترابط hypertexte .وموظفا مختلف أشكال الوسائط المتعددة. هو لا يعتمد فقط فعل الرغبة في الكتابة والإلهام الذي يرافق عادة زمن التخيل في النص المطبوع أو الشفهي ، ولكنه إضافة إلى ذلك إنه كاتب عالم بثقافة المعلوميات، والتقنية الرقمية بل يتقن تطبيقها في علاقتها بفن الكتابة. هذا يعني أننا بصدد كاتب له معرفة بالعلم. وهذا شئ جديد في نظرية الأدب التي لم تكن تنظر إلى المبدع في إطار تكوينه العلمي، بقدر ما كانت تقف عند نضج متخيله و إبداعية نصه. ينتج الكاتب الرقمي حالة نصية متشعبة وغير تتابعية من حيث أفق التلقي. وذلك بحكم اشتغال النص المترابط الذي يمنح اختيارات متعددة للقراءة، كما يمنح للقارئ أزمنة مختلفة للتواصل مع النص من خلال تقنية الروابط. لكن هل تكفي إجادة الثقافة الرقمية والمعلوماتية، وامتلاك الدرب على تدبير الفضاء الإلكتروني، لكي يتحقق مفهوم الكاتب/المنتج الرقمي؟ وهل استحضار بعد التكوين العلمي/ التقني فيما يخص زمن تشكل النص الرقمي، بالنسبة للكاتب أو القارئ، يلغي البعد التخييلي في عملية الإنتاج؟ وهل نقول بموت الموهبة أو هذا الحس المنفرد للمبدع، والذي يجعله يرقى دون غيره باللحظة إلى مستوى تعبير جمالي مثلما اشتغلت عليه نظرية الأدب منذ قرون؟ ألا يأخذنا مثل هذا القول إلى الاعتقاد بانتقال العملية الإبداعية من مجال الرمز إلى مجال العلم والتقنية؟ لكن أليس الأدب منذ نشأته هو موقف أو تعبير عن وجود الذات، وهو جمال ضد العبث، وأثر ضد العبور، لأنه الخزان الرمزي لوجدان الشعوب والحضارات؟ وهل يمكن اعتبار التقنية الرقمية التي يشتغل بها وعليها الكاتب الرقمي، عبارة عن تقنيات كتابية ثم نصية فمكونات إبداعية؟ وفي هذه الحالة، هل يتم الاعتماد من حيث وصف إبداعية النص الرقمي، بمدى إجادة الكاتب للممارسة التقنية الرقمية؟ أم يبقى الرهان على نضج العملية الإبداعية، من حيث البناء الإبداعي وقوة التخييل، بالإضافة إلى طبيعة اشتغال العناصر الرقمية وعلاقتها بصنع النص؟. مع ذلك، وانطلاقا من النصوص الرقمية العربية القليلة، كما في تجربة الكاتب محمد سناجلة، سنلاحظ أن المتخيل حاضر بقوة في تشكيل الحكاية. كما أن وضعية هذا المتخيل تسمح بتحرير الذاكرة (ذاكرة القارئ) من سلطة الواقعي الرقمي. ونجد نفس الشئ في تجارب غربية فرنسية مثلا حيث نلاحظ خاصة في الرواية الرقمية أن السرد ما يزال يحتفظ بقوته، والحكي يتحكم في بناء النص. بل يمكن اعتبار المكونات الرقمية عاملا وظيفيا و فنيا وجماليا أيضا يساهم في الارتقاء باللحظة المتخيلة للنص الحكائي في وضعية النصوص السردية. ما يلاحظ على طبيعة المنتج الرقمي في علاقته بنصه وبمتلقيه، أنه ينطلق من مبدأ التحرر من وهم النص المكتمل والذي لا ينتمي إلا إلى منتجه. وإذا جربنا التفاعل مع النص الرقمي الأخير لمحمد سناجلة " صقيع" سنلاحظ التصريح بذوات مشاركة في إنتاج النص مثل التصريح باسم المساعد في الإخراج الفني وهو شخصية واقعية، كما أن المنتج / الكاتب يدفع بشكل مباشر بتقنية التفاعل مع نص "صقيع" نحو التحقق عبر مجموعة من الاقتراحات التي يقدمها للقارئ لكي يمارس تفاعله من خلال الإمكانيات المتاحة في الاقتراحات والتي تصل إلى حد تعديل نهاية النص. وكما لاحظنا من العينة التي تفاعلت مع نص "صقيع" أن حدود التفاعل ما يزال لا يقترب من النص، والاشتغال عليه من حيث إعادة تكوينه عبر ممارسة التفاعل مع النص المترابط، بحيث أن مجمل التفاعلات ما تزال في حدود تسجيل الانطباع حول "صقيع" باعتبارها تجربة جديدة في الكتابة. وهنا نتساءل: هل طبيعة حضور النص المترابط، هي التي تعمل على تنشيط تقنية التفاعل بشكل إيجابي؟ أم أن التجربة في وضعيتها التجريبية في المشهد العربي في حاجة إلى دربة الممارسة، وإلى ثقافة التفاعل؟. 2-2 المتلقي الرقمي: نتيجة لطبيعة تشكل النص الرقمي ، فإن قراءته تستلزم امتلاك نفس آليات الثقافة الرقمية. وهذا يفترض على القارئ أن يمتلك هو الآخر، شأنه شأن الكاتب الرقمي، نفس إمكانيات الثقافة الرقمية. مما يعني أن منتج النص الرقمي ومتلقيه يستعملان نفس التقنيات الرقمية، وفي هذا اختلاف بين الرقمي والنصوص الشفهية والمطبوعة ورقيا المفتوحة على الأقل على قراء مختلفين من حيث تناولها شريطة أن تكون لديهم نفس المعرفة باللغة التي يتم بها إرسال النصوص. أما في وضعية النص الرقمي فإن الاقتراب منه لا يتم إلا عبر الوسائط الرقمية إضافة إلى اللغة المرسل بها. غير أن الملاحظ أن القارئ الرقمي يعيش حرية مفتوحة على الخيارات الذاتية في القراءة النصية. إذ تسمح له تقنية النص المترابط (hypertexte) بأن يختار للنص مدخلا للقراءة ، كما يصبح هو المتدبر لأسلوب القراءة ومنهجها. لديه حرية المرور من أي طريق شاء، كما لديه صلاحية القرار من أين يبدأ وأين ينتهي. وهذا ما يجعله منفتحا على قراءات مختلفة، كلما تواصل مع النص وغير طريقة القراءة، ومارس حريته في أن يدخل عالم النص من بدايات مختلفة عن قراءاته السابقة لنفس النص. ويؤكد منتجو النص الرقمي على ضرورة هذا الحضور للقارئ كما نجد في نص صقيع لمحمد سناجلة حين يدعو قراءه للدخول في تجربة إعادة كتابة النص. لكن: ألا يمكن أن يؤدي هذا التحرر من سلطة النص الرمزية بالقارئ إلى التشتت، في المداخيل والنصوص والروابط بدعم من مبدأ الإبحار الذي يصبح فعلا ملازما لفعل القراءة؟ ألا يمكن الحديث، في هذا إطار هذا التوجه، عن كون النص الرقمي يظل موجودا بالقوة حتى تتم قراءته التي تفعله وتمنحه الوجود؟ طبعا فعل القراءة كان دائما هو الذي يمنح للنص أو الكتابة قوة الوجود، لكن في وضعية النص الرقمي فإن طبيعة تشكيله تجعله لا يعيش الثبات في وضعه البنائي، مما يجعل من القراءة فعلا مؤسسا بامتياز. هل النص الرقمي في وضعه الأول، يعد مؤشرا لإعادة إنتاج نص/ نصوص آخر من طرف قارئ "في حالاته المتعددة"؟. ألا يمكن أن يدفعنا مثل هذا الوضع إلى التفكير في خفوت دور المنتج للنص الذي يتم تجاوز نصه بإعادة الإنتاج؟. هل أفق النص الرقمي هو أن يصنع كل قارئ نصه المترابط ( son hypertexte)؟ هل معنى هذا أن النص المترابط الذي يشكل النص الرقمي في أكثر تجلياته النصية، هو هذا النص الذي لا يوجد بالفعل إلا عبر قراءته المتجددة والمتحررة من البعد الخطي؟ ألا نشعر بتشتت النص، ليس على الشكل التجريبي الذي تطور مع جنس الرواية المطبوعة، ولكن التشتت في معنى انفلات النص من زمن الاكتمال التكويني؟ هل الكتابة الرقمية داخل الشكل الأدبي هي حالة جديدة، من حالات إدراك الوعي الإنساني الذي بدأ يفقد قيمة الوحدة منذ المجتمع الصناعي؟ ألا يمكن الشعور بفكرة العبور أو التلاشي وعدم ترك الأثر. أو تغييب الذاكرة ذاكرة النص؟ هل البعد الافتراضي لحالة الأدب مع الشكل التكنولوجي، يترجم تصورا يجرد الإنسان من بعده التاريخي والثقافي والتخييلي؟ هي كلها أسئلة مشروعة الطرح في إطار البناء المعرفي والفلسفي والجمالي للتجربة الرقمية. وطرحها لا يعني اتخاذ موقف من هذا التجلي الرقمي للظاهرة الأدبية، بقدر ما هو عبارة عن شكل من أشكال الوعي النقدي والفلسفي التي من المفروض أن ترافق عملية التفكير في بناء تصور معرفي حول تجربة أدبية. وهذا يؤكد على أن القول بأن التكنولوجية ستضعف الإيديولوجية قول فيه نقاش، مادامت الإيديولوجية هي تأويل للفكر والمعرفة بموجب المصالح. والتوظيف التكنولوجي لا يمكن التفكير فيه خارج البعد الفلسفي والمعرفي والإيديولوجي شأنه شأن كل تعبير إنساني. 2-3- النص المترابط أفقا للنص الرقمي يتضح من خلال الممارسة والتفكير أيضا في الإنتاج الإبداعي الرقمي، أن تقنية النص المترابط تشتغل بقوة في إعطاء النص شرعيته التي لا تكتمل إلا مع كل قراءة، على اعتبار أن هذه التقنية تمنح للقارئ من جهة خيارات في القراءة، وحرية في تدبر طريقة تلقي النص. كما تجعله يحقق فعل الإبحار بالشكل الذي يختاره، بل يمكن لقارئ لنفس النص أن يحقق مع كل قراءة نصا مترابطا قد لا يشبه النص السابق. وهنا يدخل فعل التفاعل باعتباره تقنية وظيفية في القراءة. هل معنى هذا أن النص المترابط في وضعية قراءته، هو الذي يحقق للنص رقميته، في إطار التفاعل مع القارئ وباقي الوسائط الأخرى؟ في هذا المعنى، يصبح النص الذي ينتجه الكاتب ليس هو الذي يتم تلقيه من طرف القارئ . إنما نص آخر يتشكل في علاقة تفاعلية فوق الشاشة بين القارئ حسب وضعية حالته وبين النص المترابط. هل يمكن التفكير في كون النص الرقمي، هو حالة بنائية نصية تعيش التشكل باستمرار. وأصالة هذا النص هي في قدرته على تحقيق مبدأ التفاعل، بطريقة وظيفية تجعله يغادر الثبات، وينفتح على الاحتمالات الممكنة، انسجاما مع علاقة القارئ التفاعلية مع النص المترابط؟ هل يمكن الحديث أيضا هنا عن مبدأ الشراكة في إنتاج النص الرقمي؟ إذا كان الوضع كذلك، فهل يمكن الحديث عن النص المترابط باعتباره النص المحتمل الذي ينجزه القارئ في حالات متعددة ومختلفة؟ وهل في هذا، تطوير للرؤية النقدية التي تبحث عن لاوعي القراءة والقارئ، بعدما كان البحث في لاوعي الكاتب والجماعة التي يحكي من خلالها أو يعبر عنها؟. أم أن الأمر يتعلق بلاوعي العملية الإنتاجية ككل، تلك التي تساهم فيها كل هذه العناصر بما فيها الكاتب والقارئ والتكنولوجيا والوسائط والنص المترابط؟. استنتاجات مفتوحة لاشك أننا نعيش لحظة تاريخية نشهد من خلالها تشكل ثقافة جديدة، تعتمد في مرجعيتها والياتها التواصلية على التكنولوجيا الحديثة، التي تعبر عن أرقى مكتسبات تطور مسار الفكر البشري، وهي ثقافة تحدث في إطار استحقاقات حقوقية وعلمية واجتماعية وتنموية، في مناخ يدفع إلى المزيد من إعطاء الفرصة أمام التعبير الذاتي الحر. ولاشك أيضا، أن عملية بناء تصور حول تجربة الممارسة الأدبية الرقمية في المشهد العربي، تتميز بالأهمية والخطورة في ذات الوقت، لأنها بمثابة شمعة وسط ظلام كثيف. وهذا ما يفرض على الأقل التعامل مع زمن بناء التصور حول هذه التجربة الإبداعية الجديدة، باستحضار مجموعة من الأسئلة، سواء المتداولة فيما يخص علاقة الفكر العربي، بكل ما هو جديد وغير مألوف في التفكير والممارسة، أو الجديدة تلك التي تنبثق مع عملية الانخراط في التجربة الجديدة تنظيرا وجرأة. كما أن الخطورة تأتي من كون التجربة الأولى يتم التعامل معها، عادة، بشئ من الدهشة والانبهار وهي مسألة مشروعة في إطار طموح الفكر البشري إلى الكشف والاكتشاف. غير أنها دهشة في حاجة إلى تحصين فكري وثقافي وفلسفي يدعم عملية البناء من أجل ضمان انخراط إنتاجي في التجربة الجديدة. وعليه، يمكن تعزيز التفكير في وضع تصور حول التجربة باستحضار الفرضيات التالية: - إن الانتقال إلى الدعامة الرقمية، يعطي فرصة جديدة بل مختلفة أمام التجلي الإبداعي، انطلاقا من كونه تجليا مختلفا عن المألوف في التشكل والتكون عن الشفهي والمطبوع، حيث البنية التركيبية و سياق الإنتاج وكذا الوسائل التعبيرية والبنائية مختلفة عن المتعاقد عليه في الممارسة الإبداعية، وهذا من شأنه أن ينتج معرفة جديدة بوضعية الوعي في الزمن الراهن. - إن ظهور أي شكل تعبيري جديد ، يعود إلى ظهور قوانينه. وهي قوانين تعبر عن أنماط التفكير والتواصل في المرحلة. وتبقى القراءة مستوى تواصلي تقني ومعرفي وحضاري، من أجل إنتاج معرفة طبيعة اشتغال هذه القوانين، ورصد الوعي المنتج لها ، في سبيل فهم المرحلة بمنطقها وقوانينها. إذ، لا يتعلق الأمر فقط بمجرد تفكيك تجربة تعبيرية إلى عناصرها البنيوية والقول بجدتها أو لامألوفيتها، وإنما القراءة سؤال فلسفي وأسلوب في التفكير في المرحلة التي نعيشها. - ما يمنح لتجربة النص الرقمي شرعية التداول في المشهد الإبداعي العربي، هو الانخراط في ممارسة هذا التعبير من طرف المبدعين العرب. - إن تحقيق (إنجاز) متن مهم من النصوص الرقمية الإبداعية العربية، خطوة مهمة لتحقيق تصور مسؤول نقديا وتنظيرا حول طبيعة التجربة. ذلك، لأن بناء تحديدات مفهومية للخطاب الإبداعي الرقمي في التجربة العربية، ما يزال في طور التفكير أمام ضعف الممارسة الإنتاجية. لأن الاشتغال على النصوص الرقمية باعتبارها متنا ونسقا، هو الذي يبلور منطق هذا الأدب، ويسمح بالتالي ببناء تصور حول منطق الممارسة الإبداعية الرقمية. - التحسيس بالثقافة الرقمية ودورها الحضاري في تطوير علاقة الفكر بالمعرفة بشكل فعال وسريع، لا يجب أن يتحول إلى نظرية نقدية تؤطر عملية الكتابة الرقمية. ذلك، لأن النصوص هي وحدها المؤهلة لتطوير ثقافة قراءة النص الرقمي الأدبي، والتنظير لمنطق هذا الأدب. - كثيرا ما رافق عملية قراءة النص الإبداعي العربي الشفهي و المطبوع بالخصوص (الرواية ،القصة القصية والشعر) سؤال تطبيق النظريات الغربية النقدية، فهل يمكن أن يضئ هذا السؤال تجربة القراءة في النصوص الرقمية العربية، حتى تطور التجربة العربية شكل قراءتها، وتطور مفاهيم القراءة الرقمية انطلاقا من الممارسة العربية. دون أن يعني هذا، التخلي عن مبدأ التفاعل مع التجارب الغربية السباقة إلى هذه التجربة، ولكن لما لا يتم التعامل مع التجربة الرقمية العربية بنوع من الإصغاء، كما وجدنا مع النقد الفرنسي الذي طور خطابه بتمثل التجارب النقدية الروسية والألمانية وغيرهما، ولكنه لم يقف عند لحظة التمثل والتطبيق، إنما أنتج خطابا نقديا (أي طريقة في التفكير) من صميم الإبداعية الفرنسية. مما أعطى للنقد الفرنسي شرعية تداوله عالميا. وبالتالي ساهم في نشر مفاهيم الفكر الفرنسي؟ - إن التفكير في التجربة الإبداعية الرقمية في المشهد الثقافي العربي، هو تفكير في مستوى من مستويات الحداثة في الممارسة العربية. ذلك، لأن شكل التعامل مع هذه الممارسة يحقق تصورا عن شكل الانخراط في هذا المتغير الحداثي العالمي. وإذا كانت هناك كثير من معيقات الفكر الحداثي ما تزال تعرقل كل عمل انتقالي حقيقي نحو الحداثة باعتبارها ممارسة في الفكر والحياة واليومي في التجربة العربية، ولكون كثير من مفاهيم الحداثة كما ظهرت، وتظهر، في الغرب ما تزال مهيمنة على الخطاب النظري العربي، وتجد صعوبات أجرأتها على الواقع والسلوك والحياة، فلا شك أن هذا الوضع الإكراهي يشتغل معيقا في عملية الانطلاق المرن للمبدع العربي بكل حرية وجرأة في مختلف وسائل التكنولوجية الحديثة، واستثمارها من أجل تعبير يستوعب مختلف التحولات التي يعرفها الوعي. وإذا كان الإبداع مع وضعية الرقمي أصبح مرتبطا بشرط علمي وتقني على المنتج والمتلقي الانخراط التكويني فيهما، فإننا في هذا الصدد نسجل ملاحظة على السياسات الرسمية العربية التي ما تزال تدفع بأدمغتها التكنولوجية للهجرة إلى الغرب الأوروبي و الأمريكي، مما يجعلها تتحول، أي الدول العربية، إلى مراكز للتكوين. ويعيد التاريخ نفسه في هذا الإطار عندما نستحضر عملية جلب الاستعمار الأوربي خاصة الفرنسي لليد العاملة من المغرب العربي إبان الاستعمار،ثم ما بعد استقلال الدول المغاربية من أجل بناء فرنسا. تلك مجموعة من الفرضيات والرهانات ، أو التساؤلات التي نرى بطرحها، أو حتى بمجرد التفكير فيها، قد نساهم في بناء موضوعي وفعال لعملية التعامل مع تجربة النص الرقمي، بخلفية معرفية وفلسفية واضحة تساهم في عملية التحسيس وأيضا في عملية الإنتاج . مع ذلك، تبقى القراءة باعتبارها أسلوبا في التفكير، وطريقة إجرائية ومعرفية وفلسفية هي القادرة على إدراك أو على الأقل الاقتراب من معرفة المنطق الذي يشكل النص الرقمي. ويبقى رهان الممارسة التجريبية خير محك للتفكير في هذه التجربة. وتبقى عملية انخراط كل مبدع ومثقف عربي في رهان هذه الممارسة، إنتاجا أو تنظيرا خطوة حضارية بامتياز. الدكتورة زهور كرام روائية وناقدة وأكاديمية مغربية والنص ورقة قدمت في المؤتمر العربي الاول للثقافة الرقمية في طرابلس (مارس 2007) المصدر / ميدل ايست اون لاين http://www.middle-east-online.com/culture/?id=46049

|

|
|
|
المشاركة3 |
|
المعلومات
مكتبي نشيط
البيانات
العضوية: 18065
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: فلسطيـن
المشاركات: 90
بمعدل : 0.01 يومياً
|
 قراءة في اعمال محمد سناجلة عن مفهوم الكاتب الرقمي ونظرية الواقعية الرقمية هل تؤسس الكتابة الرقمية لقطيعة مع فن القول المنحدر من الثقافتين الشفهية والكتابية في طريقها لجنس أدبي مختلف؟ ميدل ايست اونلاين المصدر/ ميدل ايست اون لاين بقلم: د. محمد أسليم [RIGHT]. مفهوم الكاتب الرقمي 1. 1. الرقمية و"دَمقرطة" ممارسة الكتابة مع الانتشار الواسع للحواسيب الشخصية ابتداء من سبعينيات القرن الماضي، ثم ظهور شبكة الإنترنت في مستهل تسعينيات القرن نفسه عرفت الكتابة الأدبية منعطفا يتميز أساسا بنقطتين: الأولى: إقحام الآلة نفسها في عمليتي الكتابة والقراءة الأدبيتين، بما جعل بالإمكان الحديث عن "آلات للقراءة وآلات للكتابة" (1). ليس هذا بالأمر الجديد؛ فالمحاولات الأولى في هذا الباب انطلقت متزامنة، ومنذ حوالي نصف قرن، من فرنسا وألمانيا وكندا، ولكن الرقمية تمد الآن هذا القطاع الأدبي بجميع وسائل التطور بما يجعل هذا النوع من النصوص يخرج من دائرة حفنة من المتخصصين والمجربين إلى الجمهور الواسع من الأدباء. الثانية: تخلص جميع الكتاب الفعليين والافتراضيين من المصافي التقليدية للنشر، متمثلة في هيئات التحرير ولجان القراءة في الصحف والمجلات ودور النشر، الأمر الذي فتح الباب عمليا، وأمام الجميع، كتابا مكرسين ومبتدئين، أدباء ومتأدبين، واسعا لنشر إنتاجاتهم الأدبية. مع الرقمية اليوم، بات يكفي المرء أن يمتلك جهاز حاسوب متصل بالشبكة ومساحة لوضع نصوصه على الخط، بل وحتى نصوص غيره، إن شاء، ويلم بالأبجدية الأولى لإنشاء صفحات ويب التي صار العديد من شركات الاستضافة المجانية يُعفي منها المستخدمين عبر المدونات أو الصفحات الجاهزة للاستعمال، فيصير مالكا لما يُعادل ليس مطبعة ورقية فحسب، بل وكذلك دار نشر قادرة على توزيع منتوجاتها في أرجاء الكوكب الأربعة، على مدار الساعة، وبدون حكاية نفاد الطبعات. كان طبيعيا أن يلتحق بهذه القارة الافتراضية الجديدة حشود ممن يعتبرون أنفسهم كتابا ويغرقونها بما يُقدَّم باعتباره شعرا أو سردا سواء فرارا من مصافي النشر الورقي التي أقصتهم ـ عدلا أو ظلما ـ أو حتى دون المرور من هذه المؤسسات أصلا مفضلين الحصول على الوضع الاعتباري لـ "كاتب" في عالم الرقم دون الورق. وحيث إن كل حقبة للتغييرات الكبرى تولد أشكالا جديدة للجهل والتهميش، كان طبيعيا أن يتخلف عن اللحاق بالقارة الافتراضية ـ عن إرادة وإصرار أو عن عجز وضعف ـ عدد كبير، بل الغالبية العظمى من الكتاب المكرسين في عالم النشر الورقي فيهم من يتقلد مهام كبرى في هيئات واتحادات للكتاب، بل ومن هؤلاء من يشن حربا شعواء في الظاهر أو الباطن على الشبكة العنكبوتية ذاتها. مثل هذا الموقف متوقع بالنظر إلى أن الرقمية بصدد العصف بالوضع الاعتباري التقليدي للكاتب، حيث كان المبدع يحظى بسلطة رمزية قوية داخل المجتمع، لكن أيضا بالنظر لوضوح معايير ولوج الوضع الاعتباري للكاتب متمثلة في المصافي وهيئات قبول ترشيحات الانضمام لهيئات الأدباء والكتاب. المسألة هنا لا تهم العالم العربي وحده ولا الأدب دون سائر الحقول المعرفية الأخرى: فقد لخصها أمبرتو إيكو، في أحد حواراته، بإشارة لا تخلو من تشاؤم حيث قال "إن الاتجاه ماض نحو حضارة لكل فرد فيها نسقه الخاص لتصفية المعلومات، أي أن كل فرد يصنع موسوعته الخاصة. واليوم، مجتمع متألف من 5 مليار موسوعة متنافسة، لهو مجتمع لم يعد يتواصل إطلاقا." (2) لكنه عاد ليمتنع عن إبداء أي حكم قاطع في المسألة تاركا الباب مفتوحا لجميع التكهنات ومجتهدا في صياغة تخمين متفائل: "قد تكون ثورة في الذوق لسنا قادرين على تبين نتائجها. فمن وجهة نظر تقليدنا الثقافي، قد يكون شيئا في منتهى الخطورة. ولكن يمكننا التفكير فيه بطريقة أخرى: مصافي الذوق في الأدب كانت تهم 0,5 % من السكان. إذا كان اليوم 70 % من السكان المبحرين في الشبكة يفضلون شعرا أو محكيا وجدوه صدفة، يمكننا القول إن هؤلاء الناس الذي ظلوا إلى الآن مقصيين من تذوق الإنتاج الأدبي قد استطاعوا أخيرا الدخول في اتصال مع هذا الشكل أو ذاك من أشكال التعبير الأدبية. وسيكون الأمر كذلك ثورة. ثورة ممكنة التطويع مادام الفرد الذي يربي نفسه صدفة في النت ويلتهم أي شيء، سيجد نفسه عندما سيلتحق بالجامعة أو يشرع في العمل، قد عثر بأعجوبة على مقاييس وسيطور جموحه السابق؛ ولكن هذا كله لا يعدو مجرد تكهن خالص." (3) ليس معنى هذا أن كل ما يُنشر في الشبكة ينجح في استقطاب حشود القراء؛ فللإنترنت مصافيه الضمنية التي تكشف عنها عدادات زوار المواقع ودرجة تفاعل القراء مع النصوص المنشورة، ولكن الجديد هو أن الإنتاج يكون عموما في متناول مستويات عديدة من القراء لا يمرون جميعا بالضرورة من الجامعات، ومن ثمة يحصل أن تحقق كتابة في منتهى الابتذال، من وجهة نظر النقد الأدبي الرصين، نجاحا منقطع النظير على نحو ما نجد في العديد من المنتديات التي تنشر فيها نصوص قصصية وروائية ليس لها من هذين الجنسين إلا الاسم. 1. 2. الرقمية وإشكالية تعريف "الكاتب" يبدو أن الشبكة قد أمدت الآن مقولة "موت المؤلف" التي تنبأ بها ميشال فوكو منذ سنة 1967 بكل وسائل التحقق، إذ باتت الحدود بين القراءة والكتابة تتقلص إلى حد أتيح معه ابتكار مصطلحي "القرا-كتابة" و"المؤلف ـ القارئ"، على التوالي: l’écrilecture وl’aucteur. فهل يجوز الحديث عن "كاتب رقمي"؟ إذا كان الأمر كذلك فكيف؟ بل إذا كان تاريخ الكتابة الإبداعية الطويل يعلمنا أن للإبداع الأدبي اقترانا وثيقا بالسلطة، وكان الإنترنت يثبت يوما عن يوم أنه فضاء لاختفاء هذه السلطة، فلماذا وكيف وبأي صفة نمارسها عبر ادعاء امتلاك تسمية هذا الفرد بأنه "كاتب" وذاك بأنه "ليس بكاتب"؟ لدى البحث في الشبكة عن مصطلح "الكاتب الرقمي"، في المجالين الفرنكوفوني والإسباني على الأقل، لا نجد أثرا لهذه الصفة (4). في المقابل نجد مفهوما ذا صلة، لكن بحضور خافت جدا هو مفهوم "الكاتب الشبكي" le cyber-écrivain، ويتسمى به مجموعة من الكتاب الذين لا يزاولون فعل الكتابة إطلاقا خارج الحاسوب والشبكة. التجمع الوحيد لهذا النوع من الكتاب هو ما يوجد في موقع e-critures.org، ولا يشمل جميع المبدعين وحركات الكتابة الرقمية المعروفين في الشبكة، كمجلتي Doc(k)s وalire، وجماعة Mésuline، ومجموع أعضاء شعبة الوسائط التشعبية بباريس الثامنة. في المقابل، تشكل قائمته البريدية فضاء لأكبر تجمع فرنسي من المبدعين والنقاد الرقميين، بما يفيد أن الهم الأول لهذا الاحتشاد هو إبداعي نقدي أكثر منه مؤسساتي. بالموازاة مع ذلك، يتردد في العالم العربي حديث عن "الكتاب الورقيين"، و"الكتاب الرقميين" و"كتاب الإنترنت" الذين لهم هيئة بالتسمية ذاتها. فهل نمارس نوعا من السباحة ضد التيار أم أننا نأتي بنوع من البدعة؟ ما المقصود بهذه الأسامي؟ هل الحدود بينها واضحة بما يجعل عملية تصنيف هذا الكتاب أو ذاك ضمن فئته المقابلة أمرا ممكنا؟ كيف نعرف هذا الفاعل الثقافي الجديد الذي نطلق عليه اسم "الكاتب الرقمي"؟ أمن منظور أن له وجودا "واقعيا"، أي ثمة محددات مشتركة موجودة بين فئة من ممارسي الكتابة الرقمية، فما يبقى علينا سوى جرد هذه السمات الثابتة، وبالتالي متى توفرت في هذا الفرد أو ذاك انطبقت عليه صفة "كاتب رقمي" دون أن يحتاج إلى أن يمنحه إياها شخص أو هيئة؟ أم نعرفه من منظور مراعاة الغياب التام لحواجز المصفاة في الشبكة، ومن ثمة احتمال، بل واقع، أن يكون العالم الافتراضي غارقا حرفيا في طوفان من النصوص والكتابات التي لا تستحق بالضرورة هذه التسمية، مما يستدعي ضرورة تحديد معايير لإطلاق صفة كاتب على هذا المرء أو ذاك وتجريد آخر منها، بمعنى أنه لا يكفي المرء أن ينال صفة "كاتب" حتى ولو أول ما كان ظهوره كان في النت، ثم لازمه ليلا ونهارا؟ عندما يجري الحديث عن "الكاتب الرقمي"، ربما يكون بديهيا أن المقصود بهذه التسمية هو هذا الكاتب الذي يقف على طرف نقيض من مقابله "الكاتب الورقي". هذا التقابل الذي يحضر أوتوماتيكيا في الذهن يُبدي الأمر وكأنه في منتهى الوضوح: ـ فمن جهة، هناك كاتب يلازم قلعة الورق كتابة وقراءة ولا يتردد إطلاقا على العالم الافتراضي بكتاباته ومشاهده الثقافية، بمعنى أنه غائب غيابا تاما عنه. ـ من جهة ثانية، هناك كاتب قد لا يتعامل إطلاقا مع عالم النشر الورقي، أو على الأقل دائم الاتصال بالشبكة والحضور فيها أساسا لنشر أعماله، والتواصل مع قرائه وأنداده من الكتاب .. الخ. مع أن هذا التمييز يبدو واضحا على صعيد التصور، فإنه غير صائب في الواقع كليا مادام من الكتاب الورقيين من تصل أعمالهم إلى الشبكة، ولو أنهم لا يتعاملون إطلاقا مع الحاسوب ولا الإنترنت، وتفد أعمالهم إلى الويب عبر المواقع الإلكترونية ذات الإصدار المزدوج: الورقي والرقمي، كمجلات نزوى والكرمل وفكر ونقد وموقع اتحاد الكتاب العرب .. الخ. أو صحف مثل الزمان والقدس العربي والأهرام .. الخ. أكثر من ذلك، من الكتاب والنقاد الأدبيين من يتوفر على موقع إلكتروني شخصي، بل ويكتب في قضايا الأدب الرقمي، ومع ذلك لا يكفي هذا لنعته بالكاتب أو الناقد الرقمي، لأن هذه المواقع تكون بمثابة ما يدخل في باب "مجاراة الوقت" والعمل بما يعمل به الآخرون لا غير، وسعي لإثبات حضور في الشبكة، من أجل التعريف بالنفس وبالإنتاج، دون الحياة داخل العالم الافتراضي. إنها "مواقع واجهات" sites vitrines كما يسميها البعض (5). من ذلك، مثلا، أن بعضهم يتحدث في موقعه عن شخصه بضمير الغائب، تماما كما يتحدث كتاب في تاريخ الأدب عن "عَلم ميت أو حي، لكن يصعبُ جدا الاتصال به"، ومن ذلك أيضا أن بعضهم يوكل بناء موقعه إلى الغير وهو لا يعلم ما في هذا الموقع، وإذا سألته في أمور التحيين أو التواصل عبر صفحته الشخصية أجابك "لا أعرف. فلان هو الذي أنشأ الموقع". والحال أن الفرق شاسع جدا بين الحضور من أجل الحضور وإطلاق موقع نادرا ما يُحيَّن، أو لا يُحيَّن بالمرة، وبين أن يصير التردد على الشبكة ممارسة يومية، لأجل المطالعة والتواصل والنقاش، وربط شبكة واسعة من العلاقات بين الأنداد من الكتاب والباحثين. إضافة إلى ما سبق، يوجد اليوم من الكتاب في العالم العربي من شكل النت فضاء لولادته الأدبية باعتباره "مبدعا"، ثم نال فيه شهرة واسعة، حتى إذا كبُر واشتد ساعده التحق بالنشر الورقي للمرة الأولى، وما كان ليحصل فيه على موطئ قدم لولا الرصيد الذي تجمَّع له في الشبكة، عبر المنتديات والمجلات الإلكترونية، وحتى الموقع الشخصي. أخيرا، إذا كان مما يدخل في باب المسلمات اليوم أننا نعيش في ظل ثورة جارفة ستجتث كل الميراث المنحدر إلينا من العصور القديمة، وضمنها الكتاب (المتوقع اختفاؤه في غضون الثلاثين سنة المقبلة)، فمعنى ذلك أن جميع الكتاب سيصيرون رقميين. ما فائدة هذه التسمية حال اكتمال دورة التغيير؟ هل نسعى لتحديد فاعل ثقافي "جديد" يتسم وجوده بالإطلاق أم أننا إنما نميزه في فترة التحول هذه، من ثقافة الورق إلى ثقافة الرقم، حتى إذا اكتملت دورة التغيير صارت التسمية لاغية؟ لماذا هذا التمييز؟ لا يبرر صفة "الكاتب الرقمي" أو "كاتب الإنترنت" اليوم سوى هذا التعارض القائم بين قطاعين أو سلطتين: واحدة تفرض نفسها باعتبارها "مركزية" وأخرى "هامشية" أو "مهمشة" بالأحرى. ـ قطاع الثقافة الورقية المكرسة منذ أمد طويل على شكل مؤسسة، تستفيد هيئاتها غالبا من دعم مادي من المال العمومي مشروع على كل حال للدور الحيوي الذي تؤديه، أو تسعى لأدائه بالأحرى، في الحقلين الثقافي والاجتماعي، مع أن أنشطته الواقعية (محاضرات، ندوات، مهرجانات) تبقى محصورة في الزمان والمكان، ضيقة حيز الإشعاع، مرتفعة تكلفة الإنجاز، ومنشوراته محدودة عدد السحوب والطبعات، ضيقة جغرافيا التوزيع. ـ قطاع النشر الإلكتروني متمثلا في جيش من الكتاب والمبدعين والأدباء والمثقفين ينجز، بشكل تطوعي، أضعاف ما تقوم به المؤسسات التقليدية للأدب والثقافة وهيئاتهما الراعية، حيث تنظم العديد من الندوات والملتقيات الافتراضية، وينشر كما هائلا من المواد الإبداعية والنقدية والفكرية القابلة للنشر في مجموع أنحاء المعمورة، دون أن يحظى بأي دعم يُذكر على غرار ما يحظى به القطاع التقليدي ودون أن يقوم أي تنسيق بين أعضائه وبعض هيئاته الموجودة (كاتحاد كتاب الإنترنت العرب، والجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب، مثلا، وكبريات المنتديات مثل "نادي الفكر العربي" و"مدينة على هُدب طفل" ومنتدى "القصة العربية" وغيرها). في هذا السياق، تبدو مبادرة مجموعة من الأدباء والمثقفين لتأسيس هيئة تجمع كتاب العالم الافتراضي العرب تحت اسم "اتحاد كتاب الإنترنت العرب" مبادرة هامة ووجيهة. لن أذكِّرَ بغايات هذه المؤسسة ولا بمعايير انتقائها للأعضاء لا سيما أن الوثائق المتعلقة بهذا الجانب كلها متوفر في موقع الاتحاد. في المقابل، أود اقتراح تعريف لـ "للكاتب الرقمي". 1. 3. نحو تعريف للكاتب الرقمي نظريا تسع تسمية الرقمي كل كاتب يستخدم، بدل الورق، تقنية الرقم في تدوين كتاباته وإخراجها للقراءة، وبذلك تنطبق هذه الصفة من ينشر منتوجه على الأقراص المرنة أو المدمجة كما على من يخرج كتاباته للقراء عن طريق الشبكة العنكبوتية. من هنا يكون مجموع كتاب الإنترنت "رقميين". ولكن ما أن نتتبع سلوك هؤلاء في الشبكة حتى يصير بالإمكان التمييز داخلهم بين ثلاثة أصناف: أولا: صنف ينشر في الإنترنت، موجود فيه بصفة منتظمة، لكن دون أن يعي الرهانات العميقة للعالم الافتراضي أو التماهي معها، ويمثل هؤلاء الكتاب والمبدعون الذين لم يستوعبوا بعد فكرة أن الكتاب الورقي مجرد محطة في تاريخ الكتابة الطويل، آيلة إلى الزوال، وبذلك ترى ترددهم على الشبكة يتراوح بين قراءة البريد الإلكتروني وتحيين الموقع، وفي أحسن الأحوال إرسال أخبار الأنشطة والملتقيات الثقافية ومنشورات العالم الورقي إلى منابر النشر الإلكتروني. إن نشروا كتابا كانت وجهة النشر الورقي أسبق على الرقمي، بل ربما باعوا حقوق التأليف أو الترجمة كاملة للناشر وحرموا قراء النت إلى الأبد من الاطلاع على هذا الإنتاج. في أقصى الحالات، نجد ضمن هؤلاء من يعيش النشر في عالم النت بإحساس بالذنب يُعبر عنه على النحو التالي "لو أنصفتني منابر النشر الورقية لما وطئت قدماي النت."؛ هذا الصنف لا يزال قادرا على الاختلاء بكتاب ورقي لبضعة أيام، قصد قراءته كاملا في الوقت الذي جعلت معه الرقمية هذا النوع من القراءات شبه مستحيل. يميز مارك هايير Marc Hayer في القراءة بين ثلاثة أنواع: ـ الرعي: وخلاله يلتهم القارئ، مثل الماشية في المراعي، الكتاب سطرا بسطر، صفحة بصفحة، من البداية حتى النهاية، إلى أي يأتي على آخر حرف منه؛ ـ التنقيب: وفيه يقوم القارئ مثل الحفري، بالبحث هنا، وهناك، في صفحات الكتاب وفهرسته، عما يهمه بالضبط، حتى إذا عثر عليه انكب عليه دون الاكثرات بالمحتوى الكامل للكتاب، وهذا ما يصطلح عليه بـ "القراءة" العامودية؛ ـ الصيد أو القنص: وفيه يقوم القارئ، مثل القناص، بانتقاء ما يهمه داخل حشد المعلومات، ثم ينقض عليه دون الانشغال بالباقي (7). وهذا هو ما تفرضه البيئة الرقمية في ظل زخم المعلومات المتوفرة في كافة الحقول الإبداعية. والنت بما يقدمه من زخم من الموارد النصية والوثائقية وبطبيعته التشعبية التي تجعل بالإمكان النفاد من أي نص، بصدد القراءة، إلى نصوص أخرى، إنما يجعل النوعين الثاني والثالث هما الأنسب ومتزايدا الانتشار (8). ثانيا: صنف يحيا داخل النت، يتردد عليه يوميا، يشكل البريد الإلكتروني والدردشة الآنية وبرامج مثل الـ skype والبالتولك وغيرهما، أداة شبه وحيدة للتواصل مع العالم الخارجي، إذا ما حرر نصا كانت وجهة نشره الأولى هي الشبكة. أفراد هذه الفئة يشاركون في مجموعات إخبارية ومنتديات إبداعية وثقافية، يستنزف منهم الإبحار في الإنترنت وقتا كبيرا يوميا، يترددون على عدد كبير من المنابر الرقمية بسائر أصنافها: صحف، مجلات، منتديات، .. الخ. لمعظمهم فضاءات شخصية للنشر والتواصل، تكون عبارة عن مواقع شخصية أو مدونات. لكن مع ذلك لا تنطبق عليهم صفة "كتاب رقميين" بمعناها الدقيق. أخيرا: فئة أضافت للصفات والسلوكات السابقة التكوين في مجموعة من البرامج لتسخيرها في الكتابة الإبداعية ذاتها، ومن ثمة تسهم في إنتاج ما يُسمى بـ "الأدب الرقمي" أو "الأدب المعلوماتي". هذه الفئة، في العالم العربي تكاد تكون منعدمة في الوقت الراهن؛ فباستثناء الروائي محمد سناجلة الذي شق له طريقا في هذا الحقل، وبضعة أسماء أخرى لم تحقق تراكما يمكن الاطمئنان إليه، مثل الروائي أحمد خالد توفيق صاحب قصة "ربع مخيفة" (9) التفاعلية والشاعر المغربي منعم الأزرق، والجماعة التي أبدعت قصيدة ميدوزا (10) والقاص المغربي محمد اشويكة بقصته التشعبية "احتمالات" (11)، باستثناء هذه الأسماء لا يزال هذا الحقل في الكتابة بكرا في عالمنا العربي. وأظن الواجهة الأخيرة أحد القطاعات الهامة التي يجب على اتحاد كتاب الإنترنت العرب أن يركز عليها. لأجل ذلك، سيكون مفيدا دون شك إعادة النظر في المعايير التقليدية لمنح لقب "كاتب" بحيث تصير تشمل ليس الأدباء وحدهم، بل وكذلك المعلوماتيين المهرة في البرامج التفاعلية، وهم كثرٌ في المنتديات المتخصصة في المعلوميات، لتحقيق هدف التكامل بين المعلوميات والأدب باعتبار هذا التداخل هو جوهر ما يميز "الأدب الرقمي" عن غيره. ولتحقيق هذا الهدف، يمكن اتخاذ منتديات الاتحاد فضاء لعمل يُجزأ إلى ثلاث مراحل: ـ في خطوة أولى: يلقن المعلوماتيون الأدباءَ المعلوميات ويدخل الأدباءُ المعلوماتيين في فضاء الأدب؛ ـ وفي مرحلة ثانية يُنتج الأدباء والمعلوماتيون معا نصوصا مشتركة، كل يضع فيها بصماته؛ ـ وفي مرحلة أخيرة، ستتأخر دون شك، نحصل على "معلوماتيين أدباء" و"أدباء معلوماتيين"، أي على فئتين قادرتين معا على كتابة نصوص أدبية تفاعلية؛ "يُظهر موَلودو السيناريوهات الأمريكيون أو الأدب التوليدي الممثل في فرنسا من لدن جان بيير بالب حيوية هذا المسعى الذي تكون فيه الكتابة أولا (ولكن ليس هذا فحسب) هي كتابة برنامج معلوماتي." (12) في تقديري، هذه هي المهمة الجوهرية التي يفترض في الاتحاد أن يضطلع بها، والخيط الرفيع الذي يمكن أن يميزه عن الاتحادات الورقية، بل ومعنى منحه العضوية لهذا الكاتب دون ذاك من حشود الكتاب والكتبة الذين يدخلون الآن، وعلى قدم المساواة، عبر الشبكة، إلى حقل التداول من غير أي رقيب ولا أدنى تأشيرة مرور، لا سيما أن ضعف التكوين في مجال المعلوميات هو السمة الغالبة على المعلوماتيين العرب؛ معظمهم لا يجشم نفسه عناء امتلاك الأدوات الضرورية لإبداع نصوص رقمية (كالفلاش والسويتش والجافا سكريبت وغيرها). هذه العوائق، في رأيي يمكن التغلب عليها تدريجيا عبر مراحل: ـ التحسيس بأهمية الكتابة الرقمية التفاعلية؛ ـ إنجاز كتابات نقدية نظرية وغيرها في هذا الحقل وترجمة هذا النوع من المقاربات الموجود في لغات أخرى؛ ـ دفع الراغبين في ولوج هذا المضمار إلى مراجعة مفهوم "المبدع" نفسه، بحيث يصير يتجاوز مجرد شخص يعرف القراءة الكتابة وينشئ عوالم استيهامية وتخييلية، إلى فرد يجيد بهذا القدر أو ذاك استخدام مجموعة من البرامج المعلوماتية، هذا الاستخدام الذي صار مع الكتابة الرقمية شرطا ومكونا لا محيد عنهما في العملية الإبداعية. في هذا الصدد، قد يكون من الهام توسيع دائرة الانتماء إلى الاتحاد بحيث تشمل اختصاصيين في حقل المعلوميات نفسه، بغية إنتاج نصوص رقمية يتضافر في إبداعها أدباء ومعلوماتيون، بل ويتجاوز ذلك، إلى كتابية دراسات نقدية في هذا اللون الإبداعي الجديد، على غرار ما نجد لدى الكثيرين من كتابه في الغرب، ولدى واحد من أبرز ممثليه في العالم العربي حاليا وهو الروائي الأردني محمد سناجلة في كتابه "رواية الواقعية الرقمية. تنظير نقدي". 2. نظرية "رواية الواقعية الرقمية" 2. 1. لبسٌ في التسمية لابد من رفعه تثير تسمية "رواية الواقعية الرقمية" لبسا لابد من رفعه: فلأول وهلة يبدو الأمر وكأنه يتعلق بصنف جديد من أصناف الرواية الواقعية، ينضاف إلى تقسيماتها الداخلية. بمقتضى هذا الفهم، سنكون أمام رواية تحترم القواعد العامة التي تميز "الرواية الواقعية" عن غيرها من الروايات، كـ "الرومانسية" و"التاريخية" و"الفكرية"، .. الخ، ولكنها تتميز عن الجنس الأب بكونها "رقمية"، بمعنى أنها تُكتب في الحاسوب، وربما تتداول في شبكة الإنترنت أو الأقراص المدمجة، وتضيف بالتأكيد لوينات من حيث المضامين التي تعالجها. لبسٌ حصل بالفعل، واتخذه أحد منتقدي هيئة «اتحاد كتاب الإنترنت العرب" قائلا: لم نسمع برابطة كتاب أو اتحاد كتاب أن فرض على أعضائه الكتابة في مذهب أدبي بعينه قائلا "ليس لك الحق في الانضمام إلينا لأنك تكتب كتابة سوريالية بينما رئيسنا يكتب كتابة رومانسية أو لا يحق لك أن تعارض الدادائية بعد انتمائك إلينا. يجب عليك أن تدافع عنها وتنشرها بين الناس لأن رئيسنا على هذا المذهب، اكتب في العدمية وفي أي مذهب شئت، ولكن دافع عن الدادائية وادعُ لها" (13) لرفع هذا الغموض نبادر بالقول "إن ما يقصده اصطلاح "الواقعية الرقمية" هو شيء مختلف كليا: المراد به هو تأكيد أن الرقمية والعوالم الافتراضية هي بصدد الحلول حرفيا محل الواقع بكافة قطاعاته وأنشطته، بما يقتضي التعامل معها (أي الرقمية) باعتبارها واقعا، أي أمرا ملموسا وموجودا، يمكن أن يجلب الفرح للمرء، يُسعده ويُكافئه، مثلما يمكن أن يجلب له الشقاء والبؤس. وإذا كانت هذه المسألة ترتد في نهاية المطاف إلى غياب مُعجم للنقد الأدبي الإلكتروني، الأمر الذي يُفضي إلى بلبلة وغموض في المصطلحات المستعملة لدى الغربيين أنفسهم، بما فيهم الذين دخلوا هذا القطاع منذ زمن طويل، فإن مؤلف كتاب "رواية الواقعية الرقمية. تنظير نقدي" (14)، قد نجح في تبديدها من خلال تخصيص أجزاء هامة من الفصلين الأول والثاني للتحولات الكبرى الجارية في ظل الثورة الرقمية، وهو موضوع قد يبدو للكثيرين إما خارج نطاق النقد الأدبي أو مجرد استعراض لعضلات معرفية في حقل المعلوميات، والتركيز هنا قائم على "العصر الرقمي والرواية"، "الشخصية والموضوع في رواية الواقعية الرقمية"، "العصر الرقمي والإنسان الافتراضي"، ثم "من هو الإنسان الافتراضي". 2. 2. ثورة الرقمية وفجر حضارة جديدة مدار هذه التأملات والمعلومات عرضُ التغييرات العميقة التي تطال مجموع الميراث الذي انحدر إلينا منذ آلاف السنين، بل وتمتد إلى الإنسان نفسه، بما يجعلنا لا نعيش فجر حضارة جديدة بكل معنى الكلمة (تحيل سابقتها إلى المتحف) فحسب، بل وندخل حلقة تغيير بيولوجي قد يمحو الفوارق التي ظلت قائمة إلى اليوم بيننا وبين الآلة، بحيث يصير فينا شيء منها ويصير فيها شيء منا. ما يعرضه المؤلف وجيه، ولمن شاء التوسع فيه بهذا القدر أو ذاك، بل وحتى وضع هذا الطوفان الجارف في سياقه التاريخي بحيث يستنتج أنه يدخل ضمن الحتميات التي تمتد جذورها إلى آلاف السنين، والتي ظلت تتطور عبر القرون وتتنقل عبر الحضارات، مغتنية بالإضافات إلى أن بلغت طور الاكتمال والدخول الآن مرحلة تأسيس قطيعة مع الماضي، لمن شاء ذلك أن يطلع على كتابين هامين "على طرق الشأن الافتراضي" (15) Sur les chemins du virtuel للفيلسوف بيير ليفي، و"نهاية العمل المأجور" (16) La fin du travail لعالم الاقتصاد جيريمي ريفكن. الأول: يبرهن على الاجتياح الذي يمارسه العالم الافتراضي على كافة الأصعدة: النص، الجسد البشري، الاقتصاد، معتبرا أن عناصر اللغة والاقتصاد والميثاق، باعتبارها افتراضيات، هي ما جعلت من الإنسان إنسانا. والثاني: يُبرهن على نهاية حضارة عمل الإنسان لفائدة عمل الآلات التي منها الآن ما بلغ من الذكاء ما يجعلها تتفوق على الإنسان متوسط الذكاء في أداء عمله. هذا هو الجو الذي يضعنا فيه صاحب «رواية الواقعية الرقمية» ليطرح مجموعة من الأسئلة على الحقل الأدبي مقترحا بمثابة إجابة عنها هذا الجنس الروائي الجديد. والأسئلة هي: "هل تستطيع الرّواية بشكلها الحالي أنْ تستوعب الثورة الرقمية المتسارعة في العالم، أم أنها يجب أنْ تتخلى عن مكانتها لصالح أشكال تعبيرية وإبداعية أخرى أكثر قدرة وجاذبية كالسينما أو البرمجة مثلاً؟ (...) هل الروائي بشكله وأدواته الحالية قادر على المضي في مغامرة الرّواية في ظل العصر الرقمي الآخذ بالتشكل؟ (...) هل الروائي بأدواته الحالية المستهلكة قادر على أنْ يبقى روائياً؟ (...) ما موضوع الرواية القادمة؟؟ ما لغتها، بل ما هي اللغة أصلاً؟؟ وهل الكتاب ـ بشكله الورقي المعهود ـ قادر على استيعاب الرواية القادمة؟ أم أننا بحاجة إلى لغة أخرى وكتاب آخر؟." (17) الجواب طبعا بالنفي، والبديل الذي يقدمه الكاتب هو "رواية الواقعية الرقمية". 2. 3. رواية الواقعية الرقمية: إنها رواية معرفية بالدرجة الأولى، كما أنها "مغامرة في الزمن الرقمي الافتراضي وفي المكان الرقمي الافتراضي وفي الواقع الرقمي الافتراضي." (18) من مهامها المعرفية، مثلا، الإجابة عن سؤال تحولنا الجاري من إنسان عاقل إلى إنسان افتراضي: "نحن نتطور.. نتحول .. نصبح شيئا آخر.. لكن ما هو هذا الشيء أو الكائن الجديد الذي أطلقنا عليه اسم الإنسان الافتراضي، وبماذا يختلف ويلتقي مع الإنسان العاقل؟ هذه الأسئلة هي ما (...) ستتناوله رواية الواقعية الرقمية بمفهومها الشمولي القادم والذي سيتبلور سريعا جدا في السنوات القليلة المقبلة." (19) وكمثال عن ذلك يسوق المؤلف "مغامرة" واقعية في العالم الافتراضي انتهت إلى التجسد في عمل إبداعي هو رواية "شات". لا أحد من النقاد الذين كتبوا عن هذا العمل التفت إلى هذه النقطة وعالجها في كتابته عن العمل المذكور. وحول اللغة في الرواية الجديدة، يرى سناجلة أيضا أن لغة الرواية التقليدية عاجزة عن الاستجابة لحاجيات نظيرتها الجديدة التي يجب أن تتحدد بسمات خمس: أولا: تجاوز اللغة المكتوبة إلى مكونات أخرى: صورة، صوت، مشهد سينمائي وحركة؛ ثانيا: على اللغة أن تمشهد أحداث الرواية في بُعديها المادي والذهني؛ ثالثا ـ رابعا: على اللغة أن تكون سريعة بحيث لا تتجاوز المفردة فيها أربعة إلى خمسة حروف وعدد صفحات الرواية المائة صفحة، والجملة من ثلاث إلى أربع كلمات على الأكثر؛ خامسا: على الروائي تجاوز مجرد معرفة الكتابة إلى الإلمام بهذا القدر أو ذاك بمجموعة من البرامج الكفيلة بتحقيق النقطة الأولى، ناهيك عن استخدام الحاسوب التي تعد من نافلة القول. (20) 2. 4. تلقي رواية الواقعية الرقمية في العالم العربي رغم الجدة الكاملة للآراء السابقة في الحقل النقدي العربي، فإنها لم تلق ما تستحقه من اهتمام في هذا السياق، بدون شك لسببين: الأول: الأغلبية الساحقة من النقاد والمثقفين والمبدعين العرب لازالت متقوقعة في دائرة الإنتاج والتلقي الورقيين، ومن ثمة يُفترض أن إصدار الكتاب في طبعة ورقية نفسها (21) لم يأت بشيء يُذكر؛ موضوع الكتاب سيبدو غريبا جدا. هل يستطيع إنسان أن يعلق على طريقة تعاملك مع الحاسوب أو انتقادها وهو لا يتعامل مع هذا الجهاز أصلا ؟ ثانيا: أغلبية معمري الشبكة حاليا من المثقفين والأدباء والمبدعين العرب يتعاملون مع الويب تعاملا نفعيا: لنشر النصوص أو التواصل، وفي أحسن الأحوال، المشاركة في نقاشات المنتديات، ومن ثمة غياب التكوين في حقل المعلوميات، وعدم إدراك الرهانات العميقة التي تنطوي عليها الثورة الرقمية، والتي لن يسلم منها أي قطاع من قطاعات الواقع والفكر؛ "إذا كان من السابق لأوانه تكوين فكرة عن مآل الدراسات الأدبية زمن الشبكات والوسائط الجديدة، في غضون السنوات العشر أو الخمس عشرة المقبلة، فإن المحقق هو أن تلك الدراسات ستكون في قسمها الواسع حصيلة التطورات المذهلة لنشاط يمضي بسرعة مذهلة اليوم." (22) والمقالات التي التفتت إلى الكتاب يمكن تصنيفها في قسمين: احتفاء يصل أحيانا حد المبالغة؛ انتقاد ورفض بلغ حد القسوة غير المبرَّرة. 2. 4. 1. التلقي الاحتفائي يبلغ أحيانا حد الانبهار، وتأكيد ريادة المؤلف في التبشير بأدب عربي جديد ليتم الانعطاف إلى أعمال المؤلف، خصوصا روايته "ظلال الواحد". في المقابل لا نجد مساءلة حقيقية لمحتوى الكتاب تنكب ـ ضمن ما تنكب ـ على مسألة مستقبل الظاهرة الأدبية: هل الآفاق التي تفتحها المعلوميات أمام الكتابة الأدبية ستُبقي الأدب أدبا أم ستدخله في تحول جذري سيجعل تسمية الأدب أقل من أن تحيط به؟ هل رواية الواقعية الرقمية هي الاستجابة الوحيدة الممكنة للتغييرات الجارية مع الثورة الرقمية، وخصوصية الظاهرة الروائية في الواقع العربي الذي مازالت مجموعة من الدراسات والكتابات في هذا الجنس تسعى إلى مجرَّد تأصيله. والسبب في ذلك قد يعود إلى قلة الاطلاع على الدراسات والبحوث النقدية العديدة في المجال، بل وغيابه التام، في العديد من المقالات التي تناولت الكتاب، ولذلك ركزت في عمومها على الإطراء المبالغ فيه الذي مضى أحيانا إلى حد اعتبار منجز محمد سناجلة النقدي والإبداعي الرقمي هو الأول من نوعه على الصعيد العالمي. ومسألة الأولية هذه كانت موضوع نقاش في بعديها الكوني والمحلي؛ على الصعيد الأول نشأ جدل حول من هو أول كاتب أول رواية رقمية، بين محمد سناجلة ود. سعيد الوكيل ود. عبير سلامة. وترددت في هذا النقاش ثلاثة أسماء أمريكية، هي: مايكل جويس بروايته "ظهيرة" afternoon story المنشورة عام 1986، و روبرت أرلانو المعروف باسم بوبي رابيد بروايته "شروق شمس 69"، ثم ستيفن كينج وروايته Ridding The Polit المنشورة سنة 2001م. (23) على الصعيد الثاني نشأ الخلاف نفسه بين ماجدولين الرفاعي ومحمد سناجلة حول من السباق إلى إبداع أول قصيدة رقمية اعتبارا إلى أن رواية محمد سناجلة "شات" ونصه "صقيع" تتضمنان ثلاثة أعمال من هذا الجنس (24). وتم التشديد في غير مكان في النت على أن نص "احتمالات" لمحمد اشويكة الصادر سنة 2006 هو أول "قصة ترابطية في المغرب العربي". قضية الأولية، برأيي، قد لا تفيد سوى مؤرخي الأدب إن كانت الضرورة ستظل قائمة لتأريخ الأدب بالنظر للتطور المذهل الذي يعرفه حقل التكنولوجيا المعلوماتية، والانتشار المتزايد للحواسيب الشخصية، والتطور المتواصل للبرامج، وبالتالي التجديد المدوِّخ الذي سيعرفه حقل الإبداع على يد من سيلحق بركب المبدعين من أطفال اليوم الذين يفتحون أعينهم على الحواسيب وتدخل هذه الآلات العاقلة في صلب تنشئتهم الاجتماعية. يمكن افتراض ما سيحصل على المدى البعيد: الانقراض النهائي للأدب على نحو ما نفهمه اليوم لفائدة ضرب من اللعب التفاعلي بين الإنسان والآلة تمحى فيه الحدود بين القراءة والكتابة، بل حيث سيختفي هذان النشاطان/المصطلحان لفائدة مفاهيم أخرى اشتقها بعض نقاد الأدب الإلكتروني سلفا، مثل "القرا-كتابة" l’écrilecture والكاتب ـ القارئ l’aucteur، لفائدة تجربة أعلى يعيش فيها المستخدم هاتين التجربتين معا اللتين نفصل بينهما الآن. 2. 4. 2. التلقي الرافض والمنتقد يمكن تصنيف هذا الموقف في قسمين: قسم لا يعترف بالمجهود التنظيري ولا المنجز النصي للـ "الرواية الواقعية"، وذلك ليس من منظور رفض الآفاق الإبداعية التي يفتحها الحاسوب أمام السرد الأدبي، ولكن لعدم اعترافه بذلك التنظير والإنجاز اعتبارا إلى أنه "غير كفء" في المجال و"دون المستوى". أفضل من يعبر عن هذا الموقف الناقد المصري د. سعيد الوكيل في مقالته "خرافة الواقعية الرقمية" (25) التي يؤاخذ فيها محمد سناجلة على عدم الإكثار من الروابط التشعبية في عمله "ظلال"، الأمر الذي يجعل عمله هذا رواية خطية. المأخذ الرئيسي الذي يمكن إبداؤه على هذا النوع من المقاربات هو افتراضه الضمني وجودَ خُطاطات إبداعية ثابتة وواضحة بحيث تتيح تصنيف هذا النص أو ذاك، وبشكل يقيني، ضمن النصوص التشعبية التخييلية أو إقصاءه منها. العنصران البارزان في هذه الخطاطة هما: الخطية والروابط التشعبية. إضافة إلى ذلك، يبدو أن هذا الموقف يقوم على مصادرة غير مبررة؛ فالآفاق التي يفتحها الحاسوب أمام الإبداع الأدبي أكثر من أن تحصر أو أن تُحدد لها قواعد ثابتة؛ بل ربما كانت القاعدة الوحيدة التي يمكن أن يتفق حولها الجميع، وحضور الخطية أو غيابها (حضورها يُقصي النص من دائرة هذا النوع من الإبداع وغيابها يُدخلها ضمنه) غير كافية ما دام التشعب يعتبر أحد مكونات الشبكة ذاتها، ناهيك عن ظهور بعض الروايات بصيغتين: تشعبية وخطية، كأكبر رواية فرنسية منشورة على النت (26). أما الموقف الثاني، فيرفض هذا الجنس جملة وتفصيلا، ونجد أحسن تعبير عنه في مقال لحسن سليمان تحت عنوان "محمد سناجلة والكتابة الرقمية وتغييب مفهوم الأدب" (27). ويقوم على ثلاثة أفكار رئيسية: الأولى ما يمكن تسميته بـ "نقاء الأنواع"، والثانية كون الحاسوب لا يعدو مجرد وسيط، والثالثة: سحب الاعتراف بالآراء النقدية لرواية "الواقعية الرقمية" من منظور أنها بدعة في الآداب العالمية المعاصرة. النقطة الأولى: ترتكز على تعريف الأدب نفسه الذي يميزه عن باقي الحقول باعتباره "فنا تعبيريا أداته الكلمة"، وبموجبه لا مجال لاستعمال صوت ولا حركة ولا صورة ولا مشاهد ركحية ولا سينمائية. وهذا تعريف مغرق في التقليدية ويجانب التغييرات الراهنة: "الأدب"؟ هو ما "يُقرأ" أو على الأقل هو ما اعتدنا على "قراءته" إلى اليوم بشكل مطبوع في كتب. لكن الأدب هو أيضا ما بدأ "يُعرض" منذ بداية ثمانيات القرن الماضي في شاشات الحواسيب لأن "الأدب" هو أيضا شيئا بدأ "يُبدع" و"يُبصر" من الآن فصاعدا في أجهزة عرض للتجهيزات التكنولوجية الجديدة." (28) أما بخصوص النقطة الثانية التي يرى فيها حسن سليمان أن الحاسوب لا يعدو مجرد وسيط، فكل الوقائع تخالفها، إذ هذا الجهاز: "ليس آلة جامدة. على العكس هو أداة للإبداع فعالة، خصوصا منذ تجهيز الحواسيب الصغيرة بشاشات في مستهل ثمانينيات القرن الماضي. إنه ينفد معالجات، يعدل النصوص، يحوِّل الأعمال، يمدِّد النشاط الإبداعي، ولا يعيقه. وبذلك فهو يُدخل "تجديدا"، بُعدا جديدا في فعل الإبداع لم يكن معهودا من قبل في الأدب." (29) أكثر من ذلك صار هذا الحاسوب يتدخل في صلب العملية الإبداعية والنقدية ذاتها: فعبر ما يُسمى بـ "مولدات النصوص" تتيح برامج خاصة إنشاء عدد لا نهائي من النصوص السردية والقصائد الشعرية انطلاقا من قصيدة أولية عبر إعادة تركيب وحداتها اللغوية، على غرار ما نجد في مولدات جان ببير بالب الذي يصف العملية لمستمعي إحدى محاضراته على النحو التالي: "على امتداد مداخلتي، وللتدليل على رأيي، سيقوم جهاز حاسوب بتوليد أدب في هذه الشاشة. لا تسألوني عم سيكتب، فأنا لا أملك سوى فكرة واسعة عنه. كل ما يمكنني تأكيده هو أنه يستطيع الكتابة على هذا النحو أو على نحو آخر، إلى ما لا نهاية، ثم إن يستأنف الكتابة بعد ساعة فسيكتب شيئا مختلفا." (30) وقصيدة رايمون كينو "مائة ألف مليار قصيدة" التي يتولى فيها برنامج معلوماتي بتوليد مائة ألف مليار قصيدة انطلاقا من إعادة تركيب الوحدات اللغوية لنص أولي محدود، بل أكثر من ذلك ثمة اليوم العديد من المواقع التي تمد القارئ باستمارة ما أن يكمل تعبئتها حتى يجد نفسه أمام قصيدة شعرية تتضمن كافة البيانات التي عبأها وقد صارت جزءا من القصيدة. وهذا ما جعل بعض النقاد يتحدث عن "الروبو الشاعر" في مقالة تحت عنوان "الروبو الشاعر: الأدب والنقد في الزمن الإلكتروني." (31) وتعرض في قسمها الثاني تجربة فريدة في استكشاف آفاق الحاسوب، تتمثل في إنشاء برامج للقيام بعمل الناقد الأدبي نفسه، حيث يُمد البرنامج بالنص وبفرضية للعمل، فيقوم بعدد من العمليات التي تفضي إلى خلاصات ونتائج بلغت أحيانا حد التطابق مع العمل الإنساني نفسه بفارق الزمن طبعا الذي يتفوق فيه الحاسوب (32) وقد أصدرت دار النشر الفرنسية الشهيرة غاليمار قرصا مدمجا تحت عنوان "آلات للكتابة.. آلة للقراءة". (33) أخيرا، بخصوص إدراج الآراء النقدية والتجربة الإبداعية للواقعية الرقمية ضمن ما يمكن تسميته بالبدعة في حقل "الآداب العالمية المعاصرة"، ملفت للنظر اللهجة الساخرة التي يتحدث بها حسن سليمان، إذ يقول: "لقد خطر في بالي أن أترجم هذه المقالة وأرسلها إلي إحدى المجلات الانكليزية. إنه في الواقع مبعث للحزن والأسف أن يهيم بنا الشطط إلى هذا الحد. وأن يرعاه بالتالي مسؤولون علي مستوى من الرفعة ما يؤكد أننا ما زلنا قابعين في تصور وفهم خاطئ لاستخدام الآلة." (34) "إن قبلنا بهذه الأفكار كلها فسوف يتم إذن التفكير في فتح كليات ومعاهد تدرس الآداب وهندسة البرمجة والسينما وتضع الجميع في سلة واحدة، هي كلية الآداب الرقمية. الفكرة كلها علي ما يبدو جديدة ومفاجئة فلماذا لا يتم البحث عن طريقة للحصول علي براءة اختراع، تحمل الفكرة ويُذهب بها إلى الغرب لنزع براءة اختراع قبل أن يفطن إليها الغرب؟!." (35) لن أمضي إلى حد القول بأن هذه المقالة تعكس "الظلام الذي يهيمن على كتابات بعض النقاد العرب عن واقع الأدب العربي" ولا نعت صاحبها "بعدم قدرته على مجاراة العصر الذي يعيشه"، وما شابه ذلك من الأوصاف الواردة في إحدى الدراسات (36) لدى إثارتها مسألة غياب ذكر عمل محمد سناجلة في كتاب د. سعيد يقطين "من النص إلى النص المترابط" وفي دراستي "المشهد الثقافي العربي في الإنترنت". فالأمر هنا لا يتعلق بأكثر من غياب معلومة حالما يتم الحصول عليها أو التنبيه إلى وجودها يصير ممكنا تغيير فقرة من المقال أو حتى اتجاهه العام لا سيما عندما يتعلق الأمر بالنشر الإلكتروني الذي يتيح التعديل اللانهائي للأفكار والنصوص على عكس نظيره الورقي. وإلا فتبقى المسألة متعلقة بنوايا النقاد على نحو ما تكلم د. سعيد الوكيل عن نوايا المبدعين. فمثل هذه المراكز للبحث موجود سلفا، من أمثلته في فرنسا وحدها: ـ شعبة الوسائط التشعبية بجامعة باريس الثامنة: نشأت منذ عدة سنوات عن لقاء بين أدباء ومعلوماتيين أفضى إلى تأسيس مجموعة للبحث متعددة التخصصات، تحت عنوان "فقرة" Paragraphe. وهي شعبة ما فتئت تتطور وتكبر وتتنوع. تقدم الآن تعليما في السلكين الثاني والثالث مخصصا للإبداع والوسائط المتعددة ويتضمن عدة مختبرات للبحث." (37) ـ مركز CIERON (المركز متعدد التخصصات للبحث في جماليات الرقمية) أنشأته عام 1996 مُختبرات "فقرة"، يحظى بدعم من وزارة الثقافة (مهمة البحث والتكنولوجيا) وأحد المجالس المحلية بفرنسا، ويرسم مهمته في: "إنجاز بحوث في هذه الإشكالية (إشكالية الاستخدام العام والمتزايد للرقمية في سائر الحقول المعرفية والإبداعية)، بجمع مبدعين وباحثين منخرطين في مساعي وعوالم فنية منفصلة، لكنها توظف جميعا الرقمية، وذلك بغاية المشاركة في تحديد مفاهيم جديدة والمساهمة في صياغة إشكالية مشتركة على الصعيدين النظري والتجريب الفني." (38) ليست هذه المعلومة مما يدخل في باب الكنوز النفيسة؛ يكفي الدخول إلى محرك غوغل والبحث في "الأدب والمعلوميات"، ورؤية ما ستكون النتيجة. 0502 رأينا في رواية الواقعية الرقمية الحديث عن "نظرية" في العلوم المحضة والاجتماعية والإنسانية على السواء يفترض وجود تراكم من القوانين أو الممارسات الاجتماعية أو النصوص الإبداعية (في حالة النقد الأدبي) عليه (أي التراكم) ينكب التحليل للوقوف على الخيوط المشتركة بين الظواهر المدروسة وصياغتها على شكل نظرية؛ كتاب "نظرية الرواية" لجورج لوكاتش، مثلا، يرتكز على كم كبير من الأعمال الروائية، وكتاب "نظرية الأدب" لأوستين وارين ورينيه ويليك، يعتمد هو الآخر كما هائلا من النصوص الأدبية القديمة والحديثة وفي سائر الأجناس الأدبية. فكيف يجوز، في حالة "رواية الواقعية الرقمية" الكلام عن نظرية في الوقت الذي قد لا يتجاوز مجموع الأعمال المنجزة باللغة العربية، في هذا الجنس الجديد، بضعة أعمال؟، من جهة، وفي وقت لا يزال فيه الأدب الرقمي نفسه قيد التشكل في كافة اللغات بحيث لم يتحقق تراكم هائل بعد في أية لغة، ناهيك عن أن اللقاء بين الإبداع الأدبي والحاسوب يفتح الباب أمام إمكانيات هائلة من التجارب؟ من جهة ثانية. أ ـ لهذا يبدو من السابق لأوانه الحديث عن "نظرية". وإن كان لابد فبالمعنى الذي يُفهم به هذا المصطلح لدى الكلام عن "نظرية الشعر" عند جماعات أو مدارس أدبية مثل "الديوان" و"الرابطة القلمية"، .. الخ. بمعنى أننا نكون أمام إطار للعمل وبيانات وتصور مشاريع وخطوط عامة للإبداع أكثر منا إزاء قواعد مستخلصة من دراسة تراكم من النصوص. ب ـ من خلال التحولات الجارية الآن، على إثر ثورتي الكهرباء والرقمية، يخلص المؤلف إلى أن "العالم القديم" قد انتهى، وأن هناك عالما جديدا ومختلفا تماما (يتشكل).(39) ونهاية العالم القديم هي ما يبرر الحاجة إلى رواية جديدة تماما كما حصل مع سرفانتس "حين أطلق سرفانتس العنان لخياله ليحلم بعالم آخر غير عالمه الواقعي الذي لم يكن قادرا على تقبله والتعايش معه كتب الدون كيشوت، كان الدون كيشوت استجابة عملية لخيال غير عملي." (40) حسنا، هذا التصور يضعنا أمام ما يشبه قانونا أدبيا: كل تغيير في المجتمع والنظرة إلى الذات والعالم يُفضي إلى ميلاد شكل تعبيري جديد، ولكن هل يجب أن يكون هذا الشكل في عصرنا الراهن بالضرورة داخل الجنس الروائي الذي يعود ميلاده بالضبط إلى سرفانتس؟ أليس الأليق الحديث عن "جنس جديد" بدل مواصلة الحديث عن الرواية؟ ج ـ ثمة تردد في "التنظير النقدي" للرواية الواقعية، كما في الكتابات النقدية التي تناولت بعض منجزها، بين إدراج هذا المنجز في الخط العام للأدب بمفهومه التقليدي، ومن ثمة اعتباره مدرسة جديدة في الأدب أو جنسا أدبيا جديدا وبين القبول بنوع من القطيعة التي تفتح الباب أمام سؤال موت الأجناس التقليدية. من ذلك، مثلا، التقديم الذي كتبه الأستاذ أحمد فضل شبلول لنص "صقيع"، حيث ورد فيه: "يحتار القارئ أو المشاهد أو المتصفح في تصنيف هذا الجنس الأدبي الجديد؛ هناك سرد وهناك شعر وهناك سينما وموسيقى وأغنيات وحركة مستمرة تأخذ القارئ حتى نهاية العمل وسط جو عام من الدهشة والانبهار. ولا يبدو صاحب التجربة أقل حيرة منا حين سألناه عن ماهية العمل الجديد، وهل هو رواية أو قصة قصيرة أو شعر أو سينما؟ يقول سناجلة إن "صقيع" نص من الصعب جدا تصنيفه، إنه يمزج ما بين السرد والشعر والموسيقى والغناء والسينما الرقمية المنتجة بالكامل باستخدام التقنيات الرقمية، وبالذات برنامج فلاش ماكروميديا وفن الجرافيكس وبرامج المونتاج السينمائي المختلفة." (41) والواقع أن هذه الحيرة لا تخص النقد العربي وحده، بل هي عامة، تشمل النقاد الغربيين أنفسهم، وتمتد إلى تسمية هذا الأدب الجديد نفسه: "ثمة أدب جديد في طور النشأة. أساميه غير يقينية. هل يتعلق الأمر بأدب "إلكتروني"، "سيبرنطيقي"، "تكنولوجي"، "وسائطي"، "وسائطتشعبي"، "بانوسائطي" أم "ملعوماتي"؟ تتعدد الأسماء، وتُظهر الطابع الأصيل والمجدد لأشكال البحث المعاصرة. وتترجم كذلك بتعددها قلق الملاحظين أمام ظاهرة تبدو غريبة تماما عن المقولات الأدبية المعروفة." (42) أظن أن الأسئلة التي تطرحها الأعمال الجديدة تضعنا أمام أحد خيارين، وحده المستقبل سيحسم فيهما: الأول: اعتبار هذا اللون من الكتابة محطة في تاريخ الكتابة الطويل المؤطر بأجناس على نحو ما تريد نظرية الأدب، ومن ثمة إمكانية أخذ الإنتاج الأدبي ككل، بشقيه الورقي والرقمي مجالا للتأمل والتساؤل، فنتعامل مع الإنتاج الراهن بصفته منعطفا في تاريخ الكتابة الطويل. من هذه الوجهة للنظر يكون الانتقال الحالي للأدب من طور الكتابة إلى الرقم شبيها على نحو ما بالانتقال الذي عرفه الأدب نفسه من حقبة المشافهة إلى الكتابة. وبذلك يصير ممكنا تصنيف الكتابة الأدبية إلى ثلاثة أقسام: أدب شفهي، أدب كتابي، أدب رقمي. المنظور الثاني: التعامل مع الكتابة الرقمية باعتبارها شأنا مستقلا كليا عن الإبداع الأدبي الذي اعتدنا على كتابته وتلقيه في السند الورقي، بمعنى أنها تؤسس قطيعة مع فن القول المنحدر من الثقافتين الشفهية والكتابية. ومن ثمة ضرورة اجتهاد النقد في إيجاد مصطلحات لا ترتبط بالضرورة بالميراث النقدي الورقي، وهو ما يلاحظ لدى بعض كبار نقاد الإنتاج الأدبي الرقمي عندما يتحاشون الحديث عن رواية، فيتكلمون عن "النص التشعبي التخييلي" وعن "الشعر الرقمي" أو يجهرون بوجود قطيعة أو يتكلمون عن نهاية الأدب أو تبدله أو يتحدثون عن "الأدب المعلوماتي": "في هذه الأمكنة الطليعية، ثمة وعي جذري يتحقق: "لم يعد الأدب إطلاقا هو الأدب". تحققت قطيعة. ما كان يُعرف من قبل بالـ "أدب" ينحو الآن إلى شرعنة أشكال جديدة للإبداع تجريبية "إلكترونية"، يبقى من الضروري تحديد وضعها الاعتباري." (43) د ـ الآراء التنظيرية للرواية الرقمية تستحق كل التنويه، بالنظر لدعوتها للانخراط، على الواجهة الأدبية، في طوفان لن يذر أحدا. فالتغيير على هذا الصعيد بات من المسلمات، والمسألة مسألة وقت لا غير؛ تعليم القرن الواحد والعشرين سيعتمد بالضرورة التقنيات الجديدة للإعلام والتواصل، وتوظيف النص التشعبي في حقل التعليم ذاته بدأ منذ مدة في عدد من الأقطار، ووراءه تصورات جديدة للتربية تجعل من هذه العملية الحيوية مسارا يراعي خصوصية وتفرد كل متعلم داخل جماعة المتعلمين. ومعنى هذا أن نهاية الخطية، في الكتابة والقراءة، أمر لا مفر منه. ومن رحم المؤسسات التعليمية سيخرج "أدباء" الغد وكتابه الذين لن يكونوا مخضرمين مثلنا. (44) و ـ الاعتراض على الرواية الرقمية انطلاقا من منجزها الراهن، استنادا إلى عدم إدخالها القراء في متاهة من الروابط التشعبية، يحيل إلى مجموعة من الأسئلة التي صادفتها مجالات إبداعية أخرى في عالمنا العربي، مثل: هل نطلب من الرواية، باعتبارها فنا جديدا، أن ترصد الواقع ومعاناة الناس، وتستهدف الشريحة الأوسع من القراء و"تؤرخ" للتغييرات الراهنة، في سياق تبلغ فيه الأمية أعلى النسب في العالم، أم نطالبها باللهث وراء تجريب أشكال جديدة على الدوام احتذاء بالتجارب الغربية التي تجذر فيها هذا الجنس منذ وقت طويل؟ هل نطلب من الفنان التشكيلي أن يرسم لوحات تشخيصية أم نطالبه بالتركيز على التجريد؟ بلغة هذا الفن، كل شيء مع رواية الواقعية، يتم كما لو أنه فيما اختارت لنفسها منحى التشخيص، مراعاة لمستوى المتلقين وحرصا على التواصل معهم، يأتي البعض ويحاسبها على عدم سلوك درب التجريد. 03 قراءة في أعمال محمد سناجلة الرقمية حصيلة محمد سناجلة في الإبداع الرقمي حاليا ثلاثة أعمال، هي: "ظلال الواحد" (45) و"شات" (46) (روايتان)، و"صقيع" (47) (عمل بدون تصنيف داخل أدب الواقعية الرقمية). 0102 إشِكالية القراءة: يضع جنس الأعمال التي نحن بصددها النقد الأدبي، على نحو ما نتعارف عليه اليوم، أمام حرج كبير عائد لتعدد مكونات النص: فالكلمة التي ظلت لحد الآن مكونا وحيدا للأدب ومحور اشتغال قراءته صارت مجرد عنصر ضمن مركب يتكون من: اللغة والصوت والصورة، بسبب ظهور سند جديد للكتابة هو الحاسوب وتوظيف المبدع للإمكانيات التي تتيحها هذه الآلة. أكثر من ذلك، على افتراض إمكانية الفصل بين هذه العناصر الثلاثة التي تشكل في الواقع بنية متكاملة، فإن القواعد البلاغية والنقدية نفسها لم تعد كافية لتحليل هذه الجمل التي تنكتب فوريا أمام عين القارئ، فينزل الحرف تلو الآخر إلى أن تكتمل الكلمة أو الجملة، على نحو ما نجد في قصيدتي "أحتاجك" و"بقايا" (نص "صقيع"). في نص "صقيع"، أو هذه الأبيات الشعرية المكتوبة في أوراق شجرة، التي تتخذ من الشاشة فضاء ركحيا فتتحرك يمينا وشمالا، إلى أعلى فأسفل قبل أن تستقر في مكان ما، كما نجد في قصيدة "وجود" (رواية "شات")، أو هذه السطور المكتوب أحدها فوق الآخر بشكل متعمد بحيث تتعذر القراءة إطلاقا كما نجد في مُدونة موقع كتابات www.e-critures.org أو هذه الفقرات التي تحلق كأسراب طيور في فضاء الشاشة؛ تتوارى عن البصر إلى أن تصير محظ نقط، ثم تعود فتكبر رويدا إلى أن تصير بالكاد مقروءة على نحو ما نجد في الصفحة الرئيسية للموقع السابق ذاته. ظل عجز النقد الأدبي أمام هذه النصوص إلى وقت حديث شبه عام ومعمم؛ "فثاني مظهر (لمجلات الأدب الإلكتروني) يتمثل في الاعتراف بعجز الأدوات النقدية التقليدية في مقاربة هذه الممارسات الأدبية، اعتراف تم خلال ندوة الشمال المنعقدة في موضوع "الشعر والحاسوب" من لدن متخصصين في الأدب المقارن (...) يبدو لي أن ملاحظة مختلف النصوص (نص مرئي، نص مكتوب) تظل غير كافية لوصف الاشتغال الكامل وأنه يجب أيضا إنجاز ملاحظة في فعل القراءة نفسه." (48) وسبب هذا العجز يعود إلى أن الإبداع الرقمي برمته، وإن كان يُنعت بالطليعي، فهو لا يزال هامشيا، و"وهج هذا الشكل الأدبي الذي لا يزال هامشيا، سيندفع حقا يوم سيجد ليس كتابه فحسب، بل وكذلك ناشريه وقراءه وهواته ونقاده." (49) والمحاولات المنجزة، في اللغة الفرنسية على الأقل، تعد على رؤوس الأصابع ولا تكاد تتفق سوى في نقطة واحدة عامة هي دراسة الرابط. لا ينبغي أن يكون هذا مبعث تشاؤم؛ فهكذا الأمر يكون مع كل جديد. عندما ظهرت السينما صادف الأمر نفسه، وأمام غياب تقليد نقدي اضطر هذا الفن لاستعارة مساعيه النقدية من فن مجاور هو "المسرح"، ولكن تدريجيا، وبالتركيز على ما يميز المبتكر الجديد عن الأدب، وهو الكاميرا التي تصلح لالتقاط الصور وكتابتها، تم تدريجيا التخلص من معجم النقد الأدبي وابتكار خطوات نقدية أصيلة (50). وكذلك الشأن سيكون مع الأدب الرقمي الذي "لا يجب الشك في أن لغة نقدية ستتشكل، وستصاغ تدريجيا، من لدن هؤلاء وأولئك، في فرنسا، وإيطاليا وكندا، وفي سائر البلدان التي يُطرح فيها هذا النوع من الأسئلة." (51) لكن ماذا يفعل الناقد الآن أمام مثل هذه الأعمال؟ هل يضع الجزء الأعظم من ثقافته في المتحف وينصرف ليعيد تكوين نفسه من الصفر في فنون الصورة والتشكيل والموسيقى وبعض فروع المعلوميات أم يعترف بمحدوديته وعجزه فينجز ما يقوى على إنجازه ثم يوكل الباقي إلى أهله؟ سبق لمفلح العدوان أن أثار المسألة ذاتها في مقاله "النص الإلكتروني ومأزق الناقد الورقي" (52)، تاركا السؤال مفتوحا حول ما إذا كانت القراءة النقدية لهذا اللون الأدبي الجديد في متناول الناقد المفرد، على نحو ما عودنا النقد التقليدي أم أنها تستوجب تظافر جهود عدة أفراد. وبرأيي، وحدها المقاربة متعددة التخصصات هي الكفيلة بإنجاز قراءة نقدية لهذه النصوص، بحيث ينكب التحليل على المستويات التالية: 1 ـ تقويم الموقع من حيث التصميم اعتمادا على أدبيات منهجية تقويم المواقع، وهي متوفرة وغزيرة؛ 2 ـ تحليل يُركز على العمل في بُعده البصري التشكيلي والفوتوغرافي: فللألوان، كما هو معلوم، معاني ورمزية؛ 3 ـ تحليل ينكب على البرامج المعلوماتية المستخدمة، مثل الماكروميديا فلاش الفيديو، التي لها قواعد استعمال، ومستويات في جودة الإخراج؛ 4 ـ تحليل يستفيد من الأدبيات النقدية المتوفرة في مجال «الأدب والمعلوميات»؛ 5 ـ خطوة أخيرة تأخذ على عاتقها تركيب المقاربات السابقة؛ ومعنى ذلك أننا أحوج ما نكون اليوم إلى ذلك النوع من العمل الذي كان يقوم به ما يسمى بـ "المعهد الخفي" Le collège invisible (53) في الستينيات والسبعينيات، لا سيما أن تطور الرقمية بتحطيمه مقولتي الزمان والمكان يمد اليوم هذا النوع من الأعمال أهم مقومات الوجود. 3. 2. قراءة في أعمال محمد سناجلة لا تزعم هذه القراءة تناول كافة جوانب التجربة موضوع الدراسة، وفي المقابل تود وصف مظهرين منه، وهما التشعب والرابط. تنقسم تجربة محمد سناجلة في الإبداع الرقمي إلى مرحلتين: ـ مرحلة كتابة نص تخييلي تشعبي شجري البناء، يسعى للانفصال عن القراءة والكتابة الخطيين بالخصوص، وتمثله رواية "ظلال الواحد"؛ ـ مرحلة ما يُمكن تسميته بـ "تسخير البرمجة المعلوماتية لإنتاج كتابة أدبية تتصف بدرجة عالية من الجمالية"، وهنا تارة يتناسل التشعب بشكل فريد، بحيث تتعذر القراءة والكتابة الخطيين للنص بالمرة (رواية "شات") وتارة يرتد الرابط ظاهريا إلى منزلة ثانية، حيث نجد أنفسنا أمام عمل يمكن قراءته بتجاوز الوصلات (نص "صقيع")، ولكن إنجاز هذا النوع من القراءة سيُجرد العمل من هويته الرقمية ويبتره من مكونيه البصري والسمعي. حصيلة التجربة هنا عملان: "شات" (رواية)، و"صقيع" (نص). إلى جانب ما سبق، تتضمن تجربة محمد سناجلة مُكونا قابلا للعزل عن بيئته الأصلية ليُقدَّم للقارئ باعتباره يدخل ضمن جنس "القصيدة الرقمية"، ورصيد هذا المكون ثلاث قصائد: "وجود" (المشهد 12 في رواية "شات")، "أحتاجك" و"بقايا" (في نص "صقيع")، ويحتاج بمفرده دراسة خاصة قد نقوم يها في بحث مستقل تناول فيه "الشعر الإلكتروني". في المرحلتين معا، تؤسس النصوص هويتها الفنية الرقمية في التقائها مع سائر التجارب المنجزة في هذا الجنس، بصرف النظر عن لغاتها، في النقطة التالية، وهي: "أننا نرى هنا أن عملا من الأدب المعلوماتي يفترض مؤلفا وقارئا يجب أن يتوفرا على أدوات واحدة. إنها خصوصية فريدة اليوم في مجال الفنون، أن يوضع المبدع والمتلقي تقريبا في وضعية واحدة تجاه العمل: يجب التوفر قسرا على جهاز حاسوب لإبداع عمل في الأدب المعلوماتي كما يجب قسرا التوفر على الجهاز نفسه للوصول إليه. بالإضافة إلى ذلك يجب على الحاسوبين أن يكونا ذوا كفاءة واحدة." (54) 3. 2. 1. تجربة النص التشعبي التخييلي يأخذ "ظلال" شكل عمل سردي أحادي المدخل والمخرج على السواء؛ فالقراءة ليست متاحة خارج الجملة ذاتها التي يجب على كل قارئ أن يلج منها النص ويغادره منها، وهي جملة "ها قد انتهي كل شيء"، كما أنه مهما اختلفت مسالك القرَّاء داخل النص، حيث يأخذ كل قارئ سبيلا، فإن الجميع يخرج من باب واحد، وذلك بخلاف بعض نصوص التشعب التخييلي الأجنبية التي تضع قارئ الصفحة الرئيسية أمام قائمة من الكلمات المعروضة فيما يُشبه فهرست للمحتويات، يمكنه أن يختار منها، وبطريقة جزافية، أي كلمة، بصرف النظر عن موقعها في القائمة، ويباشر عملية القراءة. لكن بالتقدم في قراءة ظلال نصادف روابط ما نختارها حتى ينعطف بنا السرد إلى ناحية أخرى لنجد أنفسنا في قلب حكاية فرعية. التصميم في هذا العمل بسيط، الصفحات بيضاء اللون، والروابط بارزة بخط مغاير، والنص تحضر فيه هشاشة وسيولة النص الإلكتروني حضورا قويا، حيث يمكن الحصول على نسخة منه والتدخل في فقراته وتغيير أسلوبه، بما يضعه في قلب أسئلة الملكية الفكرية. 3. 2. 2. الأدب وجماليات البرمجة المعلوماتية ("شات" و"صقيع") مع "شات" و"صقيع" تتحقق قفزة نوعية في مسار الكتابة الرقمية عند محمد سناجلة، متمثلة في تحويل النص إلى مشهد كتابي ـ سمعي ـ بصري يستحيل على أي كتاب ورقي أن يخرجه: إن نقلناه في دفتر (أو كوديكس) نقرأ، في أقصى الحالات، نصا مكتوبا فوق لوحة أو صورة فوتوغرافية، بمثابة خلفية له، لكن في سند الحاسوب يملك النص الكتابي حرية الحركة ليس فوق الخلفية فحسب، بل وكذلك داخل نوافذ أو إطارات مختلفة، كما في رواية "شات". الملكية الفكرية للعمل هنا محمية بقوة، لأن البرنامج المعتمد هو الماكروميديا فلاش الذي لا يتيح نسخ النص ولا إدخال أي تغيير عليه ما لم تتوفر النسخة ـ الورشة المعتمد قبل الحفظ النهائي للعمل وإخراجه لحقل التداول، بل وحتى في هذه الحالة لا يتأتى التعديل إلا على يد خبير بهذا البرنامج. وإذا كان للفلاش ميزات عديدة تتمثل في إتاحته إنشاء مشاهد متحركة، وإدراج الصوت ومقاطع الفيديو، فإن عيبه يكمن في كونه يمنح الأعمال شكلا إستطيقيا قارا، ومن ثمة إمكانية التساؤل عما إذا كان المؤلف قد تحرر من قيود هذا البرنامج أم استفاد منها (55). تم إمساك العصا من الوسط، إن جاز التعبير، إذ ظل المؤلف حبيس إمكانيات البرنامج من خلال انغلاق العملين، حيث لا نجد أي رابط يحيل إلى خارج النص، لكنه تحرر من هذه القيود عبر مشاهد غرف الدردشة، في "شات"، التي تأخذ شكل نوافذ بمعنى الكلمة، تتضمن نصا يمكن التجول فيه والتنقل بين أرجائه من أعلى إلى أسفل، والعكس، كما نقرأ أي صفحة ويب. 3. 2. 2. 1. رواية "شات" تأخذ رواية "شات" شكل أربعة عشر مشهدا فنيا، لكل منها عنوان مستقل، تأتي متسلسلة ذات نظام خطي، بحيث يتعذر على القارئ أن يقوم باختيار عشوائي لمشهد ما على غرار ما نجد في موقع "ألف ليلة وليلة" (56) الذي يضع أحد مشاهده بين يدي القارئ خريطة للشرق العربي، وقد وُضعت في مجموعة من بلدانها نقط ـ روابط، كل منها تتيح إمكانية استهلال القراءة، ليجد القارئ نفسه حرا في الانطلاق من أي نقطة، بلد، حكاية شاء، حتى إذا اتبع أحد مسالك التصفح وجد نفسه مُجددا أمام قائمة من الحكايات يمكنه استهلال القراءة بأي منها. وبذلك تدخل هذه التجربة إلى ما يصنفه بعض النقاد ضمن أعمال الأدب المعلوماتي "ذات التصفح القسري" navigation contraignante مقابل الفئة الأخرى في الأدب نفسه التي يُطلق عليها مصطلح "الأعمال التي تقترح تصفحا حُرَّا navigation libre (57) ربما كان مفيدا إضافة صفحة أو مشهد أخير إلى رواية "شات" يكون عبارة عن فهرست يتيح للقارئ الرجوع إلى أي مشهد مباشرة دون العودة التسلسلية أو الانطلاق مجددا. كذلك لا نجد ما يتيح الخروج من الحكي في مشاهده الأربعة عشر، وسيكون مفيدا أيضا وضع هذه الإمكانية بين أيدي القراء. تسلسلُ مشاهد الحكي ربما فرضته طبيعة الرواية ذاتها، وهي طبيعة خطية ذات بداية وأحداث متسلسلة تفضي إلى نهاية يمكن تجميعها على النحو التالي: 1 ـ حياة البطل بعيدا عن بلده وزوجته، لظروف مهنية، في بيئة صحراوية شديدة القسوة، وإحساسه الشديد بالغربة والمنفى والقلق، بمعنى أنه يحيا ضربا من الموت؛ 2 ـ اكتشافه للعالم الافتراضي بعد تعرفه، عن طريق الصدفة، على أنثى تعيش في قارة أخرى 3 ـ تأسيسه عالما بديلا عن العالم الواقعي، متمثلا في "مملكة الحب" التي ستتحول إلى مجتمع بمعنى الكلمة، له رئيس هو بطل الرواية (الملك ـ نزار) وملكة (منال ـ حبيبة نزار)، ورعية (رواد غرفة الدردشة)؛ 4 ـ تمرد الرعية على الملك، وانسحابه النهائي من العالم الافتراضي. 3. 2. 2. 1. 1. الرابط في "شات" يستخدم هذا العمل عدة أنواع من الروابط مجموعها يُفند رأي د. عبير سلامة ود. فاطمة البريكي القائل بضرورة أن تكون الوصلة في الرواية التشعبية أو التفاعلية (أو ما شئنا من الأسٍماء) بلون أزرق (58). كل الوصلات وردت إما على شكل صور ـ أيقونات متفاوتة الصغر، أو عبارة عن صيغ داخل مستطيل متوهج. ونقتصر في هذه "القراءة" على تناول نوعين من الروابط: رابط رسائل الـ msn، ورابط غرف الدردشة. رابط رسائل الـ msn الوافدة على البطل إلى هاتفه الخلوي يأخذ شكل أيقونة ـ صورة صغيرة جدا لهاتف خلوي، ما أن يلامسها الماوس حتى ينبعث إيقاع موسيقي جميل حتى إذا نقرت على الرابط طفا على الشاشة صورة هاتف جوال تعرض شاشته نص الرسالة المتوصل بها وقد أخذ شكل نصا متحركا يشبه جينيريك الأفلام لنجد أنفسنا باعتبارنا قراء أمام نص ـ صورة ـ مشهد يتألف من عناصر أربعة: ـ الخلفية العامة للنص، المشهد الأصلي؛ ـ النافذة التي تعرض النص المقروء؛ ـ صورة جامدة للهاتف الخلوي؛ ـ نصا متحركا داخل جزء من الصورة السابقة (شاشة الهاتف الجوال)؛ ـ خلفية موسيقية مقترنة بمرور الماوس على أيقونة الهاتف الخلوي وظهوره؛ روابط غرف الدردشة ترد على شكل أيقونة غرف الدردشة في الياهو أو مكتوب. كل أيقونة تفضي إلى ظهور نافذة جديدة في الشاشة وتسوقنا كقراء إلى غرفة لتمكيننا من الاطلاع على ما يجري فيها وعلى الأحاديث الدائرة بين أعضائها، بل وحتى على ما يسعى كل مستخدم للتميز به عن الآخرين كتلوين الخط مثلا، وبداخل الغرفة نجد أنواعا من الروابط التشعبية التي تضع المتصفح أمام ما يشبه الدمى الصينية، حيث ما أن تفتح دمية حتى تجد بداخلها أخرى: فمشهد ـ فصل، "ولادة"، مثلا، يتضمن وصلتين بشكل صورتين أيقونتين لغرف الدردشة بموقع "مكتوب" تُعرضان بمؤثر فلاشي، الأولى تحيل إلى غرفة السياسة والثانية إلى "مملكة العشاق. وطن الحب والحرية". بالضغط على الرابط الأول، يعرض النص شاشة جديدة إلى غرفة جديدة politic room، لنطلع على نقاش روادها، وفي أسفل النافذة نجد رابطا جديدا أخذ شكل مربع أزرق متوهج بداخله عبارة Nizar Left the room، بمجرد الضغط عليه تنبجس شاشة بجانب الغرفة تتضمن نصا ("لم تكن موجودة، بحثت عنها في كافة أرجاء الغرفة..") يتضمن سطره ما قبل الأخير رابطا جديدا، عبارة عن مستطيل أزرق متوهج بداخله كلمة "بيت نزار"، وفور الضغط على الرابط الجديد، تظهر نافذة جديدة لتدخلنا، باعتبارنا قراء، إلى الغرفة التي أنشأها نزار للتو تحت اسم "مملكة العشاق وطن الحب والحرية". هذا العنوان أخذ بدوره شكل رابط أزرق متوهج بمجرد ما يتم الضغط عليه يظهر نص جانبي جديد ("ودخلت، تربعت على عرشها، وحيدا والتاج على رأسي...")، ينتهي هو الآخر برابط متوهج هو جملة: "أحب وطنك، فانتظرني، سآتيك"، وفور الدخول إلى هذه الوصلة الجديدة، يجد القارئ نفسه في غرفة "مملكة العشاق. وطن الحب والحرية" التي يمكن الدخول إليها كذلك انطلاقا من المدخل الرئيسي لهذا الفصل ـ المشهد (ولادة)، عبر الأيقونة الثانية كما سبق وأن ذكرنا: ـ أيقونة مكتوب (غرفة السياسة) ـ Admin : nizar the left room ـ بيت نزار ـ مملكة العشاق.. وطن الحب والحرية ـ أحب وطنك فانتظرني سأتيك - نزار خاص أرجوك ـ نافذة بدون رابط ومعنى ذلك أنه من خلال أيقونة رابط أصلي، يتم النفاذ، وبشكل متدرج إلى سبعة روابط كل منها يفضي إلى نص ـ نافذة جديدة، تماما كما في الدمى الصينية. وهذا واحد من العناصر التي تجعل عملية إخراج هذا النص في سند ورقي مستحيلة ولو باعتماد اقتراح د. عبير سلامة القائل بإلحاق الوصلات بالنص على شكل هوامش، لتترك بعد ذلك للقارئ حرية قراءتها أو تجاوزها (59). 3. 2. 2. 2. نص "صقيع" يأخذ نص "صقيع" شكل مشهد (أو ملف واحد) يتاح للقراءة مرة واحدة وفي وقت وجيز بالمقارنة مع رواية "شات". بنية النص في هذا العمل: ـ خلفية موسيقية عبارة عن مقطع يحاكي الرعد، يتردد على امتداد القراءة، ـ لقطة ـ صورة من الشريط الاستهلالي عبارة عن صورة للبطل وهو جالس في أريكة. الصورة رمادية وبالكاد تُرى. ـ ثلج يتساقط على غرار ما نجد في واجهات بعض المواقع، بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، ويولده أحد سكريبتات الجافا؛ ـ ثم النص المكتوب بأسود داكن. ويتاح للقارئ التجول فيه، من أعلى إلى أسفل والعكس، عبر زرين بمجرد ما تلامس أحدهما الماوز. ـ مجموع العناصر السابقة تُعرض في نافذة مستطيلة تتوسط الشاشة التي تأخذ لونا أسود داكنا، بما يُبدي النص صورة بمعنى الكلمة، ويجعل القارئ يقرأ بطاقة أو صورة. 3. 2. 2. 1. الروابط في "صقيع" يتضمن نص صقيع عشرة روابط، كلها باللون الأزرق، وهي تشمل جملا بكاملها ما أن يتم الضغط عليها حتى تُعرض، بشكل أوتوماتيكي، "نافذة" تحتل مجموع مساحة الشاشة، عبارة عن مشهد سينمائي أو لقطة فيديو بالأسود والأبيض، يجسد محتوى الجملة، فيما يبدو، وذلك باستثناء رابطين اثنين كلاهما يحيل على قصيدة شعرية رقمية. سبق للأستاذ أحمد فضل شبلول أن تساءل: لماذا إدراج روابط تشعبية في جمل دون غيرها؟ الجواب برأيي هو أن هذه الروابط ربما تتيح قراءة "مختصرة" للنص. يبدو أن هذه الجمل هي النواة الأولى للنص، ومن ثمة يصير بإمكان القارئ الاختيار بين إحدى قراءتين: ـ الأولى: مسترسلة من البداية إلى النهاية، وهي قراءة تنتظر مشاهدة كل لقطة "سينمائية" (أو لقطة فيديو) إلى حين ورودها في سياقها؛ ـ الثانية: قراءة الجمل ذات اللون الأزرق، ثم الضغط عليها مباشرة لاستدعاء المشهد: "قمت أجر نفسي. الجدار يترنح تحت يدي. فجأة انضم السقف. وصلتُ على الفراش. كم أحتاجك الآن. انضمت أسرة كثيرة. ما بقا لي قلب بعد. امتدت يد في الظلام. فتحت يدي بصعوبة. يالله عفوك". د. محمد أسليم من أوراق المؤتمر العربي الأول للثقافة الرقمية بطرابلس هوامش وإحالات 1 - تحت هذا العنوان أصدرت دار غاليمار الفرنسية للنشر قرصا مدمجا، يشتمل على أعمال من الإبداع التفاعلي والتركيبي، ومحترفا للكتابة. http://www.gallimard.fr/multimedia/html/Ecrire.html 2 - Emberto Eco, »auteurs et autorités«, Un entretien avec Gloria Origgi. Traduction d'Anne-Marie Varigault, in Actes du colloque virtuel : Ecans et réseaux, vers une transformation du rapport à l’écrit ? http://www.text-e.org/conf/index.cfm?ConfText_ID=11 3 - نفسه. 4 - كم سيكون مفيدا توسيع البحث في فضاءات أخرى للنظر في كان الأمر مماثلا أو مختلفا في لغات كالروسية والصينية واليابانية والكورية والهندية والألمانية، الخ. 5 – Elodie Ressouches, Les institutions de la littérature revisitées par Internet, Mémoire de Maîtrise de Lettres modernes effectué en 2003 / 2004 à l'Université de la Sorbonne nouvelle – Paris 3 : http://www.elores.com/memoire/index.php 6 - عنوانه http://www.arab-ewriters.com 7 - Christian Vanderdorpe, «De la lecture sur papyrus à la lecture sur codex électronique» : http://www.banq.qc.ca/documents/extranet/bibliotheques/ documentation/conferences_presentations/vandendo.pdf 8 - لمزيد من التوسع في هذا الموضوع، يمكن الرجوع إلى: - Ollivier Dyens, «Le web et l’émergence d’une nouvelle structure de connaissances», in Actes du Colloque virtuel sur Le défi de la publication sur le web. Hyperlectures, cybertextes et méta-éditions : http://www.interdisciplines.org/defi...nweb/papers/11 9********************************* 10 - منتدى مجلة ميدوزا (الإصدار القديم) http://www.aslim.org/forum/viewtopic.php?t=633 11 - يوجد نصها بالعنوان http://chouika.atspace.com 12 -Jean Clément, «Hypertextes et mondes fictionnels ou l'avenir de la narration dans le cyberespace» : http://www.european-mediaculture.org...thek/francais/ clement_hypertextes/clement_hypertextes.pdf 13 - أحمد عيساوي "اتحاد كتاب الإنترنت العرب يكرس وصاية المشرق على المغرب ويصنع كتابا أشباحا"، منتدى ميدوزا. 14 - يمكن تحميل نصه كاملا انطلاقا من موقع اتحاد كتاب الإنترنت العرب http://www.arab-ewriters.com/library/ 3088886520051010153809.doc 15 - الكتاب صدر في الأصل باللغة الأنجليزية، تحت عنوان: The End of Work، وترجم إلى لغات عديدة، وآخر طبعة فرنسية له - Jeremy RIFKIN, La fin du travail, préface de Alain CAILLÉ, Michel ROCARD Traduit de l'américain par Pierre ROUVE, ed. la Découverte, Coll. La Découverte Poche / Essais, (n°34), 1996 (532p.). 16 - يمكن الاطلاع على نصع كاملا في موقع شعبة الوسائط التشعبية بباريس الثامنة بالعنوان http://hypermedia.univ-paris8.fr/pie...uel/virt10.htm 17 - محمد سناجلة، رواية الواقعية الرقمية. تنظير نقدي، مصدر سابق. 18 - محمد سناجلة، رواية الواقعية الرقمية. تنظير نقدي، مصدر سابق. 19 - نفسه. 20 - نفسه 21 - د. محمد سناجلة، رواية الواقعية الرقمية. تنظير نقدي، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، 2005 (98 ص). 22 - Christian Allègre, Textes, corpus littéraires et nouveaux médias électroniques: quelques notes pour une histoire élargie de la littérature«, in: Etudes françaises, Internet et littérature : nouveaux espaces d’écriture?, Volume 36, numéro 2 (2000) : http://www.erudit.org/revue/etudfr/2...2/005252ar.pdf 23 - راجع: - د. سعيد الوكيل "لأن النوايا الطيبة لا تكفي لصنع نوع أدبي جديد: خرافة الواقعية الإلكترونية". صدر في أسبوعية "أخبار الأدب" يوم 30 اكتوبر 2005، ويمكن قراءة نصه كاملا انطلاقا من العنوان http://www.akhbarelyom.org.eg/adab/issues/642/0800.htm - د. محمد سناجلة "عن التفاعلي والترابطي والرقمي والواقعي الرقمي". ميدل إيست أونلاين، بتاريخ 12/12/2005 http://www.meo.tv/?id=35082 - د. عبير سلامة "ظهيرة مايكل جويس وشروق شمس أرلانو". موقع ميدل إيست أونلاين، بتاريخ 21/12/2005 http://www.middle-east-online.com/?id=35239 24 - ثار هذا النقاش بمناسبة تنظيم أمسية شعرية رقمية عبر الفضاء الرقمي، بتعاون بين بيت الشعر التونسي واتحاد كتاب الإنترنت العرب، مساء الخميس 19/10/2006 الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش، ويمكن الاطلاع عليه في منتدى الاتحاد انطلاقا من العنوان http://forums.arab-ewriters.net/viewtopic.php?t=317 25 - د. سعيد الوكيل، "لأن النوايا الطيبة لا تكفي لصنع نوع أدبي جديد: خرافة الواقعية الإلكترونية". صدر في أسبوعية أخبار الأدب، عدد 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2005، ويمكن قراءة نصه كاملا انطلاقا من العنوان http://www.akhbarelyom.org.eg/adab/issues/642/0800.html 26 - يتعلق الأمر بـ - Madeleine et Georges de Scudéry , Artamène ou le Grand Cyrus وهي رواية تقع في 000 13 صفحة، نشرتها جامعة نيوشاتيل كاملة بصيغ عديدة للقراءة في الموقع http://www.artamene.org 27 - المقال صدر في مجلة «جذور» بالعنوان نفسه، يوم الخميس 21 ديسمبر 2006 http://www.jozoor.net/main/modules.php?name =News&file=article&sid=513 28 - Alain Vuillemin : «De la poésie électronique au roman interactifs» http://www.epi.asso.fr/revue/94/b94p051.htm 29 - نفسه. 30 - Jean Pierre Balpe, «Pour une littérature informatique : Un manifeste...», in Hermeneia : http://www.uoc.edu/in3/hermeneia/sala _de_lectura/balpe_pour_une_litterature_informatiqu.htm 31 - William Winder Université de Colombie britannique (Vancouver, Canada), «Le robot-poète:littérature et critique dans l'ère électronique» : http://www.uottawa.ca/academic/arts/astrolabe /articles/art0033/Robot-poete1.htm 32 - راجع الجزء الثاني من المقا ل نفسه انطلاقا من العنوان http://www.uottawa.ca/academic/arts/ astrolabe/articles/art0033/Robot-poete2.htm 33 - يراجع في هذا الصدد مقالا هاما للمشرف على عملية إنتاج القرص المدمج، بالعنوان نفسه - Berbard Magné, «Machines à écrire», Etudes françaises, v. 36, n° 2, 2000, pp. 119-128. ويمكن تصفحه في الشبكة انطلاقا من العنوان http://www.erudit.org/revue/etudfr/2000/ v36/n2/005258ar.pdf 34 - حسن سليمان "محمد سناجلة والكتابة الرقمية وتغييب مفهوم الأدب"، مرجع سابق. 35 - نفسه. 36 - د. فاطمة البريكي "الرواية التفاعلية ورواية الواقعية الرقمية. ظلال الواحد لمحمد سناجلة أول رواية تفاعلية في الوطن العربي." موقع ميدل إيست أنلالين، 03 يونيو 2005 http://www.meo.tv/?id=31231 37 - موقع الشعبة موجود في الشبكة، وفيه بحوث عديدة قيمة، بل وأعمال إبداعية أدبية وتوظف تقنيات الحاسوب http://hypermedia.univ-paris8.fr 38 - الصفحة الرئيسية للموقع http://www.ciren.org/ciren/leciren/index.html 39 - نفسه. 40 - نفسه. 41 - أحمد فضل شبلول "صقيع: تجربة إبداعية رقمية جديدة لـ محمد سناجلة"، ميدل إيست أنلالين، 14 اكتوبر 2006 http://meo.tv/technology/?id=41815 42 - Alain Vuillemin, «Littérature et informatique : de la poésie aux romans électroniques», op. cit. 43 - نفسه. 44 - هناك العديد من المواقع والدراسات المخصصة للتطبيقات التربوية للنص التشعبي في المدارس الابتدائية والثانية (الأجنبية) التي تمضي من استهداف تقوية مهارات القراءة والفهم والكتابة إلى كتابة نصوص تخييلية جماعية. من هذه العناوين على سبيل المثال: - Jean-Claude Lasserre, «En quoi la Technologie de l’Hypertexte peut-elle éclairer l’acte de lire ? « D’un écrit fictionnel écrit par les enfants vers un écrit scientifique . » Compte-rendu d’un travail mené avec la classe de CM1-CM2 de l’école de Saramon dans le Gers» : http://www.crdp-toulouse.fr/cddp-32/html/ pedagogie/innovations/experiences-locales/saramon .htm?PHPSESSID= 85b6ecb788fe829cd84097bbc147fa3c - Chantal BERTAGNA, "APPROCHES" - UN HYPERTEXTE - DELETTRES Des exemples d'utilisation en collège» : http://www.epi.asso.fr/revue/82/b82p109.htm - رواية تفاعلية من كتابة تلاميذ إعدادية Anatole Françe: http://www2.ac-lille.fr/afrance-sinlenoble/ Yves2004/roman%20interactif.htm 45 - صدرت سنة 2001، ويمكن الاطلاع عليها انطلاقا من العنوان (الذي لم أتمكن من الدخول إليه أثناء تحرير هذا العرض) http://www.sanajlehshadows.8k.com 46 - صدر هذا العمل سنة 2005، ويمكن تصفحه انطلاقا من موقع اتحاد كتاب الإنترنت العرب http://www.arab-ewriters.com/chat 47 - صدر هذا العمل في اكتوبر 2006، ويمكن تصفحه انطلاقا من موقع اتحاد كتاب الإنترنت العرب: http://www.arab-ewriters.com/saqee3/ 48 - Philippe Bootz, «LA LITTERATURE INFORMATIQUE : UNE METAMORPHOSE DE LA LITTERATURE», in : la Revue de l'EPI n° 81, mars 1996. http://www.epi.asso.fr/revue/81/b81p171.htm 49 - Alain Vuillemin, «Littérature et informatique. De la poésie électronique aux romans interactifs», op. cit. 50 - Xavier Malbreil, «Pour une méthodologie d’approche critique des œuvres de littérature informatique», in : Rilune : http://www.rilune.org/mono5/malbreil.pdf 51 - نفسه 52 - مفلح العدوان "الكتابة الرقمية ومأزق الناقد الورقي"، دراسة منشورة في موقع اتحاد كتاب الإنترنت العرب http://www.arab-ewriters.com/?action...e=ON1&&title=5 53 - شبكة "افتراضية" من العلماء في تخصصات علم الفلك والفيزياء والمعلوميات والبيولوجيا والطاقات النفسية، ينتمون إلى ست دول، تأسست عام 1960 وتوقفت سنة 1975. وكانوا يلتقون دوريا لتبادل نتائج أبحاثهم. 54 - Xavier Malbreil, «Pour une méthodologie d’approche critique des œuvres de littérature informatique», op. cit. 55 - Xavier Malbreil, «Méthodologie d’approche critique…» , op. cit. 56 - موقع فرنسي، يندرج ضمن الأدب التفاعلي http://www.2001nuits.net Xavier Malbreil, «Pour une méthodologie….», op. cit. 57 - د. عبير سلامة "النص المشعب ومستقبل الرواية". صدر في مجلة نسابا، يوم 23 نوفمبر2003: http://www.alimizher.com/n/3y/studie...ies3/hyper.htm أعيد نشره في ميدل إيست أونلاين، 21 دجنبر 2005: http://www.middle-east-online.com/?id=35239 58 - د. فاطمة البريكي "الرواية التفاعلية ورواية الواقعية الرقمية"، مرجع سابق. 59 - د. عبير سلامة، «النص المشعب ومستقبل الرواية»، مرجع سابق. [/RIGHT] 
|

|
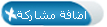 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
 المواضيع المتشابهه
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| marc | AASS | منتدى تقنية المعلومات | 5 | Jan-20-2014 11:52 AM |
| مفاهيم أساسية في بنية المكتبة الرقمية | هدى العراقية | منتدى تقنية المعلومات | 10 | Dec-26-2010 05:58 PM |
| تأثير البيئة الرقمية على إعداد أخصائي المعلومات : التحديات والتطلعات | أحمد حسن (المعلوماتى) | منتدى تقنية المعلومات | 3 | Apr-12-2009 10:07 AM |
| أدب الأطفال وتجربة ثقافة الطفل : الواقع والآمال | د.محمود قطر | عروض الكتب والإصدارات المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات | 3 | Feb-04-2007 11:03 PM |
| The ACM Digital Library المواد التي تحتوي على الاسبستوس في المكتبه الرقميه | el_khater | المنتدى الــعــام للمكتبات والمعلومات | 3 | Nov-26-2006 01:01 AM |