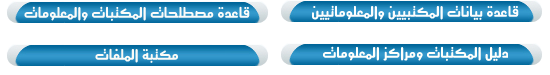
| المنتدى الــعــام للمكتبات والمعلومات هذا المنتدى يهتم بالمكتبات ومراكز المعلومات والتقنيات التابعة لها وجميع ما يخص المكتبات بشكل عام. |
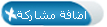 |
|
|
المشاركة1 |
|
المعلومات
مكتبي جديد
البيانات
العضوية: 35844
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: السعـوديّة
المشاركات: 2
بمعدل : 0.00 يومياً
|
السلام عليكم ورحمة الله
اريد القوانين الخمسة لرانجاناثان مع شرحها وايضا اريد معلومات عن هؤلاء العلماء الذين اسهموا في تطور مسيرة علم المعلومات : برترام بروكس مانفرد كوخن الفن شريدر الفن توفلر جوزيف هنري بول اوتليه هنري لافونتين مع العلم اني بحثت عنهم ولم اجد اي معلومات تفيدني ولكم جزيل الشكر |

|
|
|
المشاركة2 |
|
المعلومات
مكتبي جديد
البيانات
العضوية: 36910
تاريخ التسجيل: Nov 2007
الدولة: السعـوديّة
المشاركات: 8
بمعدل : 0.00 يومياً
|
الأجابه في ملزمه العلمـاء اللى أمتحنا فيها ..
 
|

|
|
|
المشاركة3 |
|
المعلومات
مكتبي جديد
البيانات
العضوية: 36910
تاريخ التسجيل: Nov 2007
الدولة: السعـوديّة
المشاركات: 8
بمعدل : 0.00 يومياً
|
أطروحة نقدية فى فلسفة علم المكتبات حول (الخيال أوسع من العقل!) مع الاعتذار لأبى العلاء فى لزومياته كذب الظن لاإمام سوى العقل ... مشيرا فى صبحه والمسا كلية الآداب – جامعة حلوان مقدمة : هل نحن بحاجة إلى مقدمة أو مدخل ليبرر لنا الأسباب التى تقف حتى الآن وراء عدم وجود عمل متكامل يسمى بفلسفة علم المكتبات، وعدم ظهور - حتى وقتنا الحاضر - منهج واحد لعلم يسمى فلسفة المكتبات، فهاهو أكثر من قرن وبضع سنين تمر دون أن تكون هناك معالم واضحة لفلسفة علم المكتبات، أو مضمونا متكاملا يقبل به العقل. أهمية الدراسة:على الرغم من صدور مجموعة من الأعمال التى تعلقت بفلسفة المكتبات إلا أنها فى مجملها لاترسخ لأن نقبل بعلم يسمى فلسفة علم المكتبات. وتمثل المحاولة التالية مجموعة من الأطروحات الأولية للبحث في إحدى المقولات التى بني عليها ما يمكن أن يسمى بفلسفة علم المكتبات، وربما هى تمثل فى دلالتها الأولى إعادة لطرح أسئلة فى علم المكتبات وماهيته بأسلوب منهج البحث العلمي الذى طرحه بيكون. يدين علم المكتبات شأنه شأن الكثير من العلوم الاجتماعية – إذا سلمنا بأنه من العلوم الاجتماعية وهو قول سنعود إليه فيما بعد – يدين إلى وجوده ورسوخ أرضه إلى حد ما إلى علماء الفيزياء والرياضيات، ولم يستطع علم المكتبات على مدار هذه السنين أن يجتذب عالما واحدا من علماء الفلسفة المبرزين ليعطينا درسا فى أهمية وجود علم يعتنى بفلسفة علم المكتبات. مشكلة الدراسة :وتمثل هذه الدراسة محاولة أولية –إن كتب لها النجاح - لوضع مجموعة من الأسس تقف جنبا إلى جنب مع الأسس التى تحكم علم المكتبات، أو أنها تنحو نحو الإجابة على مجموعة من الأسئلة الأولية التى تواجه طالب علم المكتبات المتخصص، فى رحلة دراسته وبحثه فى علم المكتبات، وكذلك لدراسة مدى مايمكن أن نصل به فى فلسفة علم المكتبات إذا تم استخدام واحد من مناهج علم الفلسفة وهو منهج البحث العلمي لفرنسيس بيكون* ومجموعة من مناهج التفكير المختلفة فى علم الفلسفة. إذا كانت الفلسفة هى أم العلوم، وهى فى الوقت ذاته تعنى حب الحكمة، وإذا كانت فلسفة العلم أى علم تعنى بالبحث فى أسباب وجود هذا العلم وماهيته والتحقق من الأفكار والنظريات التى تحكمه ومن ثم تسعى إلى استفزاز قدراتنا العقلية والتخيلية والتفكر والتدبر فى ماهية علم المكتبات، ونحن فى حاجة ماسة إلى هذا النوع من الفكر المتمرد على كل الموروثات الجينية فى علم المكتبات وإعادة بناؤها وتنظيمها من جديد حتى يمكننا مساعدة أنفسنا ومن ثم مساعدة البشرية على تخطى واحدة من العقبات التى تعترض مفهوم وربما وجود المكتبة كمؤسسة فى عالمنا المعاصر. أسئلة الدراسة:مشكلة هذه الدراسة هى التحقق من مدى صدق مقولة رانجاناثان (1872-1972) " المكتبة كائن حي ومتنام" وهل تعد واحدة من أوهام المسرح (كما سماها بيكون)، أم أنها تحتاج لشروحات وتحليل تبين صدقها من عدمه. تحاول الدراسة الإجابة عن مجموعة من الأسئلة التى تمثل محاور الدراسة : 1. مامعنى المبدأ الخامس لرانجاناثان: المكتبة كائن حى ومتطور؟ منهج الدراسة:2. هل يمكن وضع مقياس لمدى تطور ونمو كائن حى يسمى المكتبة’؟ 3. ما دورات حياة المكتبة ككائن حى؟ 4. تأثير وعاء المعلومات على تطور المكتبة ككائن حى؟ 5. من أولا : المكتبة أم الوعاء؟ 6. مامدى تأثير الفكر الجمعى على دور المكتبات؟ 7. ما مدى صحة انتماء علوم المكتبات ضمن العلوم الاجتماعية؟ يمكن القول بأن فرنسيس بيكون هو الذى أرسى قواعد البحث العلمي، وقد نقد بيكون العقل[1] ، ولكنه بدأ أولى مقالاته العلمية فى مديح العقل حيث قال " سأقدم مديحى للعقل نفسه، العقل هو الإنسان، والمعرفة هى العقل، وليس الإنسان إلا مايعرف.. وأن المعرفة وحدها تنقى العقل من جميع أنواع التهيج والاضطراب"[2]، كذلك من خلال إشارته إلى مجموعة الأفكار والبديهيات التى يقابلها الإنسان فى حياته العلمية أو المجردة أطلق عليها أصنام أو أوهام (أى يجب تحطيمها أو دحضها)، وقسمها إلى "أربعة أصناف من الأصنام التي تؤرق عقول الناس. وقد سميتها بهدف التمييز بينها: فسميت الصنف الأول أصنام القبيلة (idols of the tribe)، الثاني أصنام الكهف (idols of the cave)، الثالث أصنام السوق (idols of the market)، والرابع أصنام المسرح (idols of the theater)" [3]. وقد شرحها بيكون فى العمل المشار إليه[4] شرحا مفصلا يمكن الرجوع إليه فى الهامش، والحقيقة أن الباحث يعتقد أن هناك العديد من المقولات فى علم المكتبات تحتاج إلى التدقيق والتمحيص، وعلى ذلك فسيلتزم الباحث بالمنهج الفلسفي لفرنسيس بيكون فى التناول العلمي لمقولة رانجاناثان، فعلى الرغم من الدراسات والأبحاث لأقرانه من خريجي تخصص المكتبات لهذه المقولة المتعلقة برانجاناثان إلا أنه عجز عن الوصول لشروحات تتناولها، والباحث يحاول فى هذه الدراسة التناول الفكري لقاعدة " المكتبة كائن نام ومتطور" من خلال الاعتماد على القراءات النظرية الفلسفية، والتناول العقلى لها المبنى على المناهج العلمية الراسخة فى البحث والدراسة. يعتقد الباحث بأن هذه المقولة تعتبر واحدة من أوهام المسرح، حيث تم دراستها دون التعرف على أبعادها ومضمونها الحقيقي، إضافة إلى العديد من التساؤلات التى تكتنفها وبالتالي قد لاتكون القضية دحض المبدأ بقدر ماهى التأكد من مضمونه ومحتوياته ومدى اتساقها مع الاستقراءات العقلية. ويعد ( فرنسيس بيكون ) ت 1626 من أبرز رواد هذا الاتجاه ، الذي عمد إلى صياغة نظرية الأوهام ومدى ارتباطها بالعقل ، محدداً إياها في أربعة أنماط سلبية ، ممثلة في أوهام القبيلة والمرتبطة بالعقل الجمعي للجنس البشري عموماً، أوهام الكهف المرتبط بالعقل الفردي ومؤثرات البيئة والأعراف والتقاليد التي نشأ فيها في تحديد آرائه وانطباعاته حول الظواهر، وأوهام السوق ذات الارتباط المباشر بالدلالات التي تحملها اللغة ، وتأثيرات الاستخدام السلبي لها في إثارة الإشكاليات، وأوهام المسرح المرتبطة بقبول الأفكار والنظريات من دون ترو أو تمحيص،أو هيمنة الأفكار القديمة على الواقع مما يجعل منها عقبة كأداء في سبيل الوصول إلى الحقيقة . * يطيب لى أن أتوجه بخالص شكري وتقديري للأستاذ الجليل أسامة السيد، أستاذ المكتبات والمعلومات بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب – جامعة القاهرة، فلولا جلساتنا فى مقتبل عمرنا الأكاديمي حين كان معيدا وكنت أنا طالب بالسنة الرابعة حول مناهج البحث، ولولا أحلامنا العلمية البسيطة لما كان هذا العمل. * فرنسيس بيكون (1561-1626) فيلسوف إنجليزي ولد بلندن، دخل جامعة كامبردج عام 1573 وخرج منها بعد ثلاث سنوات دون أن يحصل على إجازة علمية، درس القانون وانتظم فى سلك المحاماة 1582، ثم عمل أستاذا بمدرسة الحقوق، وعين مستشارا فوق العادة للملكة اليزابيث، ولكنه رغم كل ما حققه كان وضيعا ومرتشيا، وفقد اعتباره فى حكم شهير لمجلس اللوردات عليه. [1] يوسف كرم. تاريخ الفلسفة الحديثة.ط5. القاهرة : دار المعارف، 1986. ص ص 44-50 ( مكتبة الدراسات الفلسفية) [2] ديورانت ، ول. قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون ديوى تأيف ول ديورانت، ترجمة فتح الله محمد المشعشع. ط5. بيروت: مكتبة المعارف،(؟197). ص143 [3]بيكون، فرنسيس. مختارات من الأورغانون الجديد "أقوال حول تفسير الطبيعة وملكوت الإنسان". على الإنترنت : http://home.birzeit.edu/phil-cs/arabic/publications/book/beacon.html فى 23/1/2006. [4]حيث يقول " إن تكوين الأفكار والبديهيات بواسطة الاستقراء الصحيح هو دون شك العلاج المناسب للابتعاد عن، والتخلص منالأصنام. إن الإشارة إليهم ذات فائدة كبيرة وذلك لأن نظرية الأصنام بالنسبة لتفسير الطبيعة هي كنظرية تفنيد المغالطات بالنسبة للمنطق العام. تجد أصنام القبيلة أساساً لها في الطبيعة البشرية ذاتها أو في قبيلة أو في عنصر البشر. يُخطئ من يقول جازماً بأن حاسة الإنسان هي مقياس الأشياء. على العكس تماما، فإن جميع الإدراكات، الحسية منها والعقلية، هي وِفق مقياس الفرد وليس وِفق مقياس الكون. والفهم البشري مثل مرآة كاذبة، والتي باستقبالها الأشعة بصورة غير عادية تشوه وتحول لون الأشياء، تخلط طبيعتها هي بطبيعة تلك الأشياء. أصنام الكهف هي أصنام الإنسان الفرد. لكل فرد (بالإضافة إلى الأخطاء المشتركة للطبيعة البشرية بعامة) كهفه أو جحره الخاص به، والذي يحول لون الضوء الطبيعي، ويعدو ذلك إما لطبيعة الفرد الخاصة أو لتعليمه ومخالطته الآخرين، أو لقراءة الكتب وسلطة أولئك الذين ينظر إليهم بالإجلال والإعجاب، أو لتباين الانطباعات، وفقاً لوجودها في عقل مستحَوذ وذي ميول مسبقة أو في عقل محايد ومستقر، وما شابه ذلك. وإذن فإن روح الإنسان (كما هي موزعة على الأفراد المختلفين) قابلة للتغير ومليئة بالاضطراب، وكأن الصدفة تتحكم بها. فقد صدق هرقليطس[4][6] (Heraclitus) حين لاحظ أن الناس يبحثون عن العلوم في عوالمهم الخاصة الضيقة، وليس في العالم الكبير أو المشترك. هناك أيضا أصنام تتكون خلال التعامل والمخالطة بين الناس، وهذه الأصنام أدعوها أصنام السوق، وذلك نظراً لعلاقات التبادل والمشاركة بين الناس هناك [أي، في السوق]. بواسطة الكلام يتفاعل الناس مع بعضهم البعض، ويتم فرض الكلمات حسب فهم العامة لها. ونتيجة لذلك فإن سوء اختيار الكلمات يشكل حجر عثرة في طريق الفهم. ولا تساعد التعريفات والتفسيرات التي دأب المتعلمون على الدفاع عن أنفسهم بها في بعض الأمور، في أي حال من الأحوال، على تقويم ما اعوجّ من الأمور. ومن الواضح أن الكلمات تكره الفهم وتتغلب عليه، وتخلق البلبلة لدى الجميع، وتؤدي بالناس إلى جدالات عقيمة لا حصر لها وإلى خيالات عابثة. وأخيراً، هنالك أصنام هاجرت إلى عقول الناس من العقائد المختلفة في الفلسفة، ومن قوانين البراهين الخاطئة. هذه الأصنام أدعوها أصنام المسرح، فكل النظريات الشائعة ليست، في رأي، إلا مسرحيات تمثل عوالم خلقتها هي بصورة غير واقعية وشكلية. لا أتحدث هنا فقط عن النظريات الدارجة الآن، أو عن الفَرق والفلسفات القديمة: فقد تؤلف الكثير من المسرحيات من هذا النوع ويتم إخراجها بنفس الطريقة الاصطناعية [التي أُلفت بها]. لقد رأيتُ أن للأخطاء، مهما كان الاختلاف بينها كبيراً، أسبابا متشابهة في معظم الأحيان. مرة أخرى، لا أعني ذلك فقط بالنسبة لنظريات بكاملها، وإنما أيضا بالنسبة لمبادئ وبديهيات عامة في العلم، والتي تم تَقبلها عن طريق التقاليد أو بسبب الإهمال وسرعة الإيقان. سوف أتحدث عن هذه الأنواع العديدة من الأصنام بمزيد من الإسهاب والدقة، عسى أن يأخذ الفهم ما يلزم من الحذر منها. ينزع الفهم البشري بطبيعته إلى افتراض وجود قدر أكبر من الترتيب والنظام في الكون مما هو قائم بالفعل. وبالرغم من وجود العديد من الأشياء الفريدة في نوعها في الطبيعة، إلا أن الفهم يختلق لها النظائر والقرائن والأقارب. ومن هنا جاءت البدعة بأن جميع الأجرام السماوية تدور في دوائر تامة، كما وتم رفض وجود... اللوالب (إلا بالاسم فقط). ولهذا السبب أيضا أضيف عنصر النار ودائرتها إلى العناصر الثلاثة الأخرى التي تدركها الحواس (للحصول على المربع). ولهذا أيضا تمددت بصورة عشوائية نسبة كثافة ما يسمى بالعناصر بنسبة عشرة إلى واحد. وهكذا بالنسبة لبقية الأحلام الأخرى. إن هذه الأوهام لا تمس العقائد فقط وإنما الأفكار البسيطة أيضاً. عندما يتبنى الفهم البشري رأياً (لكونه شائعاً أو لأنه يروق للفهم نفسه)، فإنه يجر جميع الأشياء الأخرى لدعم هذا الرأي والاتفاق معه. وبالرغم من وجود أمثلة أكثر عدداً ووزناً في الجانب الآخر، إلا أنه يهملها ويزدريها أو يقوم برفضها وطرحها جانباً باللجوء إلى تمييز معين. وبواسطة هذا التحديد المسَبق والمدمر قد تظل سلطة الاستنتاجات السابقة غير قابلة للانتهاك... هذا هو سبيل المعتقدات الخرافية في التنجيم، الأحلام، الفأل، الأحكام السماوية، أو ما شابه ذلك، حيث يقوم الناس (فرحين بغرورهم) بتسجيل الأحداث إذا تحققت، وإذا لم تتحقق (وهذا ما يحصل في أغلب الحالات) يهملونها ويمرون مر الكرام عليها. وبقدر أكبر من الدهاء اندسّ هذا الشر في العلوم والفلسفة، حيث تَصبغ الاستنتاجات الأولى تلك التي تليها بطابعها الخاص وتجعلها متفقة معها، هذا بالرغم من أن الاستنتاجات التالية أكثر صحة. علاوة على ذلك، وبشكل مستقل عن الفرح والغرور الذي وصفته، فإنه من الأخطاء الدائمة والمميّزة للعقل البشري أنه أكثر تأثراً بحالات الإثبات منه بحالات النفي، مع أن عليه اتخاذ موقف غير منحاز في كلتا الحالتين. فإنه في عملية إثبات صحة أي بديهية فإن المثل النافي[4][7] (negative instance) هو أكثرهما تأثيراً. يتأثر الفهم البشري، أكثر ما يتأثر، بتلك الأشياء التي تدخل العقل معا وبصورة فجائية، فتملأ الخيال. ثم يَفترض أن جميع الأشياء الأخرى (مع أنه لا يعرف كيف) تشبه تلك الأشياء القليلة المحيطة به. أما فيما يتعلق بالسعي المضني وراء الأمثلة البعيدة وغير المتجانسة، تلك التي تُفحص بواسطتها صحة البديهيات، فإن العقل بطيء وغير مؤهل؛ هذا إلا إذا لم ترغمه قوانين صارمة وسلطة غلابة. الفهم البشري ليس ضوءا جافاً، فهو يستقبل الإشراب (infusion) من الإرادة والعواطف، حيث تنتج علوم يمكن تسميتها "علوم كما تهوى". فالإنسان متهيئ لتصديق ما يُفضل أن يكون صحيحاً. ونتيجة لذلك فهو يرفض الأشياء الصعبة نظراً لفراغ صبره من البحث، يرفض الأشياء الجدية لأنها تضيق فسحة الأمل، يرفض الأشياء الأكثر عمقاً في الطبيعة بسبب معتقداته الخرافية ويرفض الأشياء غير الشائع تصديقها مراعاة لرأي العامة. وباختصار، لا حصر للطرق، وأحيانا عسير إدراكها، التي بها تُلون العواطفُ الفهمَ وتلوثه. غير أن أكبر عائق أمام العقل البشري هو عدم حدّة وعدم أهلية وخداع الحواس. فكفّة الأشياء التي تؤثر على الحواس ترجع كفة الأشياء التي لا تؤثر على الحواس بصورة مباشرة (وإن كانت أكثر أهمية). ولهذا السبب يتوقف التأمل عادة عند الحدود التي يتوقف عندها البصر، وإلى درجة انعدام ملاحظة الأشياء التي لا يمكن رؤيتها. وهكذا يظل عمل قوة الحياة داخل الأجسام المحسوسة خافياً ولا يلاحظه الناس. وينطبق هذا على التغيرات الدقيقة التي تطرأ على شكل أجزاء الأشياء المادية (والتي يسمونها عادة "التغيرات" مع أنها في حقيقة الأمر حركة موضعية في فراغات صغيرة جداً) والتي لا تلاحظ أيضا. وإذا لم تتم الدراسة الوافية لهاتين القضيتين المذكورتين، فلن يتم إنجاز شيء عظيم في الطبيعة من حيث إنتاج الأعمال. كما أن الطبيعة الجوهرية للهواء الذي نتنفسه جميعاً، وجميع الأجسام الأقل كثافة (وهي كثيرة) ما زالت مجهولة. الحاسَة لوحدها شيء ضعيف وقابل الخطأ، ولا تساعد كثيراً الأدوات التي تشحذ الحواس وتكبرها: إن نوع التفسير الأصح للطبيعة يمكن إنجازه بالأمثلة والتجارب المخبرية الملائمة، حيث تقرر الحاسة بشأن التجربة المخبرية فقط، والتجربة المخبرية تقرر بشأن الأمر في الطبيعة وبشأن الشيء ذاته. ينزع الفهم البشري في طبيعته إلى المجردات ويعطي محتوى ووجودًا للأشياء الزائلة. ولكن أن نحلل الطبيعة إلى مجردات هو أقل خدمة لهدفنا من تشريح الطبقة إلى أجزاء، كما فعلت مدرسة ديموقريطس[4][8] الذي تعمق في أمور الطبيعة أكثر من غيره. المادة وليس الشكل (form) يجب ان تكون موضوع اهتمامنا، المادة وتشكلاتها وتغير تشكلها، والفعل البسيط، وقانون الفعل أو الحركة. فالأشكال هي من اختلاق العقل البشري، هذا إذا لم تسمى قوانين الفعل أشكالاً. هذه هي إذا الأصنام التي أدعوها أصنام القبيلة، والتي تنشأ من تجانس مادة الروح البشرية، أو من انهماكها، أو من ضيق أفقها، أو من حركتها الدائمة، أو من إشراب العواطف، أو من عدم أهلية الحواس، أو من طريقة التأثر. تنشأ أصنام الكهف من التكوين المتميز، البدني والذهني، لكل فرد، وتنشأ أيضاً عن التربية، العادة، والصدفة. هناك عدد كبير من هذا النوع، ولكنني سأسوق تلك الأمثلة التي تتضمن الإشارة إليها التحذير الأكثر أهمية، والتي لها التأثير الأكبر في تعكير نقاء الفهم. يتعلق الناس بعلوم وبمواضيع نظرية معينة إما لأنهم يتخيلون أنفسهم مؤلفيها أو مخترعيها، أو لأنهم تحملوا المشاق في سبيلها وتعودوا عليها كثيراً. إن أناساً من هذا النوع، إذا انكبوا على الفلسفة والتأملات العامة، يشوهونها ويصبغونها بلون خيالاتهم السابقة. ويُلاحَظ هذا بشكل خاص عند أرسطو[4][9] (Aristotle)، الذي جعل من فلسفة الطبيعة عنده مجرد عبد لعلم المنطق، وبذلك أصبحت خلافية وعديمة الجدوى. كما وأنشأت طائفة الكيماويين، بناء على تجارب قليلة في الِمصهر، فلسفة خيالية تم تفصيلها بالإشارة إلى أشياء قليلة. ونفس الشيء ينطبق على جلبرت[4][10] (Gilbert) الذي، بعد أن أجهد نفسه في دراسة وملاحظة المغناطيس، انتقل على الفور إلى إنشاء نظرية كاملة وِفقَ موضوعه المفضل. هناك بعض العقول المكرسة للإعجاب الشديد بالقديم، وعقول أخرى مكرسة لحب الجديد والرغبة الجامحة فيه. قليلة هي العقول التي تشق طريقها في الوسط، بحيث لا تطعن في الجيد مما قدمه القدماء، ولا تزدري الجيد الذي يقدمه المحدثون. وهذا يَلحق ضرراً كبيراً بالفلسفة والعلوم، لأن هذه المودة للقديم والحديث هي أهواء المتحزبين وليست أحكاماً. ثم إنه يتوجب البحث عن الحقيقة ليس من أجل سعادة هذا العصر أو ذاك (وهذا شيء غير ثابت)، وإنما في ضوء الطبيعة والتجربة (وهذا شيء أبدي). ولذلك يجب نبذ الفئات الشقاقية، والاحتراس من عدم تسرع العقل في الموافقة تحت تأثيرها. ليكن ما يلي حيلتنا وحكمتنا التأملية لإبعاد وإزالة أصنام الكهف، والتي تنشأ في الغالب عن هيمنة موضوع مفضل، أو عن نزعة مفرطة للمقارنة والتمييز، أو عن التحيز لعصور معينة، أو عن كِبر أو صغر الأشياء التي يتم تأملها. وليأخذ كل دارس للطبيعة ما يلي كقاعدة: أن ما يستولي على عقلك وتعكف عليه برضى خاص، عليك أن تكون كثير الظن به، وأن عليك أن تحرص كثيراً في معالجة تلك المسائل على إبقاء الفهم نقياً وسوياً. ولكن أصنام السوق هي الأكثر إثارة للمتاعب: وهي الأصنام التي زحفت إلى الفهم من تحالف الكلمات، الأسماء. يظن الناس أن العقل يسيطر على الكلمات، إلا أنه صحيح أيضا أن الكلمات تقاوم الفهم، وهذا ما أفقد الفلسفة والعلوم الفاعلية وجعلها ذات طابع سفسطائي. الكلمات، التي تصاغ وتستعمل وفق القدرة العقلية للعامة، تتّبع خطوط التقسيم الأكثر وضوحا لفهم العامة. وعندما يحاول الفهم الأكثر حدة وأكثر دأبا على الملاحظة تغيير هذه الخطوط لتلائم التقسيم في الطبيعة، تقف الكلمات حجر عثرة في الطريق وتقاوم التغيير. ومن هذا يحدث أن النقاشات الرسمية وذات المستوى الرفيع لأهل العلم كثيرا ما تنتهي بخلافات حول الكلمات والأسماء التي بها (حسب استعمال وحيطة الرياضيين) من الأجدر أن نبدأ، وأن ننظمها بواسطة التعريفات. ولكن التعريفات لا تستطيع الشفاء من هذا الشر أثناء التعامل مع الأشياء المادية والطبيعية، فالتعريفات نفسها تتكون من كلمات، كلمات تولد بدورها كلمات أخرى. ولذا من الضروري الرجوع إلى الحالات الفردية، وتلك التي يسودها التسلسل والترتيب، وهذا ما سوف أتحدث عنه الآن عندما أتطرق لمنهج وخطة تكوين الأفكار والبديهيات. غير أن أصنام المسرح ليست فطرية، ولا تتسلل إلى الفهم خلسة، ولكنها تنطبع في الذهن عن طريق الكتب المسرحية لنظريات الفلسفة وقواعد البراهين الخاطئة. إن محاولة التفنيد في هذه الحالة قد يناقض ما قلته سابقا: فطالما أننا لا نتفق على المبادئ أو البراهين فلا مجال للنقاش. هذا جيد طالما أنه لا يمس شرف القدماء. فليس من الحكمة أن نقدح فيهم، فالخلاف بيني وبينهم هو حول الطريقة فقط. وكما يقول المثل: إن الأعرج الذي يسلك الطريق الصحيح أسبق من العداء الذي يسلك الطريق الخطأ. وأكثر من ذلك، من الواضح أنه عندما يسلك المرء الطريق الخطأ، فكلما كان أنشط وأسرع كلما حاد عن الطريق الصحيح أكثر. بيد أن المسار الذي أقترحه لاكتشاف العلوم يترك مجالاً ضيقا لحدة وشدة الذكاء (أو الفطنة)، لأنه يضع العقول والفطن كلها في نفس المستوى تقريبا. فكما في رسم خط مستقيم أو دائرة، فإن الكثير يعتمد على مراس اليد إذا تم عمل ذلك باليد المجردة. أما إذا تم عمل ذلك بمساعدة المسطرة والفرجار، فالقليل يعتمد على مراس اليد. وهكذا بالنسبة لخطتي. فبالرغم من عدم جدوى التنفيذات المحددة، فإنني سوف أقول شيئا عن التقسيمات العامة لهذه النظريات، وشيئا آخر عن العلامات الخارجية التي تُظهر عدم صحتها، وفي النهاية سأقول شيئا عن أسباب هذا البؤس الكبير وهذا الاتفاق العام والدائم على الخطأ، عسى أن يصبح الوصول إلى الحقيقة أقل صعوبة، وعسى أن يصبح الفهم أكثر رغبة في تطهير نفسه وطرد أصنامه. إن أصنام المسرح، أو أصنام النظريات، كثيرة وقد يزيد عددها. فلولا انشغال عقول الناس على مدى عصور بالدين واللاهوت، ولولا نفور الحكومات المدنية، وخاصة الملكيات منها، من مثل هذه الأشياء الجديدة، حتى وان كانت في المجال النظري، مما كان يعرض أملاك العاملين فيها للخطر والضرر، ليس فقط بدون مردود وإنما أيضا عرضة للسخرية والحسد، لولا كل ذلك، لنشأت فِرَق فلسفية أخرى كثيرة، مثل تلك الأنواع التي ازدهرت عند الإغريق، وكما يمكن وضع الفرضيات الكثيرة عن ظواهر السماء، يمكن أيضا، وبقدر أكبر، وضع العقائد العديدة عن ظواهر الفلسفة. وفي تمثيليات هذا المسرح الفلسفي يمكنك أن تلاحظ نفس الشيء الذي تجده في مسرح الشعراء: قصص تُخَتَرعُ لخشبة المسرح، قصص مكثفة وظريفة (أكثر مما يود المرء أن تكون)، ولكنها غير حقيقية وليست مستمدة من التاريخ. وعلى العموم، فإن ما يعتبر مادة الفلسفة هو إما الكثير من أشياء قليلة، أو القليل من أشياء كثيرة. وفي الحالتين فإن الفلسفة مبنية على قاعدة صغيرة جدا من التجربة والتاريخ الطبيعي، وتُصدر أحكامها بناء على حالات قليلة جدا. فمدرسة الفلاسفة العقليين تختطف عددا من الأمثلة الشائعة من التجربة دون أن تتثبت من صحتها، ودون أن تخضعها للفحص والقياس الدقيق، وتترك الباقي للتأمل وتقلبات العقل. وهناك طائفة أخرى من الفلاسفة، الذين بَعدَ بذلهم جهدا كبيرا على تجارب قليلة، يُقِدمون على استنباط وبناء النظريات، ومن ثم يصارعون بقية الوقائع (وبطريقة غريبة) كي تلائم نظرياتهم. وهناك أيضا طائفة ثالثة تتألف من الفلاسفة الذين بدافع الإيمان خلطوا فلسفتهم باللاهوت والتقاليد، وقد وصل الغرور بالبعض منهم إلى حد البحث عن أصل العلم بين الجن والأرواح. وعليه فإن هذا المخزون من الأخطاء (هذه الفلسفة الزائفة) هو من ثلاثة أنواع: الفلسفة السفسطائية، التجريبية، والخرافية. قوانين رانجاناثان الخمسة : فيما يقول البعض بأن هذه القوانين الخمسة هى التى شكلت حياة رانجاناثان[1] وإبداعاته وكتاباته ووجهات نظره المستحدثة والجوائز التى حصل عليها ، ومن هنا ربما تبرز أهمية هذه القوانين، فهي لسبب شخصي تتعلق بحياة رانجاناثان نفسه، وأيضا فى تأثيرها فى كل ما كتب حول علم المكتبات فيما بعد. 1. المكتبات تخدم الإنسانية Libraries serve humanityالقوانين الخمسة لرانجاناثان هى: 1. الكتب للاستخدام Books are for use. 2. لكل قارئ كتابه Every reader his or her book. 3. لكل كتاب قارئه Every book its reader. 4. حافظ على وقت القارئ Save the time of the reader. 5. المكتبة كائن حى متطور The Library is a growing organism. وعلى الرغم من وضوح القوانين الأربع الأولى إلا أنه فى ظن الباحث أن القانون الخامس يحتاج الكثير من المداخلات الفكرية، ولايمكن قبوله بسهولة إلا إذا تم التبحر فى مضامينه الفكرية، وصولا إلى قبوله كاملا أو رفضه كاملا وهى المشكلة المتعلقة بهذه الدراسة. فقد لوحظ أن فكرة المكتبة ككائن حي متطور ونام لاتضح بشكل كاف في ما أشار إليه ستيكل على سبيل المثال، وعلى الرغم من ذلك فقد نظر العديد من خبراء المكتبات نظرة أكثر شمولا وتطورا لهذه القوانين ليطبقوها فيما بعد على كل أنواع مصادر المعلومات ومنها الشبكة العنكبوتية والإنترنت ككل ، ولعل دراسة أليريزا نوروزى توضح هذا الاتجاه [2]إضافة إلى أن هناك العديد من العلماء الذين نحوا نحو مافعله رانجاناثان وقاموا بإصدار خمس قوانين مماثلة فى مجموعة من الفروع العلمية منهم عالم المكتبات الشهير ميشيل جورمان Michael Gormanفى خمس قوانين جديدة فى المكتبات"Five new laws of librarianship" عام (1995) وسانجايا ميشرا Sanjaya Mishra[3] فى خمسة قوانين لمكتبة البرمجيات "Five laws of the software library"عام (1998) ، ومنتور كاناMentor Cana فى مبادئ التعليم عن بعد "Principles of distance education"عام (2003)[4]، وفيرجينيا أز واترVirginia A. Walter فى خمسة قوانين لمكتبات الأطفال عام (2004)[5] "Five laws of children's librarianship"، وولينار بيورن بورن Lennart Björnebornفى خمسة قوانين للاتصال بالشبكة العنكبوتية "Five laws of web connectivity" وغيرها الكثير. وربما تكون قوانين جورمان الخمسة هى الأشهر على الإطلاق بعد قوانين رانجاناثان[6]، حيث يقول: 2. احترم كل الأشكال التى يتم تناقل المعرفة عبرهاRespect all forms by which knowledge is communicated. 3. استخدم التكنولوجيا بذكاء لتعزيز الخدمة التى تقدمها Use technology intelligently to enhance service. 4. اعمل على حماية الوصول الحر للمعرفة Protect free access to knowledge; and 5. شرف الماضي واخلق المستقبل. Honor the past and create the future تدل المجموعة من القوانين المأخوذة من القوانين الأصلية لرانجاناثان على مدى التأثير الذى تركه رانجاناثان فى مجتمع المكتبات وفى عقول المكتبيين حتى أن جيمس رتيج عام 1992 أضاف قانونا سادسا لقوانين رانجاناثان وهو المتعلق بأن لكل قارئ حريته "Every reader his freedom"تعبيرا عن مجتمع الديمقراطية والشفافية والحرية التى ينادى بها لكل البشر. 1. مصادر الشبكة العنكبوتية للاستخدام. Web resources are for useبل إن الأمر تعدى ذلك إلى المناداة بقوانين خمس للشبكة العنكبوتية[7] نفسها على وتيرة القوانين الخمسة لعلم المكتبات هى: 2. لكل مستخدم مصدره أو مصادرها للشبكة العنكبوتية. Every user his or her web resource 3. لكل مصدر على الشبكة العنكبوتية مستخدمه Every web resource its user. 4. حافظ على وقت المستخدم Save the time of the user. 5. الشبكة العنكبوتية هى كائن حي متطورThe Web is a growing organism يتبقى الإشارة إلى أن القانون الخامس فى ظن الباحث يحتاج الكثير من الشروحات التى تبين هل يمكن تطبيقه بسهوله وهل يمكن قبوله علميا دون مناقشة، وربما هذا هو ما دفع الباحث إلى استخدام الأفكار التى نادى بها بيكون لكي يستطيع أن يقدم نوعا من القراءة الجديدة لهذا القانون. مقياس نمو وتطور كائن حى يسمى المكتبة: سيتعرض الباحث فى هذه المقولة التى تمثل الحلقة الأولى من ثلاث مقولات لواحد من أهم المبادئ أو القواعد التى قام عليها علم المكتبات ومازال، وهذه القاعدة هى واحدة من قواعد رانجاناثان الخماسية التى يتم تدريسها لطلاب علوم المكتبات فى المرحلة الجامعية الأولى. ماذا تقول هذه القاعدة لرانجاناثان – عالم الرياضيات الهندي - المكتبة كائن حي ومتنام، أو The Library is a growing organism ماذا يعنى عالم الرياضيات بذلك؟؟. فى ذلك يقول مايك ستيكل [8]Mike Steckel"إننا فى حاجة إلى أن نخطط ونبني بناء على التوقعات المتعلقة بمباني المكتبات وتوقعات المستفيدين والتى ستستمر فى النمو والتغير عبر الزمن. إضافة إلى أننا فى حاجة أيضا إلى الارتفاع بمهاراتنا وقدراتنا بشكل مستمر". تبدو المسألة نسبية أحيانا حين الحديث عن التطور، تطور المكتبة، فهل نعنى بذلك – على سبيل المثال- تطور المكتبة خلال عام أو خلال قرن من الزمان، أو عبر مجموعة من الدورات الحضارية التى مرت على العالم، أم أن مسألة التطور عنى بها رانجاناثان التاريخ البشرى كله، وماهى علاقة ذلك بفلسفة علم المكتبات؟؟!. دعونا ننظر للمسألة من زاوية أخرى، إذا كان رانجاناثان بعنى بالتطور مثلا مرور 25 عاما على مكتبة، وهذا العمر يساوى تقريبا العمر الذى يمكن أن يقضيه خريج للمكتبات فى أحد المكتبات التى يتم تعيينه فيها، فمن المؤكد أنه ستحدث العديد من التقلبات على حال المكتبة سواء سلبا أو إيجابا، وهذه التقلبات عادة تأتى من أربعة اتجاهات، ويجب أن نعى أن هذا التطور تطور صنعى وليس تطورا طبيعيا، أى من صنع بشر، ماهى هذه الاتجاهات الأربعة: 1- تغيرات وتقلبات ترتبط بأوضاع سياسية محددة، وعلى سبيل المثال فإن التطور الذى تشهده المكتبات فى مصر سببه الدعم السياسى الذى تلقاه مكتبات محددة من رأس الدولة، ومن هنا فحظوظ بعض المكتبات تغلب على حظوظ مكتبات أخرى فى التقلب الإيجابى، ومما يعنى أن المؤسسة جميعها لاتشعر بهذا التحسن، وإنما هو تحسن يصدق على الجزء وليس الكل من مجتمع المكتبات، والمتهم الوحيد هنا هو غياب استرتيجية واضحة للدولة ككل فى التعامل مع مجتمع المكتبات. 2- التغيرات التى تأتى من متخذ القرار الذى تقع المكتبة ضمن نطاق هيمنته، مثل حال بعض المكتبات الجامعية فى ظل اهتمام رئيس الجامعة بالمكتبة/ وهذا الاهتمام أيضا فى حد ذاته اهتمام يعانى من مرضين هما الشكلية والوقتية، بمعنى أن هذا التغيير غالبا يحدث لإرضاء طرف آخرأو لاستكمال الشكل العلمى للجامعة، كما أن هذا التغيير مرتبط ببقاء الشخص فى موقعه، والمتهم أيضا عدم وجود سياسة وطنية للمكتبات. 3- التغيرات التى تأتى عبر مجتمع المستفيدين أنفسهم وضغوطاتهم ولكنها تصب عادة فى ناحيتين هما مجموعات المكتبات من كتب ومصادر معلومات والمتخصصين وربما تقف الموازنات أحيانا كعنصر خفى. 4- التغيرات التى تأتى عبر سواعد وعقول بعض الغيورين من المتخصصين على مهنتهم ومكانتهم وانتمائهم، وعادة مايكون ذلك أضعف أشكال التغيير. ليس الهدف مرة أخرى من هذا العرض هو العثور على متهمين وراء الضمور الذى تشهده مؤسسة المكتبة، وإذا كانت واحدة من قواعد العلوم الطبيعية تقول بأن العضو الذى لايستخدم يضمر، وهو مايؤكد أن قوانين الطبيعة يمكن تطبيقها على المؤسسات أيضا. المسألة هنا أيضا أنه ليس هناك مؤشر Index للتطور والنمو والحياة فى المكتبات، يمعنى ماهو المقياس الذى يمكن استخدامه للحكم على مدى التطور أو التدهور فى حياة كائن حى يسمى المكتبة ومن المسئول أو العناصر المتشابكة المسئولة عن هذا التطور، وكيف يمكن الارتقاء بهذه العناصر؟، بشكل آخر فإن ظاهرة تطور المكتبات فى دول العالم الثالث – مثلا- ارتبطت بالتغيرات السياسية، أو أن أحدا من المسئولين السيايين أظهر اهتماما نحو هذا النوع من التغيير، وسواء أكان هذا الاهتمام ناتجا عن إيمان فعلى بأهمية المكتبات فى حياة الشعوب، أو عن رغبة فى التغيير الشكلى متسقا فى ذلك مع رغبة الخديو اسماعيل بجعل مصؤ قطعة من أوروبا ، وهنا يصبح التغيير شكليا دون مضمون حقيقى، وذلك قد يدفعنى للقول بأنه حتى التغيير المينى على فكر سياسى محدد لم تهتم بالمضمون كثيرا، وليس معنى ذلك أن نرفضها ولكن أن نبنى عليها. إن التغيير السياسى لوضعية المكتبة يركز على المبنى والتجهيزات والأثاث والمدير الذى يتحدث بلغات متعددة، لكنه لم يصل لفحوى ومضمون المجموعات، لم يصل لتغيير الوضعية الثقافية والمهنية والمادية لأختصاصى المكتبات، ناهيك أن التغيير لم يصب أيضا فى اللوائح والقوانين الحاكمة والمنظمة للعمل. إذن فإن الحديث عن كينونة المكتبة ككائن متطور يجب أن يمتد لمعنى التطور، وهل هو معنى نسبى فى الزمن، أى هل هذا التطور الذى تحدث عنه رانجاناثان على مستويين، مسنوى أفقى يتعلق بهيئة المكتبة وحالتها الحالية، أو على مستوى رأسى يتعلق بالتحولات التى طرأت على مؤسسة المكتبات منذ بداية التاريخ حتى اليوم. يمثل الجدول التالى عرضا للتطور الذى شهدته البشرية عبر عصور اتفقت عليها أغلب المؤلفات العلمية التى تعلقت بتاريخ التطور البشرى*. جدول يبين العصور الحضارية والتوجه من المحسوس إلى غير المحسوس، ومن الفيزيائى إلى اللاملموس مسلسل ماقبل التاريخ عصر الصيد والرعى عصر الزراعة عصر الصناعة عصر المعلومات الزمن 5مليون عام – 100ألف عام 100 ألف عام – 10آلاف عام 10 آلاف عام 100 عام العقد الأخير الحضارة لاتوجد لاتوجد الفرعونية الرومانية- اليونانية الفينيقية- الآشورية العالم العالم نوع مصدر المعلومات لايوجد جدران الكهوف العظم والسعف والشقف والبردى واألواح الطين والرق والورق الورق الورق وملفات الحاسب وصفحات الانترنت اللغة لايوجد لغة تصويرية لغة تصويرية رمزية رمزية رمزية كمية المعلومات لايوجد محدودة للغاية متوسطة عالية مكثفة شكل المعلومات لايوجد تصويرية ثابتة نادرة تصويرية ثابتة رمزية + صور متحركة + صوت متعددة مكان المعلومات لايوجد متفرقة محددة محددة ومجمعة موحدة على العالم هل يمكن لنا إذن اعتماد مقاييس للتطور على المستوى السياسي والإداري والتنظيمي والمستفيدين وأخصائيي المكتبات وحتى مصادر المعلومات، وكذلك على المستوى اللائحي والتشريعي. دورات حياة المكتبة ككائن حى:إذن فالأمر هنا يتعدى حدود هذه الأطروحة، فنحن فى حاجة لمجموعة من الدراسات العلمية على مستوى الماجستير والدكتوراه التى تقيس التطورات التى مرت على المكتبات، وهل التطورات التى تمت فى مؤسسة المكتبات سواء سلبا أو إيجابا ارتبطت بالتغير السياسى أو الإدارى أو الاقتصادى وماهى العناصر التى لعبت أكثر من غيرها دورا أو أدوارا فى هذا التغيير، وهل زيادة أو نقصان فى الطبقات الاجتماعية المختلفة داخل مجتمع من المجتمعات تأثير على حركة مؤسسة المكتبات, وعلى سبيل المثال فإن انتقال العديد من الدول فى العالم من مجتمعات ملكية إلى جمهورية كان له تأثير على حركة المكتبات، وهل الانتقال من الاشتراكية إلى الليبرالية له تاثير على مجتمع مؤسسات المكتبات، وهل هناك علاقة بين أن تدين الدولة بسياسة محددة أو بمنهج سياسى محدد أن يكون لذلك تأثير على مؤسسة المكتبات. لايخفى على العديد من الباحثين والدارسين لعلم المكتبات أن الهدف من هذا القياس هو ضبط إيقاع التطور ومراقبته من خلال المؤسسات الأكاديمية المسئولة عن المؤسسات التطبيقية والعملية وبالتالى تخرج المكتبة كمؤسسة من عشوائية التغيرات السياسية إلى المعمل، مما يحفزنا أكثر على اعتماد المنهج التجريبى، وهو ماسأعود إليه فى أطروحة أخرى. إن قياس علاقة المكتبات ومؤسساتها بالتطورات السياسية وغيرها لم ينظر إليه فى علم المكتبات نظرة فاحصة حتى الآن، كأن علماء المكتبات غير معنيين بذلك، وكأننا ننتظر ملاك من السماء أو من علماء السياسة والاقتصاد والاجتماع هذا التفسير والذى أعتقد أنه تأخر كثيرا، وبالتالى يجب إطلاق عقال العلم، علم المكتبات Library Science، فى الوقت الذى أغرقنا فيه فى فن المكتبات Librarianship، وربما هذا هو سر أزمة المؤسسة التى نعيشها الآن. ربما يكون أيضا من الأهمية بمكان التعرف على تأثير الزمن على تطور مؤسسة المكتبة، وإذا أخذنا بصحة مقولة رانجاناثان أن المكتبة "كائن حى" فمن المؤكد أن هذا الكائن الحى النسبى يتعرض لدورات الحياة الطبيعية التى يتعرض لها كل كائن حى، المشكلة أن يفرز سلالات جديدة فهو أشبه بالفيروس يموت وينسلخ منه نوع جديد فى كل دورة حضارية. تأثير وعاء المعلومات على تطور المكتبة ككائن حى:بمعنى آخر أنه يشهد المراحل الست التى يشهدها كل كائن حى، من الميلاد إلى الطفولة ثم الشباب ثم الكهولة ثم الموت، ثم البعث من جديد وعلى نفس المستوى الزمنى النسبى فإن كل مكتبة تتعرض لذلك بشكل أو بآخر. هناك فى علم الفلك ظاهرة تتعلق بتطور النجم، فالشمس تعتبر – على سبيل المثال – نجما فى مقتبل العمر، ربما بعد عشرة ملايين من السنوات تتحول إلى مايعرف بالعملاق الأحمر حيث تتضخم ذراتها لتصبح أكبر من حجمها الحالى عشرات المرات وبعد عشرة مليون سنة أخرى تتحول إلى مايعرف بالقزم الأبيض حيث تتداخل ذراتها بشكل مكثف فتصبح فى حجم القمر تقريبا، وتصل شدة جاذبية الذرة الواحدة منها إلى درجة عاليه بحيث أنك لو وضعت ذرة منها على سطح الأرض لأخترقت الأرض وخرجت من الناحية الأخرى، ثم بعد ذلك تنفجر وتتحول إلى ثقب أسود يمتص أى ماده حتى الضوء، الغرض من هذا العرض هو بيان أن دورات الحياة لكل كائن فى الكون هى واحدة، يتشابه فى ذلك الفيروس والإنسان والفيل والشجرة والنجم، ومادمت قد أطلقت على المكتبة بأنها كائن حى – حتى لو على المستوى المجازى- فإنها لايمكن أن تفلت من هذا المصير وقد تعلمنا من سقوط الحضارات السابقة أن المكتبة مرتبطة ارتباطا كليا بالتطور الحضارى سلبا أو إيجابا وبالتالى فلن تفلت من نفس المصير. أيضا هذه السلالات الجديدة التى تظهر فى كل مرة تبنى على شكل جديد لوعاء/أو مصدر المعلومات ويترك هذا المصدر تأثيره على شكل المكتبة مبناً وأجهزة ونظما، وعبر كل عصر مرت به البشرية كان لمصدر المعلومات وطريقة كتابة هذا المصدر تأثيرا جوهريا على بنية مؤسسة المكتبة، كأنه يمثل حامض الدى إن إيه فى الخلية الحية، كأنه الذى يرسم لمؤسسة المكتبة مستقبلها الوراثى. من أولا : المكتبة أم الوعاء:الكتابة على جدران الكهوف كانت نوعا من التصوير لحياة الانسان فى الصيد والقنص والرعى، ويمكننا رؤية ذلك فى كهوف الجزائر والصين وغيرها، هذه الجدران وامتداداتها الحجرية تمثل بداية الذاكرة الخارجية للانسان، لكنها كانت ذاكرة بدأها الفنانون العظماء الأوائل، وليس الكتاب، الكتابة نابعة من الفن التصويرى الأول، فن التصوير هو الخلية الأولى لرموز الكتابة فيما بعد بدأت حرفة المصور تتفتت إلى التعبير الرمزى والتعبير الرمزى بدأ يتحول ِإلى الحروف اللغوية والرموز الكيميائية والأرقام الرياضية وغيرها، الرسم إذن هو وسيلة الاتصال الأولى، والتى تمحورت مع الزمن لتكون الحروف والرموز والأرقام، ثم بدا أهمية تطوير نظم لغوية شفاهية ومكتوبة. هذه الصور والرموز كان لابد لها من وعاء، كان الوعاء فى بداية التاريخ المسجل هو جدران الكهوف وجدران المعابد وكل مايمكن أن تطاله كانت هذه أوعية المعلومات الأولى، كان الاحتفاظ بها يعنى الاحتفاظ بالمبنى كله لذلك وقف بعضها شاهدا حتى اليوم بينما اندثرت أوعية معلومات أخرى فى الطريق، هل كان ذلك لضخامتها أو لقدرتها على مكافحة ندوب الزمن، لكن هل كمية المعلومات التى تحتويها هذه الأوعية تعبر بشكل كاف عن كل مناحى الحضارة، وعن التطور الفكرى، وعن كل مايعن للانسان من أفكار، لاأعتقد ذلك، فعلى ضخامتها كانت المعلومات بها ضعيفة إلى حد ما، لذلك كان يقتصر فيها على المعلومات الأساسية وزيارة لمركز معلومات أحمس الأول فى معابد الكرنك فى صعيد مصر، تبين كيف أمكن للفنان القديم أن يقتصر على المعلومات الأساسية، كذلك عجز العظم وسعف النخيل وغيرها عن الاحتفاظ بالذاكرة البشرية الخارجية، وربما نستلهم قضية طه حسين مع الأزهر فى نحل الشعر الجاهلى بسبب الشك فى التاريخ الشفاهى والمكتوب الذى وصلنا، لكن مع تطور الحضارة بدأ ظهور البردى والرق ثم الورق أعظم اختراعات عصر الزراعة، وهو الذى بشر أيضا بانتهاء هذا العصر، وهى ملحوظة أيضا تقودنا إلى ملاحظات أخرى، هل يبشر الوعاء دائما بانتهاء عصر حضارى وبداية عصر جديد، وهل هناك علاقة إيجابية بينهما، ربما هى أسئلة طرحت من قبل لكنها طرحت هنا لاكتشاف هذه العلاقة من جديد فى تأثيرها على مؤسسة المكتبات، بمعنى هل حدث تغير وتبدل فى مؤسسة المكتبات عند الانتقال من عصر إلى آخر بناء على التغير فى نوع الوعاء، وإلى أى مدى؟؟، الإجابة على مثل هذه الأسئلة هى التى ستضع الحقيقة كاملة أمامنا، هلى ستستمر مؤسسات المكتبات كما استمرت من قبل، أم لا؟! إذا فكرنا قليلا فى المعبد أو الكهف سنكتشف أن كل المؤسسات خرجت من هذا البناء ومن التصويرات التى كانت فوقه، ومنها المكتبات، كان المبنى يحتوى التصاوير، وهو الذى يتم فيه العلاج (المستشفى) والصلاة (المعبد) والرسم (المرسم) والقراءة (المكتبة) إلى آخر هذه الأفعال واسم المكان منها. تأثير الفكر الجمعى على دور المكتبات:إذن المكتبة حالة انسلاخية جزئية من كل شمل المعرفة البشرية بجميع تطبيقاتها، وبالتالى فالوعاء كان هو الجسد الذى تم الرسم عليه وخرجت منه أسماء الأماكن بشكل أو بآخر وإذا قبلنا بهذا التفسير، فالمكتبة مثلها مثل المؤسسات الأخرى فى المجتمع خرجت من نفس الرحم، لكن القضية الأكبر أن الوعاء إذا كان هو الذى خلق المكتبة فإن المكتبة هى الوحيدة التى عادت بعد ذلك لتكون الحاضن لهذا الوعاء، من بين المؤسسات جميعها، وربما هذا هو التفسير للحالة الحالية من الفوبيا التى تصيب علماء المكتبات – وأنا منهم – من أن مؤسسات المكتبات قد تموت؟ لماذا لأن الوعاء بدأ يعود مرة أخرى لحالته الأولى، الأم التى خرجت منها كل المؤسسات، وإلا فليفسر لى من يستطيع ؟ ماهى الإنترنت الآن؟ ألا نستطيع أن نفعل كل شئ الآن من على الإنترنت، نكتب ونرسم ونشفى ونصنع ونقتل ونكذب وننشر ونسافر.. و..و.. الحالة الأولى للمعبد القديم أو جدران الكهف التى نتحدث عنها. إذن حالة انفصال الجنين (الوعاء) عن الأم ( الجدران القديمة) هى حالة وهمية، فهما لم ينفصلا إلا ليزدادا نضجا ثم يعودا إلى حالتهما الأولى بعد ذلك، هاهى جدران المعبد والكهف تعود فى زى ضوئى غير ملموس اسمه الإنترنت، الحالة الأولى والأخيرة لأصل الأشياء، الضوء أو الطاقة. منذ ماقبل التاريخ المكتوب ماذا كان الانسان يفعل لتسجيل أفكاره واختراعاته وأحداث حياته، فى عصر الصيد وهو الذى يشمل تقريبا عمر الانسان كله على الأرض، إذ ماهو مقياس عشرة آلاف سنة بالنسبة لخمس ملايين من السنوات هى العمر الذى سجلته الأحفوريات لوجود الإنسان على الأرض، ومالذى جعل الانسان ينطلق هذه الانطلاقة خلال عشرة آلاف سنة، ومالسبب فى هذه المتوالية الهندسية – تقريبا- فى التطور، أليس هو التراكم المعرفى، والتحول من اللانظام فى المجتمع إلى النظام، وبناء الفكر الفردى والتحول نحو الفكر الجمعى[9] ، إن ظاهرة الفكر الجمعى فى التاريخ المعاصر، قدمت للبشرية خلال العامين الماضيين علما يوازى ماأنتج فى تاريخ البشرية كله، ونظرة سريعة على حائزى جائزة نوبل فى العلوم سنجد أن مؤسسات علمية بأكملها تقف وراء صاحب الجائزة وليس فردا بحد ذاته، وظاهرة جوائز نوبل فى الآداب ستظل دائما عملا فرديا، أن الآداب والفنون ستظل دائما حسا بشريا متفردا، بينا ستتحول العلوم إلى نتاج فكرى جمعى، هل يمكن أن ندعى بأن هذا مبدأ يحكم الفكر الإنسانى منذ البداية حتى النهاية ؟! أترك للقارئ الكريم الإجابة. هل علم المكتبات يقع ضمن العلوم الاجتماعية أم العلوم التطبيقية؟فنلق نظرة على تطور الفكر الجماعى وتأثيره، لقد أثبت الفكر الجمعى دائما تأثيره منذ بداية التاريخ، لقد استمر عصر الصيد طويلا مبنيا على الفكر الجمعى الذى يجمع البشر والحيوانات كالكلاب فى عملية الصيد وأثبت جدواه فى استمرار وجود الانسان، وتبين جدران الكهوف عمليات الصيد الجماعى، هذه الفكرة لم تختف ولكنها استمرت حتى فى العصر الزراعى حيث تقوم الأسر فى الريف المصرى والصينى والهندى منذ بداية التاريخ المكتوب بالزراعة الجماعية المبنية على التكاتف الأسرى والقروى، هاهو الفكر الجمعى الملموس المبنى على تكاتف القدرات العضلية والفكرية المحدودة، يتحول إلى نوع من التكاتف الجمعى لعملية فكرية جمعية، هى أعلى وأسمى بكثير من الفكر الفردي خاصة فى مجال العلوم، ولكن لايجب أن ننسى ان الفكر الجمعى هى دعوة أتت من الفرد، من الإنسان وحين لقيت هوى من الجماعة تم تأكيدها، وربما تكون أتت من تجربة الإنسان الأولى فى مواجهة الوحوش حين اكتشف بأن اثنين دائما أقوى من واحد فى مواجهة الضوارى، ومايعنينا هنا أننا بدأنا نعود للفكر الجمعى، وأننا سندين فى السنوات التالية إلى الفكر الجمعى فى تحسين حياة البشرية، أو أننا سندين الفكر الجمعى إذا تم تدمير الحياة البشرية!!. قد لا تكون هذه المقولة مرتبطة بشكل أو بآخر بما أشار إليه رانجاناثان، لكنها تمثل الآن عقبة أمام تقدم علم المكتبات فى العالم العربى، حيث لأنه من المعروف ضمنا أن تدريس علم المكتبات فى الولايات المتحدة الأمريكية لا يتم فى مرحلة ماقبل التخرج وإنما يتم فى مرحلة الدراسات العليا، أى بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى. والمشكلة كما يلاحظها أخصائيو علم المكتبات أننا فى الشرق نتعامل مع علم المكتبات على أنه ضمن العلوم الاجتماعية ونبرر ذلك على أساس أن علم المكتبات يخضع لدراسة المكتبة كظاهرة اجتماعية، وعلى أساس أنها ترتكز على العلوم الاتصالية فى علاقة الإنسان بأفكار الآخرين عبر المحتوى الوعائي أو المحتوى المكاني كالمكتبة. ولايمكن التقليل من هذا الشأن، لكن فى ظن الباحث أن مقولة رانجاناثان تشير إلى أهمية دراسة المكتبة ككائن حي، وهو لم يقل لنا طبيعة هذه الدراسة وبالتالي فالحكم على أن هذه الدراسة مبنية على مناهج العلوم الاجتماعية هو أيضا حكم خاطئ، فمن هو أول من أشار إلى ارتباط المكتبة بالعلوم الاجتماعية، وفى ذات الوقت فدراسة الكائن الحي يمكن لها أن تتمدد إلى كل من العلوم التطبيقية والاجتماعية والتاريخية، وهو فى ظن الباحث ما ينأى بعلوم المكتبات عن أن تكون علوما اجتماعية فقط، بل هى تدور فى فلك العلوم المتنوعة، ويمكن ملاحظة تنامي المنهج التجريبي فيها، وهو ما يمكننا القول عنه بأنه سيكون سمة البحث والدراسة خلال السنوات القادمة. يمثل الجدول التالى العناصر المكونة لعلوم المكتبات وانتماؤها لمنهج علمي محدد: م العنصر المكتبة الوعاء المستفيد المتخصص النظم تحول المكتبة من الحالة الفيزيائية إلى الحالة اللامرئية 1 التاريخ * * * 2 اللغة * * * * 3 المضمون * 4 التنظيم * * * * 5 التحول * * * 6 الاتصال * * * * * يكاد يحتل الوعاء كل العمليات التى تمت وتتم عليه عبر التاريخ الإنساني كله (رأسيا)، وهو ما يؤكد أن انتماء علم المكتبات إلى العلوم الاجتماعية انتماء طبيعي، كذلك يكاد يحتل الاتصال كل العمليات (أفقيا)، ورغم ذلك هناك مناهج متداخلة بشكل عال فى علوم المكتبات تتعلق بالتكنولوجيا واللغة وهو ما قد يتطلب مناهج مختلفة، وعلى ذلك يمكن القول بأن انتماء علم المكتبات للعلوم الاجتماعية هو انتماء منطقي وطبيعي، لكن هناك العديد من المناهج التى بدأت تزاحم المناهج الاجتماعية فى أبوتها لعلم المكتبات، وربما حان الوقت لأن نعترف بأن مستقبل علم المكتبات مرهون بالمدرسة التجريبية وليس المدرسة الوصفية والميدانية، وفى ظن الباحث أن هذا الأمر سوف يستدعى الكثير من النقاش لتحديد الاتجاهات المستقبلية فى علم المكتبات، فعلى سبيل المثال تكاد تعد أدوات البحث على الإنترنت من أهم مجالات البحث حاليا فى علوم المكتبات، وتعتمد فى مجملها على المنهج التجريبي، وسوف يمثل قطاع البحث واسترجاع المعلومات فى المستقبل القريب أهم قطاعات البحث فى علوم المكتبات، لأنه تقريبا يمثل روح علم المكتبات وجوهره، حيث أن قطاع الضبط الببليوجرافي بدأ يتراجع لصالح مؤسسات من القطاع الخاص لموردي قواعد البيانات، ومواقع الإنترنت المجانية، ممايجعل المكتبات مؤسسة من الدرجة الثانية فى هذا القطاع بعد أن كانت أم مؤسسات العالم فى هذا السبيل. استنتاجات:يمثل فكر جيمس بيكون حاجة ملحة لإعماله فى دعم بناء فلسفة علم المكتبات، وقد أظهرت الإجابات على تلك الاسئلة التى طرحها فى منهجه الفكري المتعلق بأوهام المسرح أهمية اتباع هذا المنهج، كيف يمكن إعادة تفسير العديد من الظواهر الحضارية والمتعلقة بظهور المكتبة كمؤسسة لحفظ النوع – الفكر البشرى – بكل مستوياته الفردية والجمعية، إضافة للتعرف على طبيعة المكتبة ككائن حى، وقد طرح المنهج البيكوني إشكالية فى غاية الأهمية هى التحقق من المقولات العلمية الراسخة فيما سماه بأوهام أو أصنام المسرح، وقد حاول الباحث تطبيق هذا الاتجاه الفكري من خلال المناقشة الفكرية المعتمدة على العقل لبعض هذه القضايا. لقد أثارت فكرة التحقق من مبدأ رانجاناثان المتعلق بالمكتبة ككائن حي العديد من الأسئلة الأخرى بجانب الأسئلة التى طرحها البحث، كما قدم العديد من الأجابات التى تمثل مستوى فكريا أوليا فى حاجه إلى التمحيص عبر دراسات فكرية وفلسفية مماثلة، كما طرح على البساط أيضا واحدة من القضايا الأولية فى علم المكتبات، هل علم المكتبات ينتمى للعلوم الإجتماعية، أم أنه يرتبط بدرجه أو بأخرى للعلوم التطبيقية، ونظرا لارتباط علم المكتبات بظواهر اجتماعية متعددة فإنه ينتمى للعلوم الاجتماعية فى ذات الوقت وقد أظهرت الدراسة أن علم المكتبات يقع فى منطقاة رمادية بين العلوم الاجتماعية من جهة وبين العلوم التطبيقية من جهة أخرى، على الرغم من أن القوانين التى تحكم علم المكتبات أتت بها علوم طبيعية وفيزيائية. [1] Shiyali Ramamrita Ranganathan: .R. Ranganathan is correct -- add 100 points to your score!. http://www.wam.umd.edu/~aubrycp/project/Pio100cx.html. [28/2/2006] [2] Noruzi, Alireza . Application of Ranganathan's Laws to the Web. On the Internet: http://www.webology.ir/2004/v1n2/a8.html [28/2/2006] [3] Mishra, S. (1998, October 12). Principles of distance education. On the Internet: http://hub.col.org/1998/cc98/0051.html[28/2/2006] [4] Cana, M. (2003, July 5). Open source and Ranganathan's five laws of library science. On the Internet: http://www.kmentor.com/socio-tech-info/archives/000079.html [28/2/2006] [5] Walter, V.A. (2001). Children and libraries: getting it right. Chicago: American Library Association.Excerpted from: http://www.webology.ir/2004/v1n2/a8.html#26 [6] Crawford, W., & Gorman, M. (1995). Future libraries: dreams, madness & reality. Chicago and London, American Library Association.1995. many pages. [7] Björneborn, L., & Ingwersen, P.Perspectives of webometrics. Scientometrics , v.50 No.1 2001. pp 65-82. [8] Steckel ,Mike.An Introduction to the Thought of S.R. Ranganathan for Information Architects. On the internet:: http://www.boxesandarrows.com/view/ranganathan_for_ias. [28/2/2006] · أنظر على سبيل المثال: 1- v [9] ستونير، توم. مابعد المعلومات : التاريخ الطبيعى للذكاء. ترجمة مصطفى ابراهيم فهمى. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2005. ص 77 ومابعدها. ( مكتبة الأسرة؛ سلسلة العلوم والتكنولوجيا)
تحياااااااااااااااتي لكِ السنيوره  
|

|
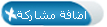 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
 المواضيع المتشابهه
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| مكتبة اليسير ( إقرأ ما تريد .. وضع كتاب جديد !) | د.محمود قطر | عروض الكتب والإصدارات المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات | 66 | Apr-05-2014 03:17 PM |
| نموذج نوعية (جودة) الخدمة: تطبيق ميداني | د. صلاح حجازي | المنتدى الــعــام للمكتبات والمعلومات | 15 | Jul-21-2008 05:06 PM |
| المؤتمر القومي السابع لأخصائيي المكتبات والمعلومات | أبـوفـيـصـل | المنتدى الــعــام للمكتبات والمعلومات | 6 | Jul-07-2007 05:17 PM |
| الموقع الرسمي للمؤتمر العربي للمكتبات والمعلومات | د.محمود قطر | المنتدى الــعــام للمكتبات والمعلومات | 4 | Mar-28-2006 11:49 PM |
| العصف الذهني واتخاذ القرار | زهــــــره | منتدى مراكز مصادر التعلم والمكتبات المدرسية | 3 | Feb-08-2005 08:58 PM |